عربيةDraw : نالت حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الثقة من البرلمان العراقي بعد التصويت على تشكيلته الوزارية يوم الخميس، 27 تشرين الاول 2022، وفيها ثلاثة نساء تسنمن وزارات سيادية ووزراء من المناطق المتنازع عليها بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كوردستان. حصدت محافظة كركوك وزارتين، وكانت حصة عربها وزارة التخطيط للوزير محمد تميم القيادي في حزب تقدم الذي يرئسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، اما الكورد حصلوا على وزارة العدل ووزيرها القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني خالد شواني. خالد سلام سعيد شواني، من مواليد كركوك 1975، دكتوراه في القانون كلية الحقوق جامعة المنصورة، وزير شؤون الحكومة الاتحادية في حكومة اقليم كوردستان، وعضو مجلس النواب من 2006 الى 2010. محمد علي تميم، استاذ دكتوراه في العلاقات الدولية سنة 2001، عضو مجلس النواب عن محافظة كركوك، لخمسة دورات، وزير التربية الاسبق من العام 2010، الى 2014، وزير التجارة وكالة لمدة شهرين في العام 2014، وترئس عدة لجان برلمانية وشغل عدة مناصب في التعليم العالي. وتم التصويت على محمد تميم، نائباً لرئيس مجلس الوزراء، وهو فائز عن الدائرة الثالة في محافظة كركوك، ورقعتها الجغرافية قضاء الحويجة جنوب غربي المحافظة. التركمان حصلوا على وزارتين، ولأول مرة بتاريخ التركمان يكون وزير الدفاع من مكونهم وهو من محافظة نينوى، الوزير ثابت العباسي، الحاصل على شهادة البكالوريوس في العلوم العسكرية دورة 69، عضو مجلس النواب للدورة الخامسة الحالية والسابقة، رئيس لجنة النزاهة النيابية في الدورة الرابعة، وهو من مواليد نينوى 1963. وكانت لنينوى حصة اخرى من خلال وزير الثقافة احمد الفكاك وهو من اصول مصلاوية، تولد 1961، حاصل على الدكتوراه في التاريخ السياسي الحديث من جامعة الموصل في العام 2022، وشغل عدة مناصب في وزارة التعليم العالي وله العديد من المؤلفات قصائد وقصص واشعار. المالية والهجرة والاتصالات من حصة النساء البدء من وزير الهجرة والمهجرين فكانت من نصيب بنت البصرة التي تقطن الموصل، الاصغر سناً بين الوزراء ايفان يعكوب جابر، وهي عضو مجلس النواب الحالي وشغلت عدة مناصب منها وزير الهجرة السابقة، وعضو لجنة الاعمار والخدمات في مجلس الوزراء وعضو المجلس التنسيقي الثلاثي، العراقي -الاردني-المصري، وعضو لجنة التمكين الاقتصادي للمرأة في مجلس الوزراء، ورئيس اللجنة العليا لإغاة ودعم النازحين التابعة لوزارة الهجرة والمهجرين، ورئيس اللجنة الوطنية العليا لمتابعة اوضاع العراقيين في الخارج، ايفان من مواليد 1981. اما وزارة المالية فذهبت الى طيف سامي، المرأة الحديدية كما يسميها من عمل معها في الوزارة سابقاً والشخصيات السياسية والنواب، لصرامة تعاملها وجديتها في حسم الملفات المالية لجميع الوزارات، طيف سامي مازالت انسة بحسب سيرتها الذاتية، حاصلة على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد كلية الادارة والاقتصاد من جامعة بغداد، شغلت عدة مناصب منها وكيل وزارة المالية من العام 2019 حتى يومنا الحالي، مدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية من العام 2010 حتى اليوم، وكانت عضواً في العديد من اللجان الحكومية داخلياً وخارج البلاد، وهي من العاصمة العراقية بغداد، مواليد 1963. وزارة الاتصالات تعتليها الوزير هيام عبود الحاصلة على شهادة الدكتوراه في هندسة الاتصالات من جامعة كرتن للتكنلوجيا في استراليا، والدكتوراه في هندسة الاتصالات من الجامعة التكنلوجية في بغداد، وهي من مواليد العاصمة العراقية 1967، شغلت عدة مناصب بينها، مدير الدائرة الادارية المالية في مؤسسة الشهداء، ومستشار وزير الاتصالات من العام 2007 الى 2021، ومناصب اخرى ضمن تخصصها في الجامعة التكنلوجية والحكومة العراقية. المصدر: كركوك ناو
عربيةDraw : بعد منح مجلس النواب العراقي الثقة لحكومة محمد شياع السوداني، تتركز الأنظار على المرحلة المقبلة، وما تضمنه برنامج الحكومة الوزاري من تعهدات وبنود تشكل خارطة طريق للحكومة التي تشكلت بعد عام من الانسداد السياسي المزمن، الذي كاد يتحول لصدامات مسلحة واسعة بين الأطراف السياسية المتنافسة. الحكومة العراقية المؤلفة من 23 وزارة حظيت بدعم الغالبية البرلمانية، خاصة قوى ائتلاف إدارة الدولة، المكونة من الإطار التنسيقي الشيعي وتحالف السيادة السني والحزبين الكرديين الرئيسيين (الديمقراطي والاتحاد الوطني)، وتم التصويت عليها باستثناء وزارتي البيئة والإسكان. أنتخابات بعد عام؟ التعهد بإجراء انتخابات مبكرة في غضون سنة، شكل أحد أبرز بنود البرنامج الوزاري لحكومة السوداني، الذي يرى مراقبون أنه "علامة على أن الحكومة الحالية تدرك أن ثمة مشكلات وتراكمات زادتها حدة الأزمة السياسية التي تواصلت طيلة عام، منذ انتخابات أكتوبر الماضي، ولا بد من تهيئة الأرضية لمثل هذه الانتخابات لمعالجة تلك الأزمات التي تواجه البلاد". ويرى محللون آخرون أن "من الصعب للغاية الإيفاء بهذا التعهد، في ظل التعقيدات المحيطة بالواقع السياسي والأمني العراقي"، مطالبين بمنح حكومة السوداني "فرصة ووقتا للتمهيد لانتخابات مبكرة مثمرة، لا تكون استنساخا لتجربة انتخابات أكتوبر 2021". خلاف كردي كردي وقال الكاتب والصحفي العراقي، مازن الزيدي: "التشكيلة الوزارية للسوداني نالت الثقة بواقع 250 صوتا من أصل 257 حضروا الجلسة، وهو رقم كبير جدا يعكس ثقة البرلمان بها، لتبدأ الحكومة بمباشرة عملها منذ اليوم". وتابع: "الحكومة مكونة من 23 وزارة، تم التصويت على 21 منها، وبقيت الحقيبتين الوزاريتين اللتين ما زالتا مدار خلاف بين الحزبين الكرديين، وهما حقيبتا البيئة والإسكان والإعمار". حكومة خدمة الزيدي أضاف: "البرنامج الحكومي واعد، ويلامس أولويات المرحلة واستحقاقات الوضع الراهن، حيث تركز البرنامج الحكومي على الجوانب الخدمية بالأساس، كونها تقع على رأس أجندة عمل التشكيلة الوزارية التي تحمل عنوان (حكومة الخدمة)، والتي ستركز على 3 ملفات محورية، هي الصحة والكهرباء والإسكان والإعمار، لذا استطاع السوداني أن يقنع الكتل النيابية بمنحه حرية في تسمية من يشغل هذه الحقائب الخدمية البارزة". وتابع: "فيما يتعلق بالانتخابات، هناك طبعا قناعة لدى جميع القوى السياسية بإجراء الانتخابات المبكرة من حيث المبدأ، لكن الخلاف هو على توقيتها، الذي يتوقف بدوره على تنفيذ حزمة إجراءات قانونية وتنفيذية". منهاج متوازن ولكن من جانبه، قال الأكاديمي ورئيس مركز "الأمصار" للدراسات الاستراتيجية رائد العزاوي، "المنهاج الوزاري لحكومة السوداني بصورة عامة جيد ومتوازن، لكن البند المتعلق بإجراء انتخابات مبكرة خلال عام واحد يبدو صعبا جدا تحقيقه، حيث لا يمكن خطو خطوة كبيرة كهذه في غضون هذه المدة القصيرة نسبيا". وتابع: "علاوة على أن الأطراف الرئيسية السنية والكردية ليست مع انتخابات مبكرة مرة أخرى، رغم أن الضرورة الوطنية بالعراق تقتضي بالفعل هكذا انتخابات، لكن لا بد أولا من تغيير قانون الانتخابات، وكذلك قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وإنشاء مفوضية جديدة، ثم الوصول للانتخابات، وهذا المسار مستحيل إنجازه خلال 12 شهرا فقط". واستطرد العزاوي: "الأفضل إعطاء فرصة لهذه الحكومة الجديدة، واختبار مدى جديتها في تحقيق برنامجها الوزاري الذي طرحته، والذي يمكن ببساطة تغيير البند المتعلق فيه بالتعهد بتنظيم الانتخابات المبكرة، حيث أن العراق بعد أزمة سياسية طاحنة على مدى سنة كاملة، بحاجة لمرحلة استقرار وإن كان نسبيا، لالتقاط أنفاسه، قبل الإقدام على خوض غمار تجربة انتخابات جديدة مبكرة". واعتبر أن "الاستعجال في الانتخابات قد ينجم عنه تكرار سيناريو أزمة انتخابات 10 أكتوبر من العام الماضي، وما تبعه من انسداد سياسي حاد". المصدر:سكاي نيوزعربية
عربية :Draw منح البرلمان العراقي، مساء الخميس، الثقة لحكومة رئيس مجلس الوزراء المكلف، محمد شياع السوداني، بعد عرضه برنامجه الحكومي، الذي حصل على أغلبية مطلقة بالتصويت. وجاءت التشكيلة الحكومية على النحو التالي، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ونائبه فؤاد حسين وهو أيضاً وزيراً للخارجية، ونائب ثاني وهو وزير النفط حيان عبد الغني، ونائب ثالث لرئيس الوزراء وهو كذلك وزير التخطيط محمد تميم. وتوزعت الوزارات كالتالي: وزيرة المالية طيف سامي، وزير الدفاع ثابت العباسي، وزير الداخلية الفريق أول الركن عبد الامير الشمري، وزير الصحة صالح مهدي، وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق، وزير النقل رزاق محيبس، وزير الموارد المائية عون ذياب، وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، وزير الشباب والرياضة احمد محمد حسين، وزير التربية ابراهيم نامس، وزير التجارة اثير داود، وزير العدل خالد شواني، وزير الكهرباء زياد علي، وزيرة الاتصالات هيام الموسوي، وزير الزراعة عباس المالكي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، وزير الصناعة والمعادن خالد بتال، وزير الثقافة والسياحة والاثار احمد فكاك.
عربية :Draw كشف رئيس المجلس الاستشاري العراقي فرهاد علاء الدين الثلاثاء عن تقدم في المفاوضات بين قوى الإطار التنسيقي، في عملية توزيع حصتهم الوزارية من حكومة محمد شياع السوداني والبالغة 12 وزارة. ويواجه التشكيل الحكومي في العراق العديد من التعقيدات، في ظل صراعات بين القوى السياسية حول الحقائب الوزارية. وقد أظهر رئيس الوزراء المكلف ضعفا فادحا في فرض سلطة القرار بشأن اختيار فريقه الحكومي، ليتحول إلى مجرد لاعب ثانوي، الأمر الذي شكل خيبة أمل كبيرة بالنسبة للعراقيين الذين استبشروا خيرا في وقت سابق بنهاية الأزمة السياسية، من خلال استكمال الاستحقاقات الدستورية. ووفق رئيس المجلس الاستشاري العراقي، فإن الإطار تمكن من تفكيك جزء كبير من الخلافات حول الحقائب الوزارية، حيث ستكون لتحالف الفتح الذي يضم منظمة بدر وكتائب عصائب أهل الحق وتحالف سند، أربع وزارات مقابل خمس وزارات لائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي، وثلاث وزارات سيعين وزراءها رئيس الوزراء المكلف. وأوضح علاء الدين في تصريحات لوسائل إعلام محلية أن “الإطار التنسيقي تمكن من التوصل إلى نتيجة وفك العقدة بين أطرافه، والتي كانت تتمثل في وزارة النفط والخلافات بين الفتح ودولة القانون”. وأشار علاء الدين إلى أن “الفضيلة وفالح الفياض والمستقلين وكتلة تصميم في البصرة لم يفوزوا بوزارات، الأمر الذي أثار غضبهم وانسحبوا من الاجتماع الأخير للإطار”. وأوضح أن “وزارة الداخلية، وهي واحدة من الوزارات المختلف عليها بين الأطراف الشيعية، جرى حل عقدتها”، مبينا أن “وزارة النفط ستذهب لدولة القانون، والداخلية للفتح”. ولفت علاء الدين إلى أن “هناك اتفاقا داخل تحالف الفتح بشأن أن تذهب وزارتان من حصته لبدر واثنتان للعصائب وواحدة لسند، ومن المحتمل أن تستعيد العصائب وزارة العمل والضمان الاجتماعي”. وأشار إلى أن “وزارات الكهرباء والصحة والمالية ستبقى عند الشيعة، لكن أمرها سيوكل إلى السوداني، حيث إن هناك اتفاقا مبدئيا على أن يعين هو الوزراء لها“. وشهد العراق انفراجة حذرة بعد أن نجح البرلمان في انتخاب رئيس للجمهورية، والذي بدوره كلّف محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة المتعثر تكوينها لأكثر من سنة، وهو موعد إجراء الانتخابات المبكرة. ويقول السوداني إنه يعمل على عرض مرشحي حكومته على البرلمان في أسرع وقت، لكن عقبات عدة اعترضت هذا الطريق، بدءا بحاضنته السياسية، الإطار التنسيقي. ويرى مراقبون أن الخلافات بين القوى السياسية تعكس عقلية “الغنيمة” التي تدار بها عملية تشكيل الحكومة، لافتين إلى أن في ضوء ما يحصل، من غير المرجح رؤية حكومة قوية وفاعلة، مثلما يصرح بذلك السوداني. المصدر: صحيفة العرب اللندنية
عربيةDraw : اشتد الخلاف داخل قوى الإطار التنسيقي والقيادات السنية، حول "مزاد الوزارات"، في حكومة المُكلف محمد شياع السوداني، وهو ما تسبب بتأجيل التصويت على الحكومة في البرلمان العراقي. وسبق أن أكد ائتلاف "إدارة الدولة"، الذي يجمع القوى السياسية العراقية الرئيسة في البلاد، عدا التيار الصدري، أنه سيدعو إلى عقد جلسة لمجلس النواب العراقي مخصصة للتصويت على منح الثقة للحكومة اليوم السبت. وحتى صباح السبت، لم يصدر عن البرلمان العراقي ما يفيد بعقد جلسة السبت، كذلك لم تشهد العاصمة أي إجراءات أمنية مشددة تشير إلى مساعٍ لعقد الجلسة. وإلى ساعة متأخرة من ليل الجمعة، واصل السوداني حواراته مع القوى السياسية للتفاهم بشأن توزيع الحقائب، إلا أن قيادي في تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم المنضوي في الإطار التنسيقي أكد أن "الخلافات ما زالت بشأن عدد من الوزارات، وأن السوداني يسعى لتضييق دائرة الخلاف حتى لا يتسع عدد الوزارات التي قد تدار بالوكالة". وفي سياق الصراع على المناصب السيادية في الحكومة العراقية المقبلة، أشعل منصب وزارة الدفاع خلافات واسعة داخل القوى السنية، فيما ألهب منصب وزارة الداخلية الخلافات داخل الإطار التنسيقي. وكشف مصدر برلماني مطلع عن وجود ثلاثة مرشحين يتنافسون على حقيبة الدفاع وهم "خالد العبيدي وحمد النامس (مرشحي مرشح تحالف العزم) والفريق الركن ناصر الغنام (مرشح تحالف السيادة) "، موضحاً أن كل مرشح منهم مدعوم من كيان سني او برلماني مخضرم. وتابع المصدر أن القيادات السنية المنشقة لم تتوصل الى أي توافق حيالها حتى الآن، مرجحاً استمرار الخلافات السنية وبقاء وزارة الدفاع تحت إدارة رئيس الوزراء بالوكالة. وأشار الى أن مفاوضات جارية على قدم وساق للتوافق على وزارة الدفاع بصفقة سرية قبل الدفع بمرشح حقيبة الدفاع إلى التصويت البرلماني. إلى ذلك، كشف قيادي في الإطار التنسيقي الشيعي في تصريحات إعلامية، السبت، بنشوب خلافات واسعة داخل قوى الإطار حيال منصب وزارة الداخلية، مشيراً إلى أن المنافسة محتدمة بين 3 مرشحين هم كلاً من مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، ومستشار وزارة الداخلية اللواء مهدي الفكيكي. كما يحتدم الخلاف أيضا بين حركة عصائب أهل الحق، وكتائب حزب الله، إذ يرغب الطرفان، بحصول كل منهما على منصب رئيس جهاز المخابرات. من المعروف أن جهاز المخابرات العراقي، بعيد عن سلطة الفصائل المسلحة، وجميع من تولى إدارته خلال السنوات الماضية، كان بعيدًا عن تلك المجموعات وتوجهاتها، مثل رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي، الذي أدار المنصب لعدة سنوات، والرئيس الحالي رائد جوحي، وهو قاضٍ سابق. ومنذ أيام يُجري السوداني، مشاورات مع تلك القوى، بهدف إقناعها والوصول معها إلى تسوية بشأن حكومته، وسط مخاوف من تصاعد الخلافات بشكل أكبر. وفي الوقت الذي كانت فيه المناصب الوزارية الحكومية توزع بين التيار الصدري والقوى السياسية الأخرى، فإن الحكومة الحالية، سيستحوذ عليها الإطار التنسيقي، بواقع 12 وزارة، ستوزع كالتالي: 4 لدولة القانون بزعامة نوري المالكي، و6 لتحالف الفتح بزعامة هادي العامري، واثنتان لتحالف المستقلين. وبدت المحاصصة الحزبية والطائفية، طاغية على حكومة السوداني، مقارنة بحكومة مصطفى الكاظمي، الذي منحه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، حرية الاختيار في بعض الوزارات، ما مكّنه من المجيء بشخصيات مستقلة. وترى أوساط سياسية أن المزاد الحاصل في منح الوزارات، والانغماس في المحاصصة الحزبية، سيعوق السوداني عن تشكيل حكومة قوية، لا سيما في وجود شخصيات ورجال أعمال، يريدون أشخاصًا بعينهم لتسلم المناصب الوزارية، ويتدخلون في هذا الشأن. وتشير هذه الأوساط إلى الصراع والخلاف ما بين الكتل والأحزاب المتنفذة على المناصب والوزارات هو سبب عرقلة تشكيل الحكومة الجديدة، وهذا الصراع تشهده العملية السياسية مع تشكيل أي حكومة جديدة، طيلة السنوات السابقة. وتعتقد نفس الأوساط أن القوى السياسية تريد ضمان نفوذها ووجودها السياسي من خلال المناصب التي تستحوذ عليها في كل حكومة، ولهذا هي لن تدعم السوداني لتشكيل الحكومة، دون أن تأخذ ما تريد من مناصب، وبخلاف ذلك، ربما يفشل السوداني في مهام تشكيل الحكومة بسبب صراع المناصب كما حصل في سنة 2019 مع محمد توفيق علاوي وعدنان الزرفي. ومن غير المستبعد أن يدفع تشكيل حكومة السوداني وفق ما تريده الكتل والأحزاب من تقاسم للمناصب الشارع العراقي، الى التظاهر والاحتجاج، خصوصاً مع قرب ذكرى انطلاق تظاهرات 25 تشرين/اكتوبر، خصوصا في ظل دعوات للتظاهر والاحتجاج لرفض أي حكومة تشكل وفق المحاصصة والتوافق. ووفق تفاهمات الكتل النيابية، فإن وزارة الخارجية من حصة الأكراد، ووزارة الداخلية من حصة الشيعة، فيما وزارة الدفاع من حصة العرب السنة. ولا توجد معطيات رسمية تشير إلى عدد وزارات كل مكون من المكونات الأساسية للمجتمع العراقي، لكنّ متابعين يشيرون إلى أن الشيعة يحصلون في كل تشكيلة حكومية على ما بين 11 و12 وزارة، بينما يحصل العرب السنة على 6 أو 7 وزارات، والأكراد على 4 أو 5 وزارات، وتعطى وزارة واحدة لممثلي الأقليات. صحيفة العرب
عربية Draw: وصلت أحزاب الإطار التنسيقي لمرحلة «شيطان التفاصيل» خلال مفاوضات توزيع الحقائب على القوى المتحالفة لتشكيل الحكومة، برئاسة المكلف محمد شياع السوداني، فيما تتردد أحزاب شيعية في طريقة «الاستحواذ» على حصة زعيم التيار الصدري التي شغلها خلال الدورات السابقة. وقال مصدران، من تحالف السيادة والإطار التنسيقي، إن خريطة الحصص تغيرت بسبب خلاف على الوزارات المحسوبة على التيار الصدري، بعد أن تراجعوا عن فكرة تأجيل تسميتها إلى حين التفاهم مع الصدريين. وتدفع أحزاب شيعية للاستحواذ على وزارات التيار، قبل أن يتفقوا على تسمية ثلاث وزارات من أصل خمس، وفق ما ذكره مصدر من الإطار التنسيقي. وقال رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، في بيان صحافي، إن «الإطار التنسيقي سيمنح الفرصة لأي كتلة لطرح مرشحيها لكل الوزارات، ويُترك أمر الاختيار لرئيس الوزراء المكلف بناءً على الكفاءة والنزاهة، وفقاً للأوزان الانتخابية». وقبل ذلك، كان الإطار التنسيقي يعقد اجتماعا لتفويض السوداني باختيار المرشحين أو اقتراح غيرهم، وأكد في بيان صحافي أنه «يعمل على تذليل العقبات أمام الرئيس المكلف». لكن العقبات بدأت تظهر بالفعل خلال مفاوضات تشكيل الحكومة، بسبب نزاع القوى السياسية على حقائب بعينها في الحكومة، وهو ما يتناقض كثيراً مع إعلان تفويض الرئيس المكلف حرية الاختيار. وقال مصدر، مطلع على المفاوضات، إن «الحماس الشديد للسيطرة على المفاصل الأمنية على وجه الخصوص يتملك قادة الإطار»، فيما يضع عدد منهم المواقع الأمنية أولويةً غير قابلة للنقاش. وتعكس طبيعة المفاوضات الجارية، والرغبة في حسم الكابينة الوزارية بأسرع وقت، رغبة القوى الشيعية الموالية لإيران في استثمار هذه الفرصة التي وفرها لهم انسحاب التيار الصدري من المعادلة. لكن «شيطان التفاصيل» بدأ يعرقل بالفعل مسار المفاوضات بسبب خلافات بين القوى الثلاث، السنة والكرد والشيعة،على وزارات سيادية وخدمية، كالنفط والإسكان، إلى جانب نزاع مواز داخل التحالف السني على تسمية وزير الدفاع. وأعلن الإطار التنسيقي، مساء الخميس، «استثناء وزارتي الداخلية والدفاع من المحاصصة وترشيح شخصيات مدنية أوعسكرية، بما يضمن تحقيق حكومة خدمة فاعلة تتفق مع البرنامج الوزاري»، لكن المؤشرات تفيد بأن المنصبين لن يخرجا عن تقليد سياسي دام عقدين. وقال مصدر سني مطلع، إن خلافا على وزارة واحدة أعاد المفاوضات إلى نقطة البداية، لأن الحصص مرتبطة ببعضها ضمن المعادلة وأي تعثر في واحدة منها يحول المشاورات إلى لعبة «السلم والثعبان". وإلى جانب ذلك، فإن عددا من الكتل الشيعية طلبت مراجعة حصصها بعد حصولها على مقاعد إضافية لانضمام نواب مستقلين إليها، ما فتح الباب لخلاف آخر على آلية احتساب الوزن الانتخابي لكل كتلة. وعرضت قوى الإطار التنسيقي على الصدر المشاركة في الحكومة القادمة طبقاً لوزنه الانتخابي قبل انسحابه من البرلمان، وذلك بمنحه 6 وزارات هي نصف وزارات الشيعة، إلا أن الصدر أعلن رفضه لهذا العرض، كما أعلن براءته من أي مسؤول صدري حالي أو سابق يمكن أن يشارك في حكومة السوداني تحت غطاء مشاركة الصدريين. ولم تحدد رئاسة البرلمان موعداً لعقد جلسة التصويت على حكومة محمد شياع السوداني. وفي وقت تضاربت الأنباء بشأن عدد الحقائب التي أصبحت جاهزة ومعدة للتصويت بحيث تنال الحكومة الثقة بها، لكونها أكثر من النصف المطلوب، لكن خلافات اللحظات الأخيرة عقدت المشهد مرة أخرى. وأعلن ائتلاف إدارة الدولة، الذي يضم كل القوى السياسية المشاركة في الانتخابات التي أجريت أواخر العام الماضي، باستثناء التيار الصدري الذي انسحب من البرلمان في شهر يونيو (حزيران) الماضي، الاثنين الماضي، أنه عقد العزم على عقد جلسة اليوم السبت للتصويت على الحكومة. لكن رئاسة البرلمان لم تعلن عن عقد الجلسة. وعلى الرغم من تأكيدات عدد من قياديي الكتل السياسية أن البرلمان سوف يعقد جلسته الاثنين القادم، قبل يوم من موعد تظاهرات يوم 25 من الشهر الحالي، فإن مصدراً مطلعاً على حوارات الكتل السياسية أكد أنه «لاتوجد مؤشرات حتى الآن على عقد جلسة يوم الاثنين بسبب بروز خلافات جديدة بين الكتل السياسية». وأضاف المصدر المطلع أن «الأمور كانت ماضية حتى قبل أيام باتجاه عقد جلسة البرلمان يوم السبت، لولا ظهور خلافات لم تكن متوقعة بين الكتل السياسية بشأن الوزارات والأسماء المرشحة لبعض الوزارات، خصوصاً تلك التي تتنافس عليها بعض الكتل، وبالدرجة الأساس الوزارات السيادية مثل الدفاع والداخلية والنفط والمالية. وأوضح المصدر المطلع أن «الكتل السياسية لا تزال في مرحلة تقاسم الوزارات ولم تصل إلى الأسماء المرشحة، وهو ما يعني صعوبة تمرير الحكومة حتى يوم الاثنين، ما لم يتم تدارك كل ذلك خلال الساعات القادمة». إلى ذلك، جدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر براءته من مثيري الشغب المحتملين بهدف زعزعة الأمن. وقال صالح محمد العراقي، المقرب من زعيم التيار الصدري والناطق باسمه، والذي يُعرف بـ«وزير القائد»، في تغريدة له على موقع «تويتر»: «تناهى إلى مسامعي أن هناك من يسعى لتشكيل مجاميع خاصة عسكرية، مهمتها خرق الشرع والقانون وزعزعة أمن الوطن»، مضيفاً: «هذه ليست أفعالنا ولا أخلاقنا ولا طريقتنا في التعامل حتى مع الفاسدين، فضلاً عمن سواهم». وأعلن الصدر البراءة من هذه المساعي، ودعا الجميع إلى التعاون بالإبلاغ عنهم وعدم الانخراط معهم، مشيراً إلى أن «أعمالهم مخالفة لكل القوانين السماوية والوضعية والنظم الأخلاقية والاجتماعية». وتأتي براءة الصدر من هذه المجاميع بالتزامن مع إطلاق تظاهرات يوم الخامس والعشرين من الشهر الحالي، بمناسبة الذكرى الثالثة لانتفاضة أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019 المصدر: الشرق الاوسط .
عربيةDraw: لاحظ المراقبون نشاطاً فوق العادة للسفيرة الأميركية في العراق إلينا رومانوسكي، منذ أن حصل محمد شياع السوداني على أوراق تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة. وبحسب بيانات رسمية، فقد كثفت رومانوسكي خلال الأسبوع المنصرم زياراتها للسوداني ورئيسي الجمهورية والبرلمان لبحث تشكيل الحكومة. لكن مصادر سياسية عراقية على اطلاع بهذه الاجتماعات، قالت إن السفيرة كانت "حريصة جداً على أن تنجح جهود القوى السياسية في تشكيل الكابينة الوزارية من دون تأخير". ونقلت مصادر مطلعة جانباً من نقاش دار بين السوداني والسفيرة، عن "ضرورة تشكيل حكومة تسهم في استعادة الاستقرار الأمني والسياسي في البلاد"، وأنها استخدمت عبارات من قبيل "من الجيد الاستفادة من تجربة الحكومات السابقة، لأن الفشل هذه المرة سيكلف العراق تداعيات خطيرة". وحاولت قيادات عراقية طمأنة السفيرة الأميركية في بغداد، بأن الحكومة الجديدة ستحافظ على علاقاتها الاستراتيجية بواشنطن، وأنها تحظى بدعم سياسي كبير في البرلمان، والذي سيمنحها الثقة بسهولة، وفق ما ذكر قيادي في "تحالف الفتح". كما أبلغ السوداني السفير الألماني في العراق، مارتن ييغر، أن حكومته المرتقبة تسعى إلى "بناء علاقات متوازنة مع محيطها الإقليمي والدولي". وبشأن مسار تشكيل الحكومة، قال مصدر مقرب من رئيس الوزراء المكلف، إن التشكيلة الوزارية ستكون "هجينة من شخصيات حزبية ومستقلين وتكنوقراط"، وإن السوداني لم يواجه عقبات في مسألة اختيارهم، لأن الأحزاب المنضوية قدمت له خيارات عديدة للمفاضلة. وأوضح المصدر أن السوداني طلب من قادة الأحزاب تذليل العقبات السياسية والإدارية لتشكيل الحكومة بالسرعة الممكنة. وأعلن تحالف "إرادة الدولة" الذي يضم "الإطار التنسيقي" و"تحالف السيادة" والقوى الكوردية، في وقت سابق، أنه حدد السبت المقبل موعداً للتصويت على الحكومة الجديدة. وقال عضو "ائتلاف دولة القانون" ثائر مخيف، إن التشكيلة الوزارية ستكون كاملة ما عدا وزارتين، ستؤجل تسمية وزيريهما إلى وقت لاحق. لكن مصدراً من "تحالف السيادة" أكد أن الموعد قد يتأجل لأيام معدودة لأن السوداني لم يتسلم سوى مرشحي الأحزاب الشيعية بانتظار قوائم وزراء بقية الحلفاء. والحال، أن الوزارات توزعت على القوى السياسية وفق نظام النقاط، حيث يبلغ منصب رئاسة الجمهورية 30 نقطة، ونائبه 25 نقطة، والوزير 20 نقطة. وبينما تحاول قوى "الإطار التنسيقي" إظهار قدر عال من الانسجام في مفاوضات الحكومة وترشيح وزرائها، لكن الأمر ليس بهذه البساطة فيما يتعلق بالمناصب التنفيذية في المؤسسات الأمنية والمالية، لا سيما جهاز المخابرات ومكتب رئيس الوزراء. لكن قيادات من "الإطار التنسيقي" لا تزال تخشى من إشغال المناصب التنفيذية التي كان يسيطر عليها "التيار الصدري" لسنوات، فيما تفضل "التعايش مع الوجود الصدري داخل الحكومة لتحاشي تداعيات مضرة باستقرار حكومة السوداني". الشرق الاوسط
عربية Draw: طبقاً لمصادر سياسية عراقية متطابقة فإن المباحثات الخاصة بتشكيل الحكومة، بما فيها توزيع الوزارات والمناصب السيادية، مثل نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس الوزراء، أوشكت على الاكتمال، وبحسب مصدر سياسي مطلع «لا يلوح في الأفق أن الحكومة بعدد حقائبها الـ22 يمكن أن تكون جاهزة السبت المقبل بسبب وجود خلافات حول بعض الحقائب الوزارية». مبيناً أن «الخلافات بشأن ذلك، يمكن أن تنقسم إلى نوعين: الأول يتعلق بتوزيع بعض الوزارات مع الاتفاق على تقسيم الوزارات السيادية (الخارجية والداخلية والدفاع والمالية والنفط) بين المكونات الرئيسية الثلاثة (الشيعية والسنية والكوردية). والنوع الثاني، وربما هو الأهم حتى الآن، يتعلق بالخلاف على توزيع الحصص الوزارية داخل كل مكون من المكونات الرئيسية" ونفى المصدر السياسي ما كان قد أُشيع عن استحداث وزارات جديدة بهدف ترضية بعض الكتل والشخصيات أو توسيع دائرة مشاركة الأقليات، مبيناً أنه «لا صحة لذلك حيث إن عدد الحقائب الوزارية التي سيتم التصويت عليها هي 22 وزارة». واستدرك قائلاً إنه «ليس بالضرورة أن يتم التصويت على كامل الحكومة يوم السبت بسبب استمرار الخلافات التي أشرنا إليها، لكن يمكن أن يتم التصويت على 12 حقيبة وزارية وهو ما يكفي لمنح الحكومة الثقة كما يجعل رئيسها أكثر حرية بالتصرف لا سيما أنه سوف يواجه ملفات وتحديات كثيرة" ورداً على ما ذكر، بشأن إعادة مناصب نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس الوزراء، قال المصدر إن «نواب رئيس الجمهورية سوف يعودون، كون هذا المنصب منصوص عليه دستورياً من دون تحديد العدد. حيث نص الدستور على أنه يحق لرئيس الجمهورية اختيار نائب أو أكثر له»، مبيناً أن «بعض أطراف ائتلاف إدارة الدولة بات يرى أن هناك ضرورة لعودة هذا المنصب عن طريق اختيار ثلاث شخصيات سنية وشيعية كنواب لرئيس الجمهورية الكوردي" الشرق الاوسط
عربية Draw: كشف ائتلاف "إدارة الدولة"، الذي يجمع القوى السياسية العراقية الرئيسة في البلاد، عدا التيار الصدري، اليوم الثلاثاء، عن مجريات تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني، مبيناً أنه سيدعو إلى عقد جلسة لمجلس النواب العراقي مخصصة للتصويت على منح الثقة للحكومة السبت المقبل. ذكر الائتلاف في بيان له عقب اجتماعه، أن "ائتلاف إدارة الدولة عقد اجتماعه الدوري الذي خُصّص لمناقشة تشكيل الحكومة في مكتب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وبحث آخر المستجدات السياسية للبلاد وضرورة الإسراع بتشكيل حكومة الخدمة".وأضاف البيان أن "ائتلاف إدارة الدولة يعتزم دعوة مجلس النواب الى عقد جلسة يوم السبت المقبل للتصويت على الحكومة بكامل أعضائها". من جهته قال قيادي بارز في تحالف الفتح، إن "عقد البرلمان جلسة خاصة للتصويت على منح الثقة لحكومة محمد شياع السوداني يوم السبت المقبل، غير مؤكد، فربما يتم تأجيل الجلسة ليوم آخر، فحتى اللحظة السوداني لم يحسم أمر كابينته (تشكيلته)، وحواراته مع الكتل والأحزاب ما زالت تجري دون اتفاقات نهائية". بيّن أن "إعلان ائتلاف إدارة الدولة لموعد جلسة منح الثقة لحكومة السوداني دون الاتفاق النهائي على موعدها، يهدف إلى جس نبض التيار الصدري، فهو يخشى من رد فعل للصدريين في الشارع قد يعرقل عقد جلسة البرلمان، ولهذا هو أعلن عنها بشكل مبكر حتى يعرف نوايا الصدريين". ولفت إلى أن "السوداني حسم حالياً 14 وزارة فقط مع القوى السياسية، وهناك خلافات على الحقائب الأخرى تتعلق بالمرشحين، وكذلك بمنح هذه الحقائب لأي كتلة وحزب، وهذا الأمر قد يؤجل جلسة منح الثقة، أو يدفع السوداني إلى تقديم كابينة (تشكيلة) وزارية غير كاملة". العربي الجديد
عربية:Draw صاحب إحدى الشركات المتورطة بسحب مبلغ ( 3 ترلیون و 700 ملیار ) دينار من أحد فروع مصرف الرافدين يدعى ( حسين كاوة عبدالقادر بريفكاني) وهو من أهالي محافظة دهوك ويسكن حاليا أربيل، سحبت شركة "بريفكاني" لوحدها مبلغ مقداره ( 447) ملياردينارعراقي من هذا الفرع. بحسب التقاريرالتي اعدت من قبل اللجان المالية والنزاهة، تم سحب مبلغ(3 ترلیون و 700 ملیار) دینار أي ما يعادل (2 ملیار و 500 ملیون ) دولار، وفق مخطط دقيق تورط فيه عدد من مسؤولي مصرف الرافدين، وقام هؤلاء المسؤولين المتورطين بنقل عدد من الموظفين من فرع المصرف إلى فروع اخرى بعد رفضهم التعاون معهم في هذه العملية. وفقا لوثيقة سربتها وزارة المالية من دائرة الضريبة (5) شركات متورطة بسرقة اموال امانات ضريبة الدولة، هذه الشركات عملت لصالح شركة تدعى( الاستشارات الصينية)، هذه الشركات المتورطة تأسست حديثا ويبلغ رأس مالها ( 2) مليون دينار فقط، وقامت بسحب مبلغ ( 100) مليار دينار دفعة واحدة، وهي كالتالي: شركة الحوت الاحدب للتجارة العامة محدودة المسؤولية، سحبت (982 ملیار) دينار شركة رياح بغداد للتجارة العامة محدودة المسؤولية، سحبت (477 ملیار) دينار شركة القانت للمقاولات العامة المحدودة سحبت ( ترليون و 185 ملیار) دینار شركة المبدعون للخدمات النفطية المحدودة سحبت (433 ملیارو 15 ملیون) دينار شركة بادية المساء للتجارة العامة محدودة المسؤولية سحبت (624 ملیار) دینار صاحب إحدى تلك الشركات من القومية الكوردية وفق التقارير التي اعدت حول القضية، صاحب إحدى تلك الشركات المتورطة في عملية سحب تلك المبالغ الطائلة هو من القومية الكوردية يدعى( حسين كاوة عبدالقادر بريفكاني) وهو من أهالي محافظة دهوك ويسكن حاليا أربيل، وصاحب شركة (رياح بغداد)، سحبت هذه الشركة مبلغ (477 ملیار) دينار، وفق المعلومات التي توصلت اليها الجهات المعنية بالتحقيقات،( حسين كاوة عبدالقادر بريفكاني) من مواليد عام 2001، ويحمل جواز سفر صادر من دائرة جوازات أربيل ويسكن ( حي طيراوة) بأربيل قام ( بريفكاني) صاحب شركة ( رياح بغداد) بسحب المبالغ على شكل دفعات من فرعي مصرف الرافدين في حي( الوزيرية والعرب) في العاصمة بغداد. قام ( بريفكاني ) في المرة الاولى وبتاريخ 31 اذار 2022، بصرف (5) صكوك، دفعة واحدة، وبلغ قيمة الصك الواحد ( 20) ملياردينار، أي انه سحب فقط في المرة الاولى( 100) مليار دينار. وقام في المرة الاخيرة وبتاريخ 11 أب 2022، بصرف( 4) صكوك، ( 3) منها بقيمة ( 10) مليارات دينار وقيمة الصك الرابع ( 15) ملياردينار، أي انه قام بسحب مبلغ ( 45) مليار دينار دفعة واحدة، بلغ مجموع الاموال التي قامت شركة ( رياح بغداد) بسحبها من فرع مصرف الرافدين (477) ملیار دینار من مجموع ( 3 ترلیون و 700) ملیار دینار.
عربية:Draw كشفت لجنة النزاهة في البرلمان العراقي، اليوم الاثنين، عن وثائق تظهر شراء البنك المركزي العراقي 30 طناً من الذهب خلال الفترة الماضية، موجهة خطاباً إلى البنك للإجابة عن عدة أسئلة حول قيمة الصفقة وسببها والجهة التي تم شراء الذهب منها، في وقت تتفاعل شعبيا قضية سرقة مبلغ مليارين ونصف المليار دولار من عائدات ضريبية في مصرف الرافدين الحكومي ببغداد. وكشفت لجنة النزاهة في البرلمان العراقي وثائق تظهر توجيه نائب رئيسة اللجنة، عالية نصيف، سؤالا إلى محافظ البنك المركزي مصطفى غالب حول عملية شراء البنك لـ30 طناً من الذهب. وبحسب الوثائق الصادرة التي نشرتها وسائل إعلام محلية عراقية، قالت نصيف: "وردتنا معلومات بأن البنك اشترى أكثر من 30 طنا من الذهب، وهي أكبر صفقة شراء للبنك المركزي. أرجو أجابتنا عن الأسئلة التالية". وأضافت: "ما مصدر البيع بنك حكومي؟ منجم خاص؟ ملك؟ وهل تم فحص الذهب في مصافٍ معترف بها دوليا؟ ومن هي الجهة المكلفة بالشراء؟ وما هو سعر الشراء؟ وهل يوجد خصم عن سعر البورصة المعمول بها، الآن الخصم 6%؟". كما طالبت لجنة النزاهة بـ"معرفة هل تم نقل الذهب إلى البنك المركزي أو بقي في عهدة البائع"، وختمت بالقول: "لدينا مخاوف كبيرة في ظل ما يجري في العراق من فوضى". وردا على استيضاح لجنة النزاهة في البرلمان العراقي، أجاب محافظ المركزي، في بيان له، أن مصدر بيع الذهب هو البورصات العالمية، كما أن جميع الذهب الذي تم شراؤه من الأسواق العالمية ضمن المواصفات (London Good Delivery)، وبأعلى درجات النقاوة المتاحة في السوق 999.9". وعن الجهة المكلفة بالشراء، أجاب المحافظ بأنها "المركزي الفرنسي ومصرف جي بي مورغان". كما أوضح محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب بالقول إن "عملية شراء الذهب من الأسواق العالمية لا تتم دفعة واحدة لكميات كهذه، إذ تُقسَّم على كميات صغيرة، وعلى أيام متعددة، لضمان عدم التأثير على سعر الذهب. وبالرغم من هذا يحدث ارتفاع في السعر عند طلب كميات الشراء أو بعده". وأشار محافظ المركزي العراقي إلى أنه "بالنسبة لهذه العملية فقد اشتملت على 19 دفعة وعلى مدى 13 يوم عمل، وفقا لأفضل الأسعار"، مبينا أن "جميع كميات الذهب المشتراة في خزائن الحفظ تحت اسم البنك المركزي العراقي في البنوك المركزية العالمية بعد يومين أو ثلاثة أيام عمل من عملية الشراء". وأكد أن العراق تقدم في حيازات الاحتياطيات من الذهب 10 مراتب عالميا، متقدما بذلك على 9 دول، منها 7 دول أجنبية، ودولتان عربيتان، فضلا عن مؤسسة بنك التسويات الدولية، ليصبح العراق في المرتبة 30 بعد أن كان في المرتبة 40، العربي الجديد
عربية Draw: أمام محمد شياع السوداني، الذي كلّف الخميس تشكيل حكومة عراقية جديدة بعد عام من الشلل السياسي، مهمة لا يستهان بها، إذ على الرجل المنبثق من الطبقة السياسية الشيعية التقليدية، أن يدير الدفّة وسط انقسام حاد وأن يحظى بقبول منتقديه. خبِر محمد الشياع السوداني النائب لدورتين، المولود في جنوب العراق ذي الغالبية الشيعية في 4 آذار/مارس 1970، السياسة منذ العام 2004، أي بعد سقوط نظام حزب البعث. ويخلف مصطفى الكاظمي (52 عاماً) الصحافي السابق ورئيس المخابرات والذي لم يكن معروفاً على الساحة السياسية عند توليه المنصب. وبعدما كان السوداني قائمقاما في ميسان التي يتحدّر منها ثمّ محافظاً لها، تولّى وزارات عديدة منذ العام 2010، من ضمنها في ظلّ حكومة زعيم حزب الدعوة نوري المالكي، الذي كان السوداني ينتمي إليه كذلك، كوزارة حقوق الإنسان ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصناعة بالوكالة. كما أن هذه ليست المرة الأولى التي يطرح فيها اسمه لرئاسة الوزراء، فقد رشّح في العام 2018 ثم في العام 2019، في خضّم انتفاضة شعبية ضدّ الطبقة السياسية، لكن اسمه قوبل حينها برفض المتظاهرين. وكان طرح اسمه في العام 2022 شرارة لتظاهرات التيار الصدري واقتحام مناصريه البرلمان العراقي والاعتصام أمامه لأكثر من شهر، اذ أعرب المتظاهرون حينها عن رفضهم القاطع له باعتبار أنه من طبقة سياسية يرفضونها ويتهمونها بالفساد. وبالنسبة للصدريين، “يبدو السوداني وكأنه من معسكر المالكي”، الخصم التاريخي للصدر، “وهذه مشكلة نظراً لعدم ثقتهم بالمالكي ومحيطه”، كما يشرح سجاد جياد من معهد “سنتشوري إنترناشونال”. أما بالنسبة لناشطي انتفاضة تشرين، “فهو ليس معروفاً بكونه مصلحا، وليس لديه تاريخ بذلك…لا يملك تاريخاً سيئاً ولا توجد حوله شبهات فساد لكن … واقع أنه منبثق من النخبة السياسية” التقليدية، “لا يعطي ثقةً بأنه سيكون مختلفاً عنهم”. “مكافحة الفساد” في المقابل، يرى نائب أمين عام تيار الفراتين الذي يرأسه السوداني منذ تأسيسه في العام 2021، بشار الساعدي أن رصيد السوداني في العمل السياسي أمر إيجابي، فهو “يجيد العمل الوزاري ويعرف كيف تدار الأمور وزارياً وكيف تدار القضايا من الجانب السياسي والجانب الإداري” ويصفه بـ”رجل الدولة”. أمام هذه العقبات الجمّة، بدأ السوداني، الأب لخمسة أولاد والذي يظهر دائماً ببزة أنيقة وربطة عنق وشاربين مشذبين، ينشط إعلامياً ويطرح برنامجه الانتخابي، الذي يحمل طابعاً اجتماعياً بشكل عام ويضمّ خصوصاً ملفات خدمية مثل الصحة والكهرباء والزراعة والصناعة والخدمات البلدية، لكن أيضاً “مكافحة الفساد”. وقال السوداني في مقابلة نشرت مقتطفات منها على قناته الخاصة في تلغرام “لدي طرق غير تقليدية لمكافحة الفساد”. ومن ضمن أولوياته، وفق بشار الساعدي “المضي بقانون الموازنة” ومعالجة قضايا “الكهرباء والصحة والخدمات” و”إكمال المشاريع المتلكئة” و”خفض مستوى الفقر والبطالة”. انتخابات مبكرة غير أنه اعلن أيضاً استعداده لتنظيم انتخابات مبكرة هي مطلب التيار الصدري الذي وصفه بـ”التيار الشعبي والوطني الكبير”. وقال “قرار الانتخابات جرى الاتفاق عليه وتم تضمينه ضمن المنهاج الوزاري وموعدها لن يتجاوز سنة ونصف سنة”. ويسعى السوداني المتخرّج من كلية العلوم الزراعية في جامعة بغداد، كذلك إلى تحقيق نوع من “التوازن” في العلاقات مع دول الجوار والعالم في بلد غالباً ما يجد نفسه تحت نيران صراعات إقليمية، كما قال. يرى المحلل السياسي حمزة حداد أن السوداني، رغم الانتقادات ضده، “نجح بإعادة خلق نفسه، حيث ترك دولة القانون وفاز بمقعد في البرلمان منفرداً، بعد أربع سنوات كان فيها نائباً نشطاً بعيون الرأي العام”، وفق حداد. كل ذلك أسهم في “تسميته لرئاسة الوزراء”. ويعتبر أن “الدعوات التي خرجت ضدّ ترشيحه، لم تكن شخصية، إنما مرتبطة بظرف كونه مرشح الإطار التنسيقي”، فهو “يتمتع بعلاقات جيدة مع كل الأحزاب السياسية”. لا يملك تياره الفتيّ سوى3 نواب في البرلمان الحالي، من ضمنهم السوداني نفسه، لكنه يحظى بدعم القاعدة البرلمانية الواسعة في البرلمان الحالي التي يهيمن عليها الإطار التنسيقي. من ضمن نقاط قوته أيضاً أنه لم يغادر العراق. وهو “يمثّل مثل الكاظمي الجيل الجديد من السياسيين الذين جاؤوا بعد العام 2003″، وفق حداد. فالسوداني، الذي أعدم والده على يد حزب البعث حين كان يبلغ تسع سنوات، “ابن الجنوب ولا يملك جنسية مزدوجة ووجه شاب”، بحسب الساعدي. المصدر: القدس العربي
عربية:Draw تقول مصادر سياسية مطلعة، إن "الهدف من زيارة الوفد السياسي المكون من تحالف السيادة والإطار التنسيقي إلى أربيل والاجتماع مع بارزاني طرح مبادرة لحل الخلاف على رئاسة الجمهورية مع الاتحاد الوطني الكردستاني من خلال تغيير مرشح الاتحاد بمرشح آخر يحصل توافق عليه مع الحزب الديمقراطي الكردستاني مع إعطاء المناصب الوزارية من حصة الكرد للأخير". وتضيف المصادر، أن "الوفد أوصل رسالة إلى القوى الكردية خلال اجتماعه قبل يومين في بغداد مع رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني واليوم خلال الاجتماع مع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني بأن عدم اتفاق الكرد خلال الأسبوع الحالي سوف يدفع إلى عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية من دون انتظار الاتفاق الكردي- الكردي لمنع عرقلة تشكيل الحكومة لفترة أطول". وتبين أن "الحزبين الكرديين رفضا مقترح الوفد السياسي، وطلبا مزيدا من الوقت لإجراء الحوار والتفاوض خلال اليومين المقبلين لحسم ملف رئاسة الجمهورية بشكل توافقي، فيما شدد بارزاني على رفض عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية من دون الاتفاق المسبق مع الاتحاد، وأبلغهم بأن أي جلسة من دون ذلك سوف تتم مقاطعتها وكسر نصابها مع حليفه تحالف السيادة". وتشير المصادر إلى أن "الوفد طلب من بارزاني التواصل مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من أجل التفاهم لمنع أي تصعيد شعبي يعرقل عملية تشكيل الحكومة الجديدة، إذا ما تم الاتفاق على تحديد موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف مرشح رئاسة الوزراء". وكان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر والقيادي في الإطار التنسيقي فالح الفياض والمرشح لرئاسة الحكومة محمد شياع السوداني، وصلوا يوم أمس، إلى أربيل والتقوا رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني. يشار إلى أن الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين، دخلا في صراع كبير بعد إجراء الانتخابات النيابية خلال تشرين الاول أكتوبر الماضي، حول منصب رئيس الجمهورية، فقد طالب الأول بهذا المنصب، كونه صاحب أكبر عدد من المقاعد النيابية عن الأحزاب الكردية، في وقت يصر الآخر عليه، نظرا لتقاسم المناصب القائم منذ 2005، حيث يسيطر الحزب الديمقراطي على مناصب حكومة الإقليم فيما تذهب رئاسة الجمهورية للاتحاد الوطني. المصدر: العالم الجديد
عربية Draw: تجددت الاثنين الدعوات إلى الأطراف السياسية في العراق للحوار لحل الأزمة في البلاد بعد عام على الانتخابات التشريعية، في وقت يؤكد الإطار التنسيقي الذي يشكل المظلة الجامعة للقوى الموالية أن "تحالف إدارة الدولة" تحرك للتفاهم مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشأن تشكيل الحكومة، مشيرا إلى أن البرلمان سيعقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية الأربعاء المقبل. لكن على بعد عام من ذلك، ما زالت الأحزاب السياسية نفسها تهيمن على السلطة في البلاد. وعلى الرغم من المفاوضات اللامتناهية فيما بينها، فشلت أطراف الأزمة في التوصل إلى اتفاق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتسمية رئيس جديد للوزراء. وحذرت بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي" في بيانها الاثنين من أن العراق لم يعد أمامه "الكثير من الوقت، لاسيما أن الأزمة التي طال أمدها تنذر بالمزيد من عدم الاستقرار، والأحداث الأخيرة دليل على ذلك"، في إشارة إلى المواجهات المسلحة التي شهدها العراق في أغسطس الماضي وخلال الأسبوع الماضي في البصرة. كما حثّت الجهات الفاعلة كافة الانخراط في حوار دون شروط مسبقة، ودعت ساسة البلاد إلى "الاتفاق بشكل جماعي على النتائج الرئيسة من خلال تقديم تنازلات تعيد التأكيد على هدفهم المعلن، وهو تلبية احتياجات الشعب العراقي وتشكيل حكومة ذات صلاحيات كاملة وفاعلة". لايزال الحزبان الكورديان منقسمين على حسم مرشحهما لرئاسة الجمهورية، والذي جرى العرف السياسي في البلاد، بعد الغزو الأميركي عام 2003، أن يكون المنصب من حصّة القوى الكوردية. يحرص الإطار التنسيقي، الذي يشكل المظلة الجامعة للقوى الموالية لإيران، على تشكيل تحالف سياسي واسع يضمن له السيطرة على دفة الأمور، لكنه يواجه صعوبات في مقدمتها الخلاف بين القوى الكوردية على آلية اختيار رئيس للجمهورية. تقول أوساط سياسية عراقية إلى ان العقدة الرئيسية التي تحول دون اتفاق نهائي حول هذا الائتلاف هي استمرار الخلاف بين الحزبين الكورديين الرئيسيين على رئاسة الجمهورية. ويصر الحزب الديمقراطي الكوردستاني على أن يكون المنصب من حصته، في ضوء النتائج الانتخابية في الإقليم، والتي حصد فيها المرتبة الأولى، بينما يصر الاتحاد الوطني في السليمانية على تجديد ولاية الرئيس الحالي برهم صالح. وتطرح قوى الإطار التنسيقي فكرة دخول القوى الكوردية بمرشحين اثنين، وتكون الغلبة بالأصوات البرلمانية لا التوافق، وهو ما يرفضه مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، على اعتبار أن الإطار التنسيقي سيصوت لصالح مرشح حليفه التقليدي، الاتحاد الوطني الكوردستاني. ويرى مراقبون أن عدم اتفاق الحزبين الكورديين على آلية لاختيار رئيس للجمهورية سيبقي اتفاق تشكيل ائتلاف إدارة الدولة معلقا، وهو الأمر الذي لا يخدم العراق، الذي يكمل الاثنين عامه الأول منذ إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة، دون حكومة جديدة. المصدر: صحيفة العرب
عربية:Draw فشل ائتلاف "إدارة الدولة"، الذي تشكّل أخيراً في العراق دون الإعلان عنه رسمياً حتى الآن، ويضم عدة قوى سياسية عن العرب الشيعة والسنة والأكراد، وقوى أخرى بهدف الوصول إلى تشكيل حكومة جديدة، في التوصل إلى تفاهمات بشأن آلية اختيار رئيس جديد للبلاد. وليلة أمس السبت، عقدت زعامات سياسية ضمن الائتلاف الذي أطلق عليه "إدارة الدولة" اجتماعاً في بغداد، لبحث ملف تشكيل الحكومة والعقبات التي تعترضها. ووفقاً لبيان مشترك صدر عن القوى المجتمعة في ساعة متأخرة، ونشرته وسائل إعلام محلية عراقية، فإنّ "الهيئة القيادية للائتلاف اجتمعت في مكتب زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، وناقش الاجتماع تطورات الساحة السياسية العراقية واستمرار عمل مجلس النواب وتشكيل الحكومة"، مبيّناً أنّ "الائتلاف جدّد استعداده لفتح حوار جدي مع التيار الصدري للتفاهم حول إدارة المرحلة المقبلة". ودعا الائتلاف قيادة الحزبين الكرديين (الحزب الديمقراطي الكردستاني، الاتحاد الوطني الكردستاني) إلى "حسم مرشح رئاسة الجمهورية أو آلية الاختيار ووضع جدول زمني لحسمها". من جهته، أكد مصدر سياسي مطلع أنّ "الاجتماع فشل في التوافق على آلية اختيار رئيس الجمهورية، الذي جرى العرف السياسي المعمول به في البلاد، أن يكون من نصيب القوى الكردية". وبيّن المصدر مشترطاً عدم ذكر اسمه، أنّ "الإطار التنسيقي" الذي يضم قوى مدعومة من إيران "يضغط باتجاه الذهاب بمرشحين اثنين من قبل الأكراد، ما تسبب بانقسام بين القوى المتحالفة"، مبيّناً أنّ "الحزب الديمقراطي الكردستاني رفض بشكل قاطع هذه الآلية". وأضاف أنّ "الآلية تسببت بعدم ثقة بين الأطراف، ما قد يعطل حسم الملف". وكان "الحزب الديمقراطي الكردستاني" قد أعلن، أمس السبت، رفضه آلية الذهاب بمرشحين لرئاسة الجمهورية في العراق. وقال وزير داخلية الإقليم، مرشح الحزب للمنصب، ريبر أحمد، خلال استضافته في مؤتمر بأربيل "نحن لا نقبل أن نذهب بمرشحين اثنين لمنصب رئيس الجمهورية إلى بغداد، فإما أن تكون آلية اختيار المرشح عن طريق الأكثرية الانتخابية، أو يتم اختياره من قبل شعب كردستان عبر ممثليه في برلمان كردستان". وشدد على أنه "خارج إطار هذين الخيارين، فإنه سيتم فرض إرادة أناس آخرين، وأن المرشح الذي سيتولى المنصب سيأتي بأصوات أُناس آخرين وليس بأصوات شعب كردستان (في إشارة إلى أصوات الإطار التنسيقي الداعم للاتحاد الوطني الكردستاني)"، مضيفاً أنّ "ما حصل في عام 2018 من اختيار رئيس للجمهورية، فإنّ الأخير لم يكن يمثل شعب كردستان (في إشارة إلى الرئيس الحالي برهم صالح) وأصبح رئيساً بأصوات أناس آخرين". وأكد قائلاً: "لا نريد أن تتكرر هذا التجربة مرة أخرى أبداً، بل يجب أن يكون القرار بيد شعب كردستان، وأن يقوموا بحسم مرشحهم لهذا المنصب". من جهته، أكد الباحث بالشأن السياسي العراقي باسل حسين، في تغريدة له، أنّ "الحزب الديمقراطي لا يريد الذهاب إلى بغداد بمرشحين اثنين؛ لأنه يعتقد أن لا فرصة لديه أمام مرشح حزب الاتحاد المدعوم من الإطار التنسيقي الذي يمتلك الأغلبية في البرلمان، بينما الاتحاد لا يمانع بالذهاب بمرشحين اثنين لأنه يعرف أنّ النتيجة ستكون لصالح مرشحه.. تلك الحكاية والرواية". وتتلخص محاور الأزمة السياسية في العراق والتي تنهي، غداً الاثنين، عامها الأول منذ إجراء الانتخابات في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، في إصرار قوى "الإطار التنسيقي"، الذي يضم القوى السياسية القريبة من طهران، على انتخاب رئيس جمهورية ورئيس حكومة كاملة الصلاحيات بدلاً من حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي، ثم الذهاب نحو تعديل قانون الانتخابات الحالي، الذي تراه قوى "الإطار التنسيقي"، سبباً في تراجع مقاعدها البرلمانية بالانتخابات الأخيرة، كما تصرّ على تغيير مفوضية الانتخابات، قبل الذهاب إلى حلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. في المقابل، يرفض "التيار الصدري" ذلك، ويصرّ على حلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة خلال 9 أشهر، كما يطرح تعديل الفقرة 76 من الدستور المتعلقة بالكتلة الكبرى التي يحق لها تشكيل الحكومة، مع رفعه مطلباً آخر وهو تعديل قانون المحكمة الاتحادية لتكون أكثر استقلالية عن الأحزاب السياسية التي تولت فعلياً منذ عام 2005 اختيار أعضاء هذه المحكمة وعددهم 11 عضواً بطريقة المحاصصة الطائفية والحزبية. وإلى جانب ذلك، يرفض "التيار الصدري" أيضاً تعديل قانون الانتخابات ويصرّ على بقائه، وهو القانون الذي اعتمد نظام الدوائر المتعددة والفوز للنائب الأعلى أصواتاً، على خلاف القانون السابق المعروف بقانون (سانت ليغو) الذي منح أغلبية عددية للقوى السياسية الكبيرة على حساب القوى السياسية الناشئة والصغيرة، بسبب بند القاسم العددي في توزيع أصوات الدوائر الانتخابية، كما يرفع الفيتو أمام أي حكومة تتشكل سواء كانت مؤقتة أو دائمة، من خلال مشاركة كتلتي "دولة القانون"، بزعامة نوري المالكي و"صادقون"، بزعامة قيس الخزعلي، وألمح إلى قبوله إسناد ذلك للمستقلين كحل وسط، على لسان أعضاء فيه خلال تصريحات سابقة لهم. المصدر: العربي الجديد

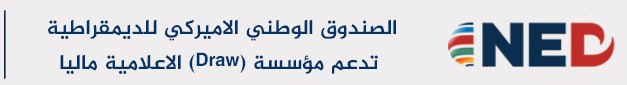
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)