عربية : Draw أجبر المشهد السياسي الراهن في العراق معظم القوى والأطراف العراقية على إعادة النظر في رهاناتهم وافتراضاتهم. كان هناك العديد من السيناريوهات التي وضعت ليَمُر بها البلاد، لكن التيار الصدري جاء وقلب كل شيء رأساً على عقب بالطبع من المبكر الحديث عن نتائج التحول الدراماتيكي الذي شهده المشهد السياسي، ومازال مبكراً أن يحكم المرء على السيناريوهات المستقبلية ، لاسيما أن الموقف الصادر عن التيار الصدري ليس إنفعالاً سياسياً، ولا من باب الوطنية أو حباً بالمواطن، فضلاً عن أنه لايعني أيضاً إنعدام الخبرة أو التجربة كما يتهم بها جزافاً هذا التيار، ما يحدث هو أكبر مما يمكن توقعه، صحيح أنه غالبا ما تُبث خيبات أمل سياسية ، أو تشاؤمات كبيرة حول مستقبل البلاد ، ويُؤوَّل حاله بتقديرات وتوقعات غير حسنة، إلا إن هذه المرة بالذات لا تُقاس الظروف القائمة في البلد بهذه المقاربات السايكولوجية. بأوضح معنى للكلمة ، ما سيأتي هو قريب مما يمكن تسميته نظريًا: بمحاولة خلق الفوضى الخلاقة Creative Chaos ، التي تعني، باختصار، أنَّه عندما يصل المجتمع إلى أقصى درجات الفوضى المتمثلة في العنف الهائل وإراقة الدماء، وإشاعة أكبر قدر ممكن من الخوف لدى الجماهير، فإنَّه يُصبح من الممكن بناؤه من جديد بهوية جديدة تخدم مصالح الجميع. بناءاً على العديد من المؤشرات، بات العراق اليوم موضوعاً فعلاً على وعاء يغلي ويُحّضَر لأجل تحدث فيه هذه الفوضى الخلاقة، فالصدريين حينما يرفضون القبول بالمسؤوليات السياسية لا في الحكومة ولا حتى في مجلس النواب العراقي ويقدمون أنفسهم - وبمئة ألف عنصر مسلح!- كجزء من المعارضة الشعبية، إنما يريدون أن يصبحوا مهندسي غليان الظروف تلك، وعراب إثارة الفوضى الخلاقة، وفي النهاية المراهنة على أن يتحكمون هم وحدهم لا غيرهم بزمام أمور البلاد والعباد.هذه المقاربة لمستقبل العراق ليست بلغة التنجيم والعراف إزاء نوايا التيار الصدري، إنها، بسطر واحد، قراءة موضوعية لخيار التيار الممكن حالياً لمرحلة ما بعد إنسحابه من العملية السياسية والذي بات بمثابة السبيل الوحيد لإعادة الفاعلية لهذا التيار، فالصدريين مثلما كانوا يعرفون تماماً بأنهم لا يستطيعون تشكيل الحكومة، ولا أن يكونوا معارضة مسموعة في مجلس النواب، يعرفون أيضاً بأنهم لن يخرجوا من هذه المعادلة الصعبة بأمان ومن دون تضحية، وأنما سيُستَهدفون دون أدنى شك، خصوصاً إذا ما حسموا أمرهم كمعارضة شعبية ولعبوا على وتر الغضب الشعبي وإستثماره سياسياً، بل أسوأ من ذلك ربما ستُعتَقَل قياداتهم ونشطائهم ويُمنع عليهم ممارسة النشاط السياسي. ولِمَ لا ؟ فإذا كان الشبان المتظاهرين المدنيين قد ألتخطت أجسادهم الطاهرة بالدماء في أزمان حكومات العبادي وعبدالمهدي وحتى الكاظمي، فما المانع أن يُستهدف أيضاً كل أعضاء وناشطي هذا التيار بمسوغات أمنية؟، وعليه يتضح لنا هنا وبجملة، أن الخيار المذكور للتيار هو فعلاً بات بمثابة خيار مصيري، بل ربما متوقف عليه في النهاية حدوث مآلان لا ثالث لهما: إما الوصول الى نهاية مميتة، أو النهوض مجدداً وسحق المنافسين.
عربية :Draw فعلاً...تستحقون هذه الرواتب الضئيلة وهذه الدنانير البائسة لأنكم سُرّاق أيُها المتقاعدون...إنكم كذلك فقد سرقتم سنوات من أعماركم وضاعتْ أحلى أيامكم في خدمة وطن وتربة، تعلمون حق اليقين أنه وطن لايعيش فيه سوى السُرّاق ولايحيا على أرضه إلا الفاسدين واللصوص فماذا بقي لكم في الوطن؟ أنتم اللصوص والفاسدين أيُها المتقاعدون عندما ذبُلتْ زهرة شبابكم في سنواتٍ عِجاف وأنتم تنشدون بناء الوطن وتسعَون لخدمته لتنتهي رحلتكم براتب تقاعدي لايكفي مناديل ورقية لإبن أو حفيد المسؤول الذي تتظاهرون أمام قصره في المنطقة الخضراء.ماذا كُنتم تعتقدون أن تُحيطكم الرعاية الأبوية من لَدُن الحكومة كما إحتضنتْ رئيس جمهورية العراق (المتقاعد) غازي عجيل الياور براتب تقاعدي لايقل عن (60) مليون دينار شهرياً (مايقارب 40 ألف دولار) عن خدمة جهادية لم تستغرق سوى بضعة أشهر قضاها بين قصور المنطقة الخضراء لخدمة العراق؟.هل كنتم تظنون أن الحكومة ستنظر لكم بنفس العين التي نظرتْ إلى هذا الرئيس المتقاعد؟ حقاً أنتم لستم بكامل وعيكم. هكذا يتم تكريم من أفنى حياته في خدمة العراق، وبعد كل ذلك تريدون الإنصاف من شرذمة لاتعرف معنى العدالة والحقوق، وتبحثون عن حقوقكم عند من سرقكم وأضاع حياتكم؟. كم أنتم ساذجون وطيبون..وإسمحوا لي أن أقول أنكم مغفلون، فهولاء لن ينحنوا أمامكم ولن يعترفوا لكم بحقوق لما فيها خيركم، ببساطة أتعلمون لماذا؟ لأنهم أولئك اللصوص والسُرّاق وعناوين الفساد الذين سرقوا منكم ماتتظاهرون من اجل المطالبة به.حقاً أيُها المتقاعدون لاتُدركون حجم اللعبة والخدعة التي تعيشون فيها، لأنكم لو كنتم عكس ذلك لأدركتم أن البلد الذي يُقتل فيه الرأي الحر والنزيه والمثقف لن يعطي حقوقاً للمتقاعد، حياتكم وأحوالكم ستظل بائسة مادام صوتكم معلقاً بين السماء والأرض، لأنكم رقم بسيط لايؤثر في المعادلة السياسية أو لأنكم صوت غير مسموع عند من صُمّتْ آذانه عن سماعكم أو لأنكم فئة لايُستفاد منكم إلا في وقت وأيام الإنتخابات عندما تكون أصواتكم مهمة بالنسبة لهم وليتهم يشعرون بالإمتنان لذلك؟، إنكم ساذجون عندما إعتقدتم إن كفاحكم وعملكم الدؤوب وأيامكم التي ضاعت في خدمة هذا البلد ستشفع لكم بنهايات مفرحة وخواتيم سعيدة، لكنكم كنتم مخطئين فالعراق لايعيش فيه ولاينعم به إلا اللصوص والسُرّاق والقتلة، أما أنتم يافقراء الله على الأرض فمن المؤكد أنكم كُنتم في المكان والزمان الخطأ، أقولها لكم أيُها المتقاعدون كما قالوها لإخوة يوسف (أَيَّتُهَا العِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ) وهم يعلمون أنهم بَراءٌ من السرقة، فلله دَرّكم لأنكم مساكين تعيشون في بلد يُسمى العراق.
تقرير: عربية Draw للمرة السادسة يعلن فيها مقتدى الصدر إنسحابه من العملية السياسية، آخرها كان قبل الانتخابات التشريعية الأخيرة بثلاثة أشهر، الإنسحاب الأخير، دفعت بأطراف الإطار التنسيقي الذين كانوا من أكبر الخاسرين بالإنتخابات في (10 تشرين الاول) الماضي الى الانتعاش، كيف تم تقسيم " كعكة "الصدر؟ بعد أنسحاب الكتلة الصدرية، كيف ستكون خارطة التوزيعات تحت قبة البرلمان؟ هل سيتمكن الإطار من تشيكل الحكومة المقبلة بدون الصدر؟ هل يستطيع الإطار من تقريب وجهات النظر بين " اليكيتي والبارتي"؟ أم سيعطي هذه المهمة الى " إيران" ؟، تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي. تم توزيع " تركة" الصدر أدى النواب الجدد البدلاء لشغل مقاعد الكتلة الصدرية المستقيلة من البرلمان اليمين الدستورية خلال جلسة استثنائية لمجلس النواب العراقي عقدت ظهر اليوم الخميس ( 23 حزيران) .64 نائبا من بدلاء الكتلة الصدرية أدوا اليمين الدستورية وبذلك اسدل الستارعن أي إحتمال لعودة الصدر، 9 من المرشحين البدلاء تغيبوا عن الجلسة التي حضرها 202 من نواب البرلمان (من أصل 329)، أستحوذ تحالف الإطار التنسيقي الذي يتألف من أحزاب شيعية موالية لإيران على غالبية مقاعد نواب الكتلة الصدرية الذين استقالوا جماعيا من مجلس النواب، ما يجعله القوة الأولى في المجلس ويتيح له تشكيل الحكومة المقبلة، من المقاعد الـ( 9) التي لم تشغل( 5) منها وهي من حصة ( حركة حقوق) الذين رفضوا شغل مقاعد الصدريين، تشير المصادر بأن الحركة التي تعتبر الذراع السياسي لكتائب ( حزب الله) ويتزعمها( حسين مؤنس)، طالبوا بمقعد ( النائب الاول رئيس مجلس النواب) الذي كان يشغله حاكم الزاملي، الا أن أطراف الإطار التنسيقي رفضوا إعطاء المقعد لهم خوفا من يكون ذلك بمثابة استفزار للصدر والشارع العراقي، لإنهم يعتبرون كتائب (حزب الله) المسؤول عن الهجمات التي تحدث بين الفينة و الاخرى، لذلك ليس من المعقول إعطاء هكذا منصب مهم لهم، وهذا ما دعى( حسين مؤنس) الى رفض شغل مقاعد الصدريين الشاغرة. الصدر ينعش مكانة خصومه داخل البرلمان بالمقاعد مع انسحاب كتلة التيار الصدري وعددهم 73 نائباً، من مجلس النواب العراقي، تغيرت بعض الحسابات الانتخابية، وقامت الاطراف السياسية الاخرى بتوزيع " كعكة الصدر" خصوصاً أن القانون ينص على أنه عند استقالة نائب، يتولّى منصب النائب المستقيل صاحب ثاني أكبر عدد من الأصوات في دائرته. بعد انسحاب نواب كتلة الصدر الـ73 منتصف حزيران الجاري، ذهب 3 مقاعد من كتلة الصدر إلى مرشحين سنة. و12 من المقاعد الشاغرة ذهبت إلى مرشحين من تحالف "الفتح"، الذي يمثل "الحشد الشعبي"، ويضم فصائل شيعية متحالفة مع إيران. ومع هذه الزيادة، ارتفع عدد نواب كتلة التحالف الذي يقوده هادي العامري، إلى 29 نائبا بعد ان كان ( 17) مقعداً، في المقابل، حاز المستقلون الشيعة على 11 مقعداً من مجموع المقاعد الشاغرة، ليرتفع عدد النواب إلى 34 نائباً.وجاءت حركة "امتداد"، ويرأسها علاء الركابي، في المرتبة الثالثة في قائمة الرابحين من استقالة الكتلة الصدرية، بنيلها 7 مقاعد إضافية رفعت عدد نوابها في البرلمان إلى 16 نائباً. بدوره حاز تحالف "قوى الدولة الوطنية" الذي يضم تحالف "النصر" برئاسة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي إضافة إلى "تيار الحكمة" برئاسة عمار الحكيم، على 8 مقاعد إضافية، ليرتفع عدد أعضاء الكتلة في البرلمان إلى 12 نائباً. من جانبه حصل تحالف "دولة القانون" الذي يقوده رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، على 5 مقاعد من مجموع المقاعد الشاغرة، ليرتفع بذلك مجموع أعضاء كتلته في البرلمان إلى 38 نائباً. وتوزعت باقي المقاعد على كلّ من تحالف "العقد الوطني" بزعامة رئيس هيئة "الحشد الشعبي" فالح الفياض (4 مقاعد إضافية ليصبح المجموع 5)، وتحالف "تصميم" وهو تكتل سياسي في محافظة البصرة جنوب العراق برئاسة عامر الفايز، (3 مقاعد إضافية ليصبح المجموع 7) وتحالف "النهج الوطني وهو حزب "الفضيلة" سابقاً وتابع لرجل الدين محمد اليعقوبي (3 مقاعد ليصبح المجموع 4.وذهب مقعدان من مجموع المقاعد الشاغرة إلى كل من حركة "الوفاء العراقية" بزعامة محافظ النجف الأسبق عدنان الزرفي، وحزب "قادمون"، وهما حزبان لم يفوزا بأي مقعد في البرلمان خلال الانتخابات الأخيرة. ونال كذلك "تيار الفراتين" بزعامة وزير العمل الأسبق محمد شياع السوداني، مقعدين، ما رفع رصيد نوابه إلى 3 مقاعد في البرلمان. ونال كل من "إشراقة كانون" وهي حركة سياسية جديدة، و"تجمع أهالي واسط المستقلون" وهو تجمع سياسي جديد في محافظة واسط جنوبي العراق، و"الحزب المدني" الذي يضم ثلاثة أحزاب مدنية أبرزها الحزب الشيوعي العراقي، و"حركة العراق الوطنية" (جديدة) و"حركة النور-الانتفاضة والتغيير" و"تجمع الفاو زاخو" وهو تحالف سياسي يتزعمه وزير النقل الأسبق عامر عبد الجبار وينشط في محافظة البصرة جنوب العراق، و"المحافظون" (جديد)، على مقعد إضافي لكل حزب. خارطة مجلس النواب بعد الصدريين. بعد استقالة نواب الكتلة الصدرية أرتفع عدد مقاعد الإطار التنسيقي إلى نحو 120 مقعدا ما يجعله القوة الأكبر داخل مجلس النواب، ويتيح له تعيين رئيس للوزراء وتشكيل الحكومة بالتحالف مع كتل برلمانية أخرى. لم يبق لتحالف "السيادة" والحزب الديمقراطي الكوردستاني غير مسارين؛ إما الذهاب نحو المشاركة بحكومة يشكلها "الإطار التنسيقي" الذي يضم قوى موالية لطهران، أو يتخذان دور المعارضة البرلمانية كموقف سياسي متضامن مع الصدر .أظهر الديمقراطي الكوردستاني موقفه بشكل واضح عندما شارك في جلسة حلف اليمين ويمكن أعتبار هذا الموقف اشارة للاتفاق مع "الإطار التنسيقي" بحكومة جديدة، ولكن بدون اتفاق معلن، إذ تحمّل حكومة وأحزاب الإقليم الاطار مسؤولية الكثير من الملفات التي سيكون على حلفاء إيران حسمها قبل توقع ذهاب الكورد معهم بحكومة واحدة.وأبرز هذه الملفات (قصف أربيل المتكرر وملف تصدير النفط والغاز وحصة كوردستان من الموازنة)."الإطار التنسيقي"، ماضي مع القوى السياسية الحليفة، تشكيل الحكومة المقبلة، من خلال بدء حوارات مع كل الأطراف الأخرى، وعلى رأسها تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكوردستاني، واللذين لم تعقد لقاءات معهما حتى الآن، الا أن الاطار سيحاول قبل بدء أي حوارات مع الحزبين الكورديين تقريب وجهات النظر بينهم وحل الخلافات التي اشتدت بينهما حول منصب رئاسة الجمهورية. سيحترم الاطار موقف " الاتحاد الوطني الكوردستاني" الذي كان داعما لهم طيلة ( 8) اشهر الماضية والذي شكل معهم وبمقاعده( 18) الثلث المعطل. ألا ان الاطار في نفس الوقت يعلم جيدا بأن مشاركة " الديمقراطي الكوردستاني" في الحكومة المقبلة مهمة، وربما سيكون تشكيل الحكومة المقبلة بدون مشاركة " الديمقراطي " امرا مستحيلا نوعا ما، تنتظر قوى الإطار التنسيقي الآن حسم المواقف النهائية لتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكوردستاني بشأن المرحلة المقبلة، ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تغييراً كبيراً في تشكيل التحالفات السياسية، خصوصاً بعد إنهاء التيار الصدري تحالفه مع تحالف إنقاذ وطن، وهذا ما يدفع طرفي التحالف الآخرين إلى البحث عن شركاء جدد لهما". يسعى الديمقراطي الكوردستاني خلال مباحثاته مع اطراف الاطار التنسيقي معالجة قرار المحكمة الاتحادية الصادر ضد القطاع النفطي في إقليم كوردستان، وهذا يجعل أمر تحالف المالكي والعامري مع الديمقراطي صعب للغاية، هل سيخضع الاثنان الى مطالب " البارتي" أم لا ؟، أما العملية مع السنة لن تكون بتلك الصعوبة و خاصة أن السنة قد أخذوا مسبقا استحقاقهم وهو منصب "رئاسة مجلس النواب"، الا أن على الاطار الاخذ بنظر الاعتبار حصة السنة في المقاعد الوزارية في الحكومة و خاصة حصة " تحالف العزم" الذي كان في الفترة الماضية داعما لإطراف الاطار التنسيقي.حتى هذه اللحظة، يصرعمار الحكيم على عدم المشاركة في الحكومة المقبلة، لذلك من المتوقع أن يقوم الاطار بإعطاء منصب " نائب رئيس مجلس النواب" له وذلك لاقناعه على المشاركة في الكابينة الوزارية الجديدة، انسحاب الصدر يمكن أن يكون له فائدة كبيرة لاطراف الاطار التنسيقي، حيث تمكنوا من تعويض الخسائر التي لحقت بهم أثناء الانتخابات التشريعية الماضية، الا أن رغم ذلك من الممكن أن يتعرضوا الى خسائر أشد وأكبر فيما بعد، وخاصة اثناء المباحثات حول ترشيح شخصية لرئاسة الحكومة المقبلة وتوزيع المقاعد الوزارية، لان هذا التحالف شكل في الاساس وفق استراتيجية مواجهة الصدر ولم يشكل على أساس تشكيل الحكومة، اضافة الى ذلك يشكل بقاء الصدر خارج البرلمان مخاطركبيرة على أي حكومة مشكلة من قبل الاطار التنسيقي، ويمكن ايضا ان يلحق الديمقراطي الكوردستاني وتحالف السيادة، بحليفهم السابق( الصدر) في حال اذا ضربت مصالحهم و لم يحصلوا على مايريدون، أما نقاط القوة الموجودة لدى الاطار، هو انه مدعوم من قبل الإيرانيين الذين من المتوقع أن يضطلعوا بدورمحوري و كبير في تفعيل الحكومة العراقية المقبلة وخاصة معالجة الخلافات بين " البارتي و اليكيتي" حول منصب رئاسة الجمهورية.
عربية Draw: المرصد العراقي لحقوق الإنسان قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان إن حالات التحرش الجنسي واللفظي آخذة في التزايد في كثير من المنشآت الحكومية والخاصة بما في ذلك المنازل في العراق وفق شهادات لضحايا وشهود عيان. واستمع المرصد للشهادات الشخصية وأجرى مقابلات عديدة، تحدثت خلالها نساء وكذلك رجال وعناصر أمن وصحفيون ومدرسون، تفاصيل حوادث تحرش وقعت في مستشفيات وجامعات ومدارس ودوائر حكومية وأخرى خاصّة وكذلك في وسائل إعلام. وطلب المتحدثون جميعهم عدم ذكر أسماءهم أو كشف معلومات تقود إلى التعرف عليهم أو على "مرتكبي" حالات التحرش الوارد ذكرها في هذا التقرير خشية "الوصمة المجتمعية" والملاحقات العشائرية. "العلاج مقابل الجنس" قالت إمرأة للمرصد العراقي لحقوق الإنسان وطلبت إخفاء هويتها، إنها كانت ترافق والدتها المصابة بمرض السرطان خلال علاجها في مستشفى (الأمل) في بغداد عندما "ساومها" جنسياً أحد الموظفين هناك مقابل صرف العلاج لوالدتها. وأضافت: "كان علاج والدتي يتوقف على توقيع منه. فكرت بكيفية حل المشكلة ولم أبلغ أبي لئلا تزيد متاعبه، وخشيت تضرر والدتي في حال تقدمت بشكوى رسمية فالمسؤولون لا يقفون مع مواطن لذلك سكّتُ". بعد يوم واحد على الحادثة، توفيّت والدتها. وقالت أيضاً: "كذلك تعرضت لحالتي تحرش أيضاً، الأولى من قبل أستاذ جامعي قلّل من درجتي العلمية في مادته لأنني رفضت تحرشه بي رغم أنني في المرتبة الثانية على دفعتي الدراسية في مرحلتي الباكالوريوس والماجستير". ومع ذلك، كان هذا "العقاب" أقل حدة مما وقع على زميلة لها "تحرّش بها أستاذ أيضاً ولم تستجب له فرسّبها في مادته". أما حالة التحرش الثانية التي تعرضت لها المتحدثة، فكانت بعد تقدمها بطلب للعمل مراسلة في قناة فضائية: "تحرش بي رئيس المراسلين فاضطررت للانسحاب رغم كفاءتي". وروى صحفي تحدث للمرصد العراقي لحقوق الإنسان وطلب عدم ذكر اسمه أو اسم المؤسسة التي يعمل لصالحها، حالة مشابهة. وقال في تسجيل صوتي أرسله إلى المرصد العراقي لحقوق الإنسان، إن "مديراً في مؤسستنا تحرش بإحدى الزميلات داخل المقر الذي نعمل فيه فبادرت هي إلى ضربه ثم طُردت من العمل بعدما اتهمها كذِباً بسرقة أموال من حقائب زميلاتها". "أستاذ جامعي يلمس صدر طالبته عنوة" في جامعة بغداد، تعرضت الطالبة (ز.خ) لتحرش جنسي داخل غرفة أحد الأساتذة، روى قصتها زميلاً لها: "دخلت لغرفته من أجل سؤاله عن شأن دراسي فلمس صدرها بيده ما دعاها إلى التقدم بشكوى لرئاسة الجامعة التي أوقفته عن التدريس عاماً كاملاً". وأضاف زميلها الذي يدرس للحصول على درجة الماجستير، وطلب عدم ذكر اسمه تجنباً للمضايقات الإدارية، أن "أستاذاً في الكلية ذاتها اتصل بزميلة أخرى في وقت متأخر من الليل وطلب منها أن تريه صدرها عارياً وأماكن حساسة أخرى من جسدها وتحجج لاحقاً بأنه يتعاطى دواءً يؤثر على عقله". هذه الحالة "لم تصل إلى عمادة الكلية أو رئاسة الجامعة، لأنها أولاً شيء غير مستغرب وشبه طبيعي ويعرفه الجميع ولا يجلب للطالبات سوى المتاعب والسمعة السيئة رغم كونهن ضحايا، لذلك فإن الغالبية منهن يفضلن السكوت ونادراً ما تتجرأ إحداهن على تقديم شكوى رسمية وهن لا يتحدثن أصلاً إلّا لمن يثقن به من زملائهن ويطلبن المساعدة والنصيحة أحياناً"، وفقاً لشهادة طالب الدراسات العليا الذي شهد إحدى عمليات التحرش. وتفيد الشهادات التي استمع لها المرصد العراقي لحقوق الإنسان، وكذلك المقابلات التي أجراها، بأن المدارس تشهد حالات تحرش أيضاً، وتشمل الطالبات والمعلمات والمدرسات على حدٍ سواء. في بغداد، قال مدرس للمرصد العراقي لحقوق الإنسان إن "مدير المدرسة التي أعمل فيها طلب من زميلة لنا إقامة علاقة جنسية لكنها رفضت فضايقها كثيراً حتى انتقلت إلى مدرسة أخرى، وهو معروف بين الطلبة بلقب (الأستاذ جنسي) لأنه كان يطلب منهم إرسال مقاطع إباحية لهاتفه". كما استمع المرصد لتسجيل صوتي يوثق طلب مدرس في محافظة الديوانية من إحدى الطالبات إقامة علاقة جنسية أيضاً، وقد تشكلّت لجنة تحقيقية بشأن الحادثة التي أوصلها صحفي مع الدليل، إلى مكتب وزير التربية. وأفاد طالب في مدرسة مسائية في بغداد بأن زملاء له، وهم أكبر سناً من طلبة المدارس الصباحية "لا يتوقفون عن التحرش بمحاضِرة مجانية تدرّسنا دون أي محاسبة أو اهتمام حتى من قبل إدارة المدرسة". قالت بلسم مصطفى، وهي باحثة في جامعة واروك في إنجلترا وناشطة نسوية خلال مقابلة مع المرصد العراقي لحقوق الإنسان: "تشير دراسات علم النفس الاجتماعي إلى وجود وصمة إجتماعية شديدة تحيط بالتحرش بمختلف أشكاله عالمياً مما يدفع الفتيات والنساء إلى الصمت وعدم البوح عن تجاربهن أو الإبلاغ عن أي حالة تحرش يتعرضن لها". وأضافت: "تلك الوصمة مرتبطة بنظرة دونية للمرأة تغذيها ثقافة ذكورية متسيدة تلقي باللوم على الضحية مما يضعف من ثقتها بنفسها ويفقدها الإحساس بالأمان حيث تخشى أن تواجه بالنبذ أو التقريع والعقاب. كل ذلك يستدعي تشريع قوانين قوية مصحوبة بحملات توعوية وتثقيفية لتغيير المفاهيم الراسخة وتعزيز من روح التضامن مع المرأة العراقية". "عناصر في الشرطة يساومون" في الإطار ذاته، يروي عريف الشرطة (ع.م) حادثة مساومة متسوّلة عربية ضبطتها دوريته في إحدى شوارع بغداد دون أوراق رسمية ولا تصريح إقامة. "قبل أن ينادي آمر الدورية قيادتنا العليا عبر جهاز اللاسلكي ويبلغها بالحالة، بدأ الفزع على وجه المتسوّلة فطلب منها ممارسة الجنس مقابل تركها تذهب، وهو ما حصل فعلاً" وفقاً لشهادة العريف. "لا أمان حتى في المنزل" في المطاعم والأسواق والحدائق العامة والشوارع وسيارات الأجرة والنقل العام، وحتى في بعض الأماكن ذات الطابع الديني، قال أشخاص من كلا الجنسين وبأعمار مختلفة للمرصد العراقي لحقوق الإنسان، إنهم "تعرضوا لحالات تحرش جنسي ولفظي من قبل عمّال ومارّة وسائقين بينهم كبار في السن، رغم أن بعض الضحايا لم يكونوا بمفردهم لحظة التحرش وكانت ملابسهم فضفاضة". "آباء وإخوان متحرشون" ولا يعني وجود العديد من الفتيات والشابات والسيدات المتزوجات في منازلهن أنهن بمأمن من التحرش إذ يتعرضن له من قبل آبائهن أو إخوانهن أو أقاربهن ويصل الأمر حد الاغتصاب وممارسة الجنس معهن تحت التهديد وبالقوّة. وتُجمع الشهادات والإفادات التي استمع إليها المرصد العراقي لحقوق الإنسان، على تفضيل غالبية ضحايا التحرش الصمت تجنباً لـ"المتاعب والسمعة السيئة والوصمة المجتمعية، وكذلك عدم الثقة بالمحاكم ومراكز الشرطة وصعوبة إثبات الحالات أمامها وما يتضمنه هذا الأمر من إحراج أخلاقي يمتد ليشمل عائلة الضحية في مجتمع محافظ تغلب عليه المفاهيم الذكورية والأعراف العشائرية الصارمة في قضايا الشرف". "العشائر تنهي القضايا بدل المحاكم" تنص المادة 396 من قانون العقوبات العراقي بالسجن 7 سنوات لمن يدان بالتحرش بالقوة أو التهديد أو الحيلة، وتشدد العقوبة إلى 10 سنوات في حال كان المجني عليها/ عليه دون سن الـ18، بينما تنص المادة 402 من القانون ذاته على معاقبة "المتحرش بالطلب" بالسجن 3 أشهر أو الغرامة على أن تضاعف العقوبة إلى السجن 6 شهر في حال تكرار الفعل، وهو ما يراه خبراء غير كافٍ للردع المطلوب. ويذكر الموقع الإلكتروني لمجلس القضاء الأعلى، في تقرير أورده في 15 أيلول 2019، عن قاضي محكمة تحقيق الكرخ في بغداد، سيماء نعيم هويم قولها، إن "المحاكم تردها قضايا وشكاوى عديدة عن حالات التحرش لكن غالبا هذه الدعاوى تنتهي بالصلح والتراضي وأحد الأسباب ترجع للصلح العشائري وكون المجتمع العراقي مجتمعاً محافظاً". "الحاجة ماسّة لقانون جديد" يرى الخبير القانون علي التميمي، في حديث مع المرصد العراقي لحقوق الإنسان، أن "الحاجة ماسّة لتشريع قانون جديد، يجمع المواد القانونية المبعثرة، لردع التحرش الذي بات ظاهرة شائعة في العراق بما ينطوي عليه من آثار نفسية واجتماعية. التطور التكنولوجي وانتشار مواقع التواصل الاجتماعي تفاقم حالات التحرش". يحث المرصد العراقي لحقوق الإنسان، السلطات العليا في العراق، بتشديد المتابعة وتفعيل الإجراءات القانونية بحق المتحرشين وتخصيص أقسام مدرّبة على التعامل مع قضايا التحرش تضمن عدم إفلات الجناة من العقاب أولاً، وحفظ سرية هوية الضحية التي تبلغ عمّا تتعرض له ثانياً. كما يدعو المرصد البرلمان ومجلس القضاء الأعلى إلى التعاون لإيجاد تشريعات وقوانين أكثر صرامة لردع المتحرشين وعدم السماح بإفلاتهم من العقاب لمجرد حصول "الصلح العشائري" خاصة إذا كانوا موظفين حكوميين. وأكد المرصد العراقي لحقوق الإنسان أن هذه القضايا تؤثر بشدة على نفسية الضحايا وتؤثر على مستقبلهم بما في ذلك الدراسة والعمل وصولاً إلى الهجرة والانتحار.
تقرير:عربية Draw أرخى حرالصيف سدوله على أجواء العراق مع قدوم شهر حزيران، متزامنا مع بدأ الإنقطاعات في التيار الكهربائي، الاطراف السياسية المتصارعة تراهن على استثمارغضب الشارع ضد بعضهم البعض، المهلة المقدمة من قبل زعيم التيار الصدري شارف على الإنتهاء، سيعود الصدر الى الساحة السياسية وسيكون له هذه المرة موقف مختلف، الاصوات المطالبة بحل البرلمان اخذت تتعالى شيئا فشيئا.. تفاصيل أوفى في سياق التقريرالتالي. فشل المبادرات رغم مرور(8) أشهر على إجراء الانتخابات البرلمانية، الا أن عملية تشكيل حكومة عراقية مازلت تواجه الكثير من العقبات والانقسامات الحادة بين الكتل السياسية وهي خلافات أحدثت بمجملها مشهدا سياسيا مضطربا، قدم الصدر( 3) مقترحات والإطار التنسيقي قدم مقترح والمستقلون قدموا بدورهم مقترح ،رغم ذلك لم تظهر على الساحة أي بوادر حلحلة للأزمة التي تعتبر الأكثر تعقيداً منذ عام 2006، جميع الخيارات مطروحة في الأزمة الحالية، بما فيها عودة الصدر الى محور مباحثات تشكيل الحكومة أوإجباره على التراجع عن خيار حكومة الأغلبية الوطنية، أو الذهاب لانتخابات جديدة. مهلة الصدر الثالثة تشارف على الانتهاء يواصل الانسداد السياسي في العراق مساره منذ إعلان نتائج الانتخابات في شهر تشرين الأول من العام الماضي، وتضمنت الفترات الماضية إطلاق مبادرات عدة من قبل أطراف العملية السياسية لحلحلة الأزمة السياسية وتفكيك الانسداد السياسي، كانت آخرها مبادرة مكونة من عدة نقاط طرحها الإطار التنسيقي ، تلتها بساعات مبادرة أخرى طرحها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، تهدفان إلى حلحلة الأزمة السياسية وإنهاء الانسداد السياسي في البلد كلا من وجهة نظره. يصر الصدر في جميع مبادراته على تشكيل حكومة إغلبية وطنية، أعطى الصدر في مبادرته الاولى مهلة ( 40) يوم لأطراف الإطار التنسيقي تشكيل الحكومة من دون مشاركة الصدريين، وقام الصدر بتقديم مبادرة ثانية عقب ساعات من طرح الإطار التنسيقي لمبادرة جديدة لمعالجة الانسداد السياسي في البلاد، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، من جهته المستقلين، لتشكيل تحالف جديد خلال 15 يوما. ودعا الصدر النواب المستقلين إلى تشكيل تكتل مستقل منهم لا يقل عن 40 فردا، بعيدا عن الإطار التنسيقي، والالتحاق بالتحالف الأكبر (تحالف إنقاذ وطن)، ليشكلوا حكومة دون اشتراك الصدريين فيها، وهو ما رسخ استمرار الاختلاف مع الإطار التنسيقي (الذي يضم معظم القوى الشيعية البارزة باستثناء الكتلة الصدرية) والسعي لجذب المستقلين صوب كفة أحد الطرفين.وأعلن زعيم التيار الصدري في ( 15) من أيار الماضي التخلي عن مساعي تشكيل الحكومة العراقية لـ30 يوما، والانتقال إلى المعارضة خلال هذه الفترة. وأفاد الصدر، قائلا "فإِن نجحت الأطراف والكتل البرلمانية، بما فيها من تشرفنا بالتحالف معهم بتشكيل حكومة لرفع معاناة الشعب، فبها ونعمت، وإلا فلنا قرار آخر نعلنه في حينها". الكورد داخل الصراع السياسي في العراق بعد فشهلم في ترتيب بيتهم، راهن الشيعة على الكورد في حلحلة الانسداد السياسي، كانوا يتأملون بأن يتفق الديمقراطي والاتحاد الوطني فيما بينهم حول منصب رئاسة الجمهورية، ويكون لهم دور فاعل في رجحان كفة على الاخرى، ويتمكنوا من عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية و من ثم يأخذ الرئيس الجديد على عاتقه تحديد الكتلة الاكبر داخل البرلمان، لترشح رئيس الحكومة، في الآونة الاخير تسربت أنباء من داخل الديمقراطي الكوردستاني تشير الى أن زعيم الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني يريد حل عقدة الانسداد السياسي في العراق من أربيل، وأن البارزاني قام بزيارة سرية الى طهران، وانه سيترك منصب رئاسة الجمهورية للاتحاد الوطني الكوردستاني، الخبر لم يتم نفيه لامن قبل المسؤولين الايرانيين و لا من قبل الديمقراطي الكوردستاني. وفق المعلومات التي حصل عليها (Draw)، قام وفد إيراني مكون من قائدين في الحرس الثوري الايراني وهما كل من ( حسن دانايي فر) السفير الايراني الاسبق في بغداد و( عبدالرضا مسكريان) يوم أمس بزيارة الى أربيل، هناك الى نوع من التقارب في العلاقات بين الجانبين حاليا .الا أن رغم التقارب الاخير بين الحزبين الكورديين من جهة والتقارب بين الديمقراطي وإيران لايزال " البارتي" متمسكا بمنصب رئاسة الجمهورية، يسعى الايرانيون الى وضع حد لعناد الصدر وإعادته الى داخل إطار وبودقة البيت الشيعي من خلال الكورد، أفرزت نتائج الانتخابات التشريعية في العراق التي أُجريت في العاشر من تشرين الأول العام الماضي، وجود قوى سياسية مدنية وأخرى مستقلة، برزت الحاجة إليها أكثر مع الانسداد الحاصل في تسمية رئيس الجمهورية، والمرتبط بتحقيق النصاب الضروري لعقد جلسة التصويت في البرلمان.ويقف المدنيون والمستقلون اليوم في البرلمان العراقي، أمام حالة تجاذبات واسعة فرضتها حالة الانقسام السياسي بين "التيار الصدري" الذي أسّس لاحقاً تحالف "إنقاذ وطن" مع تحالفي "السيادة"، بزعامة خميس الخنجر، و"الحزب الديمقراطي الكوردستاني" بزعامة مسعود البارزاني، رافعين شعار حكومة الأغلبية الوطنية. يقابله بذلك تحالف "الإطار التنسيقي"، الذي يضم قوى وكتلاً سياسية حليفة لإيران، أبرزها "دولة القانون"، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، و"الفتح"، الذي يقدم نفسه ممثلاً سياسياً عن "الحشد الشعبي"، ويتزعمه هادي العامري.وسعت جبهتا الصراع السياسي ، "إنقاذ وطن" وقوى "الإطار التنسيقي"، لاستقطاب أكبر عدد من النواب المستقلين والمدنيين خلال الفترة الماضية من أجل ضمان عقد جلسة البرلمان أو إفشالها، وهو ما ولّد تبايناً في مواقف النواب والكتل المستقلة من هذا الحراك بين من شارك في الجلسة ومن قاطعها. حل البرلمان و إجراء الانتخابات إعادة الانتخابات أو حل البرلمان أو عودة الاحتجاجات للشارع العراقي، سيناريوهات مرتقبة في العراق لحلحلة الانسداد السياسي الذي يعصف بمعادلة الحكم العراقية، إذ تذهب أغلب التوقعات إلى استمرار حالة الانسداد لفترة أخرى، ومن المتوقع أن تضفي الاجواء الصيفية في العراق اجنحتها على المشهد السياسي وتجعلها أكثر سخونة مع بدأ الانقطاعات الكلاسيكية في التيار الكهربائي وتصاعد موجة الحرّ، التي بلغت درجة نصف الغليان، في عدد من المحافظات العراقية، ويتوقع المراقبون للشأن العراقي أن تتسبب انخفاض في ساعات تجهيز التيار الكهربائي للمواطنين، بحالة من الغضب الشعبي تطغى في المحافظات التي تشهد أكبر ارتفاع في درجات الحرارة، ما يدفعهم باتجاه الخروج بتظاهرات شعبية، كالاعوام السابقة، من جانبه وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ، وزراء حكومته بحماية أبراج نقل الكهرباء من هجمات محتملة والتصدي للأعمال التخريبية، وملاحقة الجماعات الإرهابية والتخريبية التي تحاول استهداف أبراج الطاقة بهدف إرباك الوضع وزعزعة الاستقرارمع قرب حلول فصل الصيف، موسم الصيف في العراق فرصة سانحة للاطراف السياسية المتخاصمة في إستغلال الشارع العراقي لتحقيق مأربهم السياسية وخلق الاضطرابات وتحريك الجماهير مستغلين شح التيار الكهربائي. واشار زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أن ،" الشهر السادس اوحزيران من هذا العام سيكون حاسما في العملية السياسية”، بما إننا قد دخلنا فعليا في شهر حزيران، بدأت الاطراف المحسوبة على الاطار التنسيقي بتسجيل دعاوى قضائية في المحكمة الاتحادية تطالب بحل البرلمان بحجة فشل البرلمان بعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بالمدد الدستورية المحددة. ويرى مراقبون للشأن السياسي العراقي "حل البرلمان لا يكون إلا ذاتيا، من خلال تقدم رئيس مجلس الوزراء بطلب الى رئيس الجمهورية لحل البرلمان ويحال الطلب على مجلس النواب للتصويت عليه، ويجب أن "يصوت عليه ثلاثة أخماس عدد أعضاء المجلس أما الطريقة الأخرى هو طلب مقدم من ثلث أعضاء مجلس النواب لحل البرلمان ويعرض على المجلس للتصويت عليه فيما لم ينص الدستور وقانون المحكمة الاتحادية على وجود حل قضائي، ورغم ان هذه الدعوات قد تبدو لأول وهلة سياسية ودعائية اكثر منها واقعية او معبرة عن مواقف سياسية موحدة ورسمية للداعين لها، لكنها في الواقع تكرس التجاذبات السياسية بين الفرقاء حول القضايا الجوهرية وخاصة مسألة مخرجات الانتخابات من استكمال انتخاب رئيس الجمهورية وتحديد هوية الكتلة الاكبروتكليف مرشحها لتشكيل الحكومة، هذه الدعوات المتضاربة قد تدخل البلد ازمة حكم حقيقية تتيح للأطراف الدولية والاقليمية انخراطا اكثر في الساحة العراقية و تخشى الاطراف الشيعية المتخاصمة تصاعد الغضب الشعبي مع تصاعد موجة الحر وأن تتكرر سيناريو تشرين 2019، لذلك يراهن كل طرف على هذا الشهر في إخضاع خصمه، أطراف الإطار التنسيقي تراهن على حرهذا الشهر في انصياع الصدر لمطالبها و العدول عن فكرة تشكيل ( حكومة الاغلبية) ويراهن الصدر بدوره أيضا على خضوع الاطار والعدول عن فكرة (الحكومة التوافقية).
عربية Draw: صلاح حسن بابان - الجزيرة تقف السلطات العراقية عاجزة عن إيجاد مصادر أخرى لميزانية الدولة إلى جانب النفط الذي تغذي مبيعاته أكثر من 90% من الإيرادات، وهذا ما جعل البلاد رهينة تقلبات أسعار الخام العالمية رغم أنها تمتلك الكثير من المصادر المرشحة لتعزيز الميزانية السنوية لو استغلت بشكل صحيح. غياب الحلول الإستراتيجية لتفعيل أو تنشيط القطاعات الأخرى والاعتماد شبه المطلق على النفط، زاد من تفشي البطالة وغياب فرص العمل لأصحاب الشهادات والخبرات مع استمرار ارتفاع معدل النمو السكاني إلى نحو 2.7%، وبلوغ نسبة الفقر نحو 25%، وفقا لوزارة التخطيط. تزاحم عدد من العراقيين لتقديم أوراقهم بهدف الحصول على فرصة عمل أمام أحد المؤسسات (رويترز) ويُشير تقرير للبنك الدولي إلى أن نحو 13 مليون عراقي يكسبون يوميا أقل من دولارين، مع توقعات بأن يصل عدد سُكان العراق إلى 80 مليونا بحدود العام 2050. مليار برميل سنويا ويصدر العراق سنويا أكثر من مليار برميل من النفط الخام، ويحتاج إلى نحو 90 مليار دولار سنويا لتغطية موازنته السنوية التي ترتبط في جزء كبير منها بصادرات النفط الخام. ويحتاج العراق سنويا نحو 90 تريليون دينار (60 مليار دولار) للإنفاق التشغيلي -حسب تقارير سابقة- نصفها لرواتب موظفي الدولة والقطاع العام، بالإضافة إلى نحو 18 تريليون دينار (12 مليار دولار) تذهب إلى رواتب الرعاية الاجتماعية والمتقاعدين، وما يتبقى يكون للنفقات الأخرى. المرسومي يرى ضرورة استغلال العراق لفوائض النفط الحالية لبناء قاعدة إنتاجية متنوعة (الجزيرة نت) صانع القرار السياسي ورغم التحذيرات من انخفاض الطلب على النفط مستقبلا، فإن الخبير النفطي الدكتور نبيل المرسومي يقفُ مُدافعا عن النفط بتأكيده أنه سيكون المصدر الأول للطاقة على الأقل حتى العام 2050، مع إشارته إلى وجود نقص في الاستثمارات بقطاعات النفط وانخفاض بـ 30% في هذا العام مقارنة مع 2019، يقابله شح في المعروض وزيادة في الطلب. هذا المعطيات دفعت المرسومي للمطالبة بضرورة استثمار العراق للعوامل النفطية المُتاحة مع الارتفاع الكبير للأسعار التي كسرت مؤخرا حاجز 100 دولار بسبب العوامل الجيوسياسية، على أن تستغل فوائض النفط لبناء قاعدة إنتاجية متنوعة تحقق مصادر دخل بديلة. ومع ذلك، يرى الخبير النفطي أن العراق يعتمد على النفط بشكل مفرط بحيث يشكل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي وأكثر من 90% من الموازنة، ما يضع البلاد عرضة لاضطرابات السوق، في ظل عدم وجود مصدات اجتماعية ومالية تُخفف من الأزمات، كما أن العراق -وعلى عكس عدد كبير من الدول النفطية- لا يمتلك صندوقا سياديا أو صندوقا للأجيال القادمة لاستثمار عائدات النفط والاستفادة منها. وفي رده على سؤالٍ للجزيرة نت عن إمكانية أن تُنافس قطاعات أخرى مثل الصناعة والزراعة والسياحة النفط في تأمين الواردات التشغيلية والاسثتمارية للبلد، يقول المرسومي إن ذلك يعتمد على صانع القرار السياسي. ويرى أن صانع القرار السياسي في العراق لا يؤمن بالتنمية الاقتصادية المبنية على خطّة عمل واضحة ومحددة. وواحدة من الحالات التي تجعل الخبير النفطي في حالة من الإحباط من العقلية الاقتصادية التي تُدير البلد أن العائدات السنوية لقطاع السياحة فيه تبلغ قرابة 85 مليون دولار، بينما تبلغ واردات القطاع ذاته في دول أخرى مثل مصر أكثر من 13 مليار دولار. سميسم ترى في السياحة القطاع المرشح ليكون رديفا للنفط لإنعاش مالية العراق (مواقع التواصل) من ينافس النفط؟ ومنذ العام 2003، تُعاني قطاعات حيوية مثل الصناعة والزراعة والسياحة إهمالا واضحا مما جعلها في موضع إنتاجي بائس لم يصل إلى المستوى المطلوب، في مقابل زيادة الاستيراد من الدول المجاورة مثل إيران وتركيا والأردن وسوريا والسعودية. وترى الباحثة الاقتصادية سلام سميسم أن السياحة تشكل القطاع المرشح ليكون رديفا للنفط لإنعاش مالية العراق، مشترطة لذلك تفعيل الإيرادات لهذا القطاع وحسن الاستثمار فيه. وما يحتاجه العراق لجعل قطاعه السياحي بالمستوى المطلوب هو توفر البنية التحتية، أبرزها القطاعات الفندقية ووسائل نقل وشبكات التواصل والاتصال وتفعيل الخدمات المصرفية التي تُتيح للسائحين التواصل والإمداد المالي المناسب لهم. وأضافت سميسم أن العراق لو يفرض رسوم رمزية بنحو 40 دولارا على منح الفيزا للوافدين إليه، وتحديدا خلال المناسبات الدينية التي تستقبل الملايين سنويا، لاستطاع أن يرفد الميزانية بنحو 11 مليار دولار سنويا. أنطوان وصف تهميش القطاعات الأخرى كالصناعة والزراعة والسياحة والخدمات بـالخطأ الكبير (الجزيرة نت) القطاع الخاص من جانبه، يصف الباحث الاقتصادي باسم أنطوان اعتماد الاقتصاد العراقي على النفط وتهميش القطاعات الأخرى كالصناعة والزراعة والسياحة والخدمات بالخطأ الكبير في إدارة موارد الدولة، مشيرا إلى أن من شأن تطوير القطاعات غير النفطية توفير إيرادات تقارب 40% من الريع النفطي. وواحدة من السلبيات التي سُجلت على الاقتصاد العراقي أن الدولة تُهيمن عليه وتحتكره بشكل كبير، وهي تنفق على نحو 70 شركة عامة و250 معملا، أغلبها شبه معطلة دون أن يكون لها مردود أو ناتج جيد. وهذا ما دفع بعض الخبراء ومنهم أنطوان إلى طرح فكرة التخلي عن هذه الشركات وتحويلها إلى القطاع الخاص. وفي حال حدث ذلك، فإن إنتاجية الفرد ستزداد مع مُساهمة القطاع الخاص بزيادة الناتج الإجمالي المحلي مع ارتفاع الإيرادات بشكل كبير، إلا أن بقاءها بيد الدولة وهي عاجزة عن تطويرها، كما الحال في قطاع الكهرباء، فيعني أن الأمور ستبقى على ما هي عليه. القطاع الصناعي في العراق لا يشكل حاليا سوى 1.5% من إجمالي الناتج المحلي في العراق (الجزيرة نت) وكان القطاع الصناعي يُشكل في مرحلة سابقة أكثر من 18% من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أنه لا يساوي اليوم أكثر من 1.5% كما يؤكد أنطوان للجزيرة نت، وكذلك الحال مع القطاع الزراعي الذي كان يصل إلى نحو 24% واليوم لا يتجاوز 5%. ورغم أن القطاع الصناعي شبه مشلول اليوم، فإن الخبير الاقتصادي لا يستبعد إمكانية أن ينافس النفط في تحقيق إيرادات كبيرة للدولة في حال تم توظيفه بشكل صحيح، وسيرفع من نسبة المساهمة ويُشغل القوى العاملة ويُقلل من البطالة باستيعابه الخريجين مع وجود أكثر من 170 ألف خريج سنويا. وينتقد أنطوان تهميش الصناعات البتروكيميائية التي تعدّ من الصناعات الأساسية التي كان يشتهر بها العراق وكانت تحقق له إيرادات جيدة، بالإضافة إلى الصناعات الاستخراجية والتحويلية، فضلا عن قطاعي النقل والتأمين. المصدر : الجزيرة
عربية Draw: رامي الأمين - صحافي لبناني/ DARAJ الرقم الدقيق لحجم المبالغ العراقية المرتبطة بنظام صدام حسين المحتجزة في المصارف اللبنانية موجود فقط لدى رياض سلامة ولدى النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم. الخبر يقول إن “ملايين الدولارات من عائدات نفط إقليم كردستان- العراق محتجزة في لبنان”. وهو يستند إلى تقرير نشرته شركة “ديلويت” الدولية للتدقيق حول صادرات نفط الإقليم للعام 2021، وفيه ملاحظة (رقم 10) تفيد بـ”إعادة تصنيف مبلغ وقدره 310 ملايين يورو سبق أن دفعها مشترٍ واحتفظ بها في حساب ضمان في حساب مصرفي في لبنان كدفعة مقدّمة. لم يتم الإبلاغ عن هذا المبلغ حتى الآن في صافي الحركة في أرصدة حساب المشتري أو الرصيد الإجمالي المستحق من حكومة إقليم كردستان… ولم يتم الإفراج عن الأموال إلى حكومة إقليم كردستان بعد”. وتضيف الملاحظة العاشرة من التقرير أن “البنوك في لبنان تواصل تقييد حركة العملات الأجنبية خارج البلاد”، كما يكشف التقرير عن وجود مبلغ آخر من عائدات نفط اقليم كردستان محتجز في أحد المصارف اللبنانية ويبلغ 294 مليون دولار أميركي. نتحدث هنا عن رصيدين في حسابين مصرفيين فقط، من أصل عشرات، بل ربما مئات الأرصدة التي تعود إلى رجال أعمال عراقيين ومسؤولين سياسيين وأموال عامة عائدة للدولة العراقية عالقة في المصارف اللبنانية. وهذه الأموال يقدّرها مصدر حكومي التقى به فريق “درج” أثناء زيارته العراق لمتابعة ملف “وثائق إريكسون”، بـ17 مليار دولار، ويقول المصدر إن من بينها ملياراً و300 مليون دولار تعود للحكومة العراقية عالقة في المصارف اللبنانية. بيان لعائدات النفط في إقليم كردستان العالقة في المصارف اللبنانية كما نشرته حكومة الإقليم لا نعرف على وجه الدقّة ما إذا كانت أموال عائدات نفط اقليم كردستان محسوبة ضمن هذا المبلغ (مليار و300 مليون دولار)، لكن الأكيد أن المبلغ الاجمالي الهائل للاموال العراقية العالقة في لبنان (17 مليار دولار) يتوزع بين أموال مجمّدة بفعل العقوبات الدولية (أموال صدام حسين وعائلته)، وأموال أخرى تعود لرجال أعمال عراقيين قرروا الاستفادة من السرية المصرفية اللبنانية لتخبئة أموالهم، وكثير منها قد يكون موضوع مساءلة داخل العراق نفسه. وطبعاً لا يخلو الأمر من أموال “نظيفة” أخطأ أصحابها في وضع ثقتهم بالنظام المصرفي اللبناني، فخسروا أموالهم على غرار المودعين اللبنانيين. في 22 آذار/ مارس الماضي، تقدمت الدائرة القانونية لمجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام” بإخبار أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، وذلك “ضد كل من يظهره التحقيق من المصارف والأشخاص المعنويين والطبيعيين بجرائم الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال وإساءة الأمانة ومخالفة أحكام قانون النقد والتسليف ومخالفة القرارات الإدارية وذلك على خلفية ما يعرف بأموال الرئيس صدام حسين المجمدة والتي تقدر بمليارات الدولارات. هذه الأموال، بحسب المجموعة “تم وضعها في مصارف لبنانية بأسماء موالين للنظام العراقي السابق بعد غزو الكويت عام 1990 وصدور قرارات دولية حاصرت العراق على جميع المستويات ومنها القطاع المصرفي، وقد توافرت معلومات عن استعمال هذه الودائع في العمليات المصرفية في لبنان ثم تبخرت بفعل الأزمة التي ضربت القطاع المصرفي في لبنان”. المحامي حسن عادل بزي تابع هذه القضية مع مجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام”، وبحكم توكيله من قبل أحد العراقيين المحتجزة أموالهم في لبنان، لمحاولة استعادتها، وهو يمتلك معلومات وتفاصيل وأرقام حسابات تثبت وجود أرصدة له في عدد من المصارف اللبنانية تزيد على 300 مليون دولار. يقول بزي لـ”درج” إن التقديرات تتحدث عما يزيد على ستة مليارات دولار لما يسمى “أموال صدّام”، و”الداتا” الخاصة بهذه الأموال موجودة لدى هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان التي يرأسها الحاكم رياض سلامة. وبالتالي الرقم الدقيق لحجم المبالغ العراقية المرتبطة بنظام صدام حسين المحتجزة في المصارف اللبنانية موجود فقط لدى رياض سلامة ولدى النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم، المطّلع عن كثب على الملف. وهذه الأموال محتجزة في المصارف اللبنانية بقرار من هيئة التحقيق الخاصة يمنع التصرف بها. بمعنى آخر يلزم القانون المصارف بالإبقاء على هذه الأموال “كاش” في خزائنها، وعدم استثمارها من ضمن أموال المودعين. لكن خلال التحقيقات التي أجرتها القاضية غادة عون مع عدد من المصارف تبين أن الأموال النقدية بالعملات الأجنبية بما فيها الأموال العراقية”تبخّرت” مع بقية أموال المودعين وأن المصارف تصرفت بها واستثمرت فيها لمدة تزيد على 25 عاماً. قضية الأموال العراقية المحتجزة في لبنان أثيرت خلال زيارة الوفد العراقي الأخيرة إلى بيروت، خصوصاً مع الحديث عن مساهمة عراقية في إعادة إعمار مرفأ بيروت، وهو ما استهجنه عراقيون يرون أن حكومتهم مقصّرة في إعادة إعمار المناطق التي دمّرها “داعش”، وفي الوقت نفسه تتنطح للمساهمة في إعمار مرفأ بيروت. لكن خبراء اقتصاديون رأوا ان مصالح العراق في إبقاء علاقة جيدة بلبنان، عبر هذه المبادرة، تأخذ بعين الإعتبار الأموال العراقية المحتجزة في المصارف اللبنانية. “درج” سأل الخبير الاقتصادي العراقي همام الشماع عن معلوماته حول أموال عراقية محتجزة في لبنان، فتحدّث عن متابعته قضية أرصدة تتعلق بـ”بنك كردستان” حصراً، وهي عالقة في ثلاثة مصارف لبنانية، وتبلغ 40 مليون دولار أميركي. وهذا المبلغ يعتبر صغيراً مقارنة بالمبالغ التي يتحدث عنها المصدر الحكومي الذي التقاه فريق “درج” في بغداد، والبالغة 17 مليار دولار. صحافيون عراقيون التقيناهم خلال زيارتنا العراق، تحدثوا عن أموال بملايين الدولارات مرتبطة برئيس الحكومة الأسبق نوري المالكي عالقة في المصارف اللبنانية. فيما قال أحد الصحافيين إن بحوزته معطيات عن تحويلات مالية لاتباع المالكي إلى لبنان منذ عام 2015 وحتى الانهيار الاقتصادي في لبنان عام 2019، لشراء فلل وأراضٍ ومنازل وعمارات وفنادق في لبنان، لمحاولة إخراج أموال و”تبييضها” خوفاً من العقوبات الأميركية. لكننا لم نستطع التأكد بشكل قاطع من هذه المعطيات. كما علم “درج” أن رغد صدام حسين، ابنة الديكتاتور العراقي المخلوع كلفت أحد المحامين في بيروت بمتابعة أموال تفوق المليار دولار باسم زوجها حسين كامل الذي قتله النظام العراقي عام 1996، وبعض هذه الحسابات موجود في “بنك لبنان والمهجر”. لكن المصرف بحسب ما أكد أحد محامي رغد لـ”درج” أنكر وجود الأموال. المحامي الذي تحفظ على ذكر اسمه أكد أن عائلة حسين كامل لا تمتلك اي مستندات لإثبات وجود هذه الأموال، خصوصاً أن رغد هربت من العراق مع الغزو الأميركي عام 2003، لتستقر بعدها بين الأردن والإمارات.
تقرير : DRAW أعلن العراق،أن صادراته النفطية المتحققة خلال عام 2021 تجاوزت مليار برميل، وأوضحت شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، أن الإيرادات المحققة من مبيعات النفط الخام بلغت 75 مليارا، في حين أعلنت حكومة إقليم كوردستان إنها صدرت في عام ( 2021) أكثر من ( 151 مليون) برميل من النفط، بعد حساب نفقات الاستخراج والتسويق و بيع برميل النفط بأقل من سعر السوق بـ( 10 دولارات) تكون الحكومة حصلت على عائدات مالية تقدر بـ ( 3 مليار و 870 مليون دولار) خلال عام 2021. أولا - الصادرات والايرادات النفطية للعراق خلال عام 2021. بلغ مجموع الصادرات النفطية العراقية خلال عام 2021 ( مليارا و102 مليون و188 ألف برميل)، بمعدل تصدير شهري بلغ 91 مليونا و849 ألف برميل، وبمعدل يومي بلغ مليونين و962 ألف برميل.. مضيفة أن الإيرادات المحققة من مبيعات النفط الخام بلغت( 75 مليارا و650 مليون و 606 الف دولار، بمعنى أخرأذا ما قورنت هذه الواردات المتحققة بالدولار بالدينار العراقي، وحسبنا سعرالدولار مقابل الدينار العراقي بـ ( 1450)، فسيكون المجموع الكلي للايرادات بالدينار(109 ترلیون و 693 ملیار و 378 ملیون 700 هەزار) دینار ثانيا- مصادر الصادرات النفطية العراقية أشارت الشركة تسويق النفط العراقية ( سومو) إلى أن مجموع الصادرات من الحقول النفطية في البصرة ووسط العراق، المصدرة عن طريق موانئ البصرة خلال العام 2021، بلغ( مليار و65 مليون 414ألف و695 ) برميل، فيما بلغت الصادرات من حقول كركوك عبر ميناء جيهان التركي،( 36 مليونا و774 ألف و288 )برميل، وشكلت صادرات نفط البصرة ووسط العراق نسبة (96.65%) من المجموع الكلي للصادرات، أما الصادرات النفطية المصدرة من حقول كركوك فأنها شكلت نسبة (3.45%)من المجموع الكلي للصادرات. ثالثا – واردات نفط إقليم كوردستان. صدرت حكومة إقليم كوردستان في عام ( 2021) أكثرمن ( 151 مليون) برميل من النفط، وفق الاحصائيات، كان معدل سعر البرميل خلال تلك سنة في الاسواق العالمية أكثرمن ( 70 دولارا)، أي أن قيمة النفط المصدر قبل حساب نفقات الاستخراج والتسويق تقدربـ ( 10 مليار و 670 مليون دولار)، وهذا المبلغ يعادل بالدينار العراقي ( 15 ترليون و553 مليار دينار)، بعد حساب نفقات الاستخراج والتسويق و بيع برميل النفط بأقل من سعر السوق بـ( 10 دولارات)، تكون الحكومة حصلت على عائدات مالية تقدر بـ( 5 ترليون و 611 مليار دينار) خلال عام 2021 . في 28 حوزيران 2021، أعلن وزير الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كوردستان( كمال اتروشي) خلال جلسة برلمان الاقليم أن،" نسبة (58%) من عائدات النفط تذهب الى الشركات النفطية و نفقات الاستخراج، حيث أن (20%) من العائدات تذهب كنفقات أستخراج النفط و نسبة (14%) منها تذهب كمستحقات لشركات النفط و (6%) نفقات نقل النفط وتصديره عن طريق الانبوب الناقل الى ميناء جيهان التركي، أما ماتبقى فهي لدفع الديون المستحقة على الحكومة، إضافة الى ذلك فأن حكومة الاقليم تبيع برميل النفط بـ( 10) دولارات أقل من سعر السوق العالمية، لذلك تبقى لحكومة الاقليم (3 ملیار و 870 ملیون 24 الف و 521) دولار، أذا تم احتساب الدولار الواحد مقابل(1450) دينار عراقي تكون الحكومة حصلت على (5 ترلیون و 611 ملیار و 535 ملیون و 410 الف و 740) دينار خلال عام (2021 ). في نفس الوقت فأن(5 ملیار 344 ملیون و319 الف و 439) دولار، تذهب الى نفقات الاستخراج و وأجور الشركات النفطية العاملة في الاقليم وهذا المبلغ يعادل بالدينار العراقي(7 ترلیون و749 ملیار و 263 ملیون و 186 الف 260).
عربية Draw: رئيس مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون فخري كريم مخاطبا الصدر: ? أتمنى عليكم منع التغول بين أنصاركم ،وتحريم الانتقام من الخصوم خارج سلطة القضاء والفصل بين بين حرمة السلطات وإختصاصاتها والنفوذ السياسي للزعيم ?تغريدتكم حول إستدعاء وزير المالية ومحافط البنك المركزي أشاع أجواء القلق والتساؤل حول المسافة بين الزعامة و المسؤولية. عربية DRAW : خاطب السياسي والصحافي ورئيس مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون، فخري كريم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بعد تغريدته التي طالب فيها بإستدعاء وزير المالية ومحافظ البنك المركزي على خلفية تغيير سعر صرف الدينار، وقال كريم مخاطبا الصدر: ? أتمنى عليكم منع التغول بين أنصاركم ،وتحريم الانتقام من الخصوم خارج سلطة القضاء والفصل بين بين حرمة السلطات و إختصاصاتها والنفوذ السياسي للزعيم. ? فزعيم الاكثرية هو الاحرص على صيانة الدستور وحماية من يستظل به". ? الناس يريدون بسط سلطة الدولة والقانون و تصفية قوة تغول قوى اللادولة و السلاح المنفلت والميليشيات. ?نطالب بالتغيير دون تدوير فضلات الفساد وتبديل الوجوه، ?نؤكد على الاغلبية الوطنية في إعادة الاعتبار للوطن والمواطن،ولكن بإدوات الشرعية السياسية في أطار الدولة و مؤسساتها والقضاء العادل . ?تغريدتكم حول إستدعاء وزير المالية و محافط البنك المركزي أشاع أجواء القلق والتساؤل حول المسافة بين الزعامة والمسؤولية.
عربية Draw: المنصب من اجل قيادة السنة. تم تحديد يوم الأحد الموافق 9 كانون الثاني 2022، موعداً لانعقاد أول جلسة لمجلس النواب الجديد في دورته التشريعية الخامسة. وبحسب المرسوم الجمهوري فقد تمت دعوة مجلس مجلس النواب المنتخب بدورته الخامسة للانعقاد من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح في يوم الأحد الموافق 9 كانون الثاني 2022 على أن يترأس الجلسة أكبر الأعضاء سناً. وتنص المادة (54) من الدستور العراقي على أنه "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسومٍ جمهوري، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة، وتعقد الجلسة برئاسة أكبر الأعضاء سناً لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ولا يجوز التمديد لأكثر من المدة المذكورة آنفاً، الفرصة سنحت هذه المرة لـ(محمود المشهداني) من المكون السني لكي يرأس الجلسة الاولى لمجلس النواب، لانه اكبر اعضاء البرلمان سنا وهو من مواليد ى الاول من تموز 1948. بحسب العرف السياسي المتبع في العراق بعد سقوط نظام صدام حسين في عام 2003، فأن منصب رئاسة مجلس النواب من حصة السنة، ورئاسة الحكومة من حصة الشيعة و رئاسة الجمهورية من حصة الكورد. تحالف«تقدم» برئاسة محمد الحلبوسي، هي الكتلة السنية التي فازت بأكثر المقاعد في مجلس النواب العراقي و الحاصل على 37 مقعداً، وانظارهذه الكتلة ترنو الى ان يتولى رئيسها الولاية الثانية لمجلس النواب العراقي. الا ان جهات من داخل المكون السني و جهات اخرى خارج المكون يعارضون تولي الحلبوسي رئاسة مجلس النواب لولاية ثانية. العزم الذي يتزعمه الشخصية السنية المعروفة ورجل الاعمال الثري خميس الخنجر، من الكتل المهمة داخل المكون السني و هو يسعى لان تكون رئاسة مجلس النواب هذه المرة من حصة كتلته، الحلبوسي و الخنجر، قاما برحلات مكوكية الى اربيل و دولة الامارات لحسم منصب رئاسة مجلس النواب لصالحهم( الحلبوسي مقرب الى دولة الامارات المتحدة و الخنجر مقرب من تركيا) . بحسب تصريح محمود المشهداني، الرئيس الاكبر سنا للبرلمان العراقي في دورته الخامسة،" الخنجر يسعى للحصول على منصب رئاسة مجلس النواب هذه المرة ، الا ان كتلته لم يتفق حتى الان على المرشح الذي سيتولى المنصب). لمنصب رئاسة مجلس النواب اهمية كبيرة للمكون السني، الشخص الذي يتولى المنصب، سيتراس سنة العراق، وهذه الالية غير متبعة داخل المكونين الشيعي و الكوردي. بسبب الصراع المتأزم بين الحلبوسي و الخنجر من غير المتوقع ان يحسم منصب رئاسة المجلس النواب في الجلسة الاولى، مما يؤدي الى ابقاء الجلسة مفتوحة الى ان يتفق الجهات السياسية فيما بينهم. هناك فكرة داخل المكون السني لحل المشاكل العالقة بين الحلبوسي و الخنجر، وهي تولي الحلبوسي رئاسة المجلس النواب للولاية الثانية ، واعطاء منصب نائب رئيس الجمهورية لكتلة الخنجر، الا ان اعضاء كتلة الخنجر يرفضون الفكرة وهم مصرون علي عدم حصول الحلبوسي على الولاية الثانية. تحالف العزم رشح ( 3) اسماء لتولي منصب رئاسة مجلس النواب وهم كل من ( القيادي في التحالف ووزير الدفاع السابق خالد العبيدي ومحمود المشهداني، الذي لايلقى تأيدا من الاوساط السياسية العراقية، اما الشخصية الثالثة هو ثابت العباسي، وهو من المكون التركماني ومقرب للشيعة، ويعتقد ان هذه الشخصية لايستطيع تمثيل السنة. من المتوقع ان ينتهي الصراع بين الحلبوسي والخنجر الى التوصل لحل وسط، من خلال ترشيح شخصية سياسية سنية من الخط الثاني لرئاسة البرلمان على ان لايكون من خط "الصقور" لكي لايصبح رئيسا للمكون السني وفي نفس الوقت لايكون من خط ( الحمائم) ويكون ضعيفا و ان يستغل من قبل المكونات السياسية الاخرى. التوقعات تشير الى ان بعد وصول الأنباء الخاصة بلقاء الحلبوسي والخنجر في دولة الإمارات العربية المتحدة، وشبه الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان بضمانة إماراتية، إلى باقي الأعضاء في تحالف عزم الذي يترأسه الخنجر وينافس تحالف "تقدم"، بزعامة الحلبوسي، ثارت حفيظة أعضاء تحالف عزم. الرافضين لما سماه "صفقة الحلبوسي"، حيث اكدوا بانهم ولن يسمحوا للحلبوسي برئاسة البرلمان مرة ثانية، إذا صمم الخنجر على تنفيذ هذا الاتفاق، فسوف يعلنون انشقاقهم عن تحالف عز، .هناك العديد من أعضاء عزم لا يريدون الحلبوسي رئيساً للبرلمان مرة ثانية، ويعتقدون ان تحالف عزم قادر بمفرده على اختيار رئيس للبرلمان آخر غير الحلبوسي.
عربية Draw: 1 من سيصبح رئيسا للوزراء العراق؟ رغم عدم وجود مرشحين واضحين حتى الآن، لكن هناك تداول لعدة أسماء داخل البيت الشيعي لرئاسة الوزراء، أبرزهم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، ومحافظ البصرة الحالي أسعد العيداني، والوزير السابق محمد شياع السوداني، ومحافظ النجف السابق عدنان الزرفي، وحسن الكعبي نائب رئيس مجلس النواب السابق، وسفير العراق في لندن جعفر الصدر، والوزير السابق نصار الربيعي، إلى جانب رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي. يسعى التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر -والذي جاء في المرتبة الأولى بواقع 73 مقعدا بالبرلمان (وفقا للنتائج الأولية) من أصل 329 في الانتخابات الأخيرة- إلى تشكيل الكتلة النيابية الأكثر عددا لتشكيل الحكومة الجديدة، لكنّ لم يتم الاتفاق حتى الآن على شخصية معيّنة لرئاسة الحكومة لأنّ ذلك يحتاج إلى توافق داخل البيت الشيعي. حصل دولة القانون على( 34 مقعدا) وهناك وجود حظوظ كبيرة لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي بأن يكون مرشح القوى المحسوبة على الفصائل والحشد الشعبي المنضوية فيما بات يُسمى بـ"الإطار التنسيقي" وهو يسعى لتشكيل الكتلة النيابية الأكثر عددا والإعلان عنها قريبا لتشكيل الحكومة الجديدة وهناك ( 4) سيناريوهات لذلك : السيناريو الاول. اتفاق التيارالصدري مع اطراف الاطار التنسيقي و الكورد والسنة، ومن ثم تشكيل الكتلة الاكبر، من الصعب تحقيق هذا السيناريو، لان الصدر يرفض تشكيل حكومة توافقية و ويريد تشكيل حكومة اغلبية وطنية . السيناريو الثاني . توصل الكتلة الصدرية للاتفاق مع الكورد والسنة و تشكيل الكتلة الاكبر داخل البرلمان، تحقيق هذا السيناريو صعب ايضا، لان ايران ابلغت الاطراف الكوردية عن طريق سفيرها في بغداد عدم التدخل في الصراع الشيعي الشيعي. السيناريو الثالث: اتفاق اطراف الاطار التنسيقي، مع الكورد والسنة و طرد التيار الصدري خارج المعادلة، تحقيق هذا السيناريو يعرض الوضع السياسي للعراق و يعرض البيت الشيعي للازمة كبيرة و يضع مصير الحكومة القادمة على المحك وربما سيكون مشابها لمصير حكومة عادل عبدالمهدي اذا اختار الصدريون المعارضة. السيناريو الرابع اتفاق الصدر مع بعض اطراف الاطار التنسيقي بالتعاون مع الكورد والسنة، وهذا السيناريو متوقع حدوثه، وسيؤدي الى فرط عقد الاطار وسيكون نوري المالكي ضحية لهذا السيناريو ويذهب احلامه في ترأس الحكومة مرة اخرى تحت الثرى، في خضم هذا الصراع هناك السيناريو عدد من سياسي الشيعة مرشحين لتولي منصب رئاسة الحكومة القادمة. اولا :مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي ، له اكثر حظوظا لتولي المنصب و يحظى بدعم الاميركان والايرانين، الا ان الاطراف الشيعية الخاسرة في الانتخابات يرفضون توليه المنصب لولاية ثانية، اذا فشل الاتفاق النووي بين ايران واميركا، فأن حظوظ الكاظمي سيكون كبيرا لانه مرشح التوافق بين هاتين الدولتين. اضافة الى ذلك للكاظمي دور كبير لتقريب وجهات النظر بين الايرانيين و السعوديين. ثانيا: مرشحون اخرون. هناك شخصيات اخرى مرشحة لنيل منصب رئاسة الحكومة: اسعد العيداني علي شكري حيدر العبادي محمد شياع السوداني محمد توفيق علاوي
عربية Draw: صلاح حسن بابان - الجزيرة بغداد- طوى العراق صفحات عام 2021 بالعديد من الأحداث الاستثنائية على مختلف الأصعدة، لعل أبرزها إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة واستكمال انسحاب القوات القتالية الأميركية من البلاد، على سبيل المثال لا الحصر. ورغم صعوبة التنبؤ بمستقبل الأحداث في العراق عام 2022، فإن محللين يتوقعون أن يكون عاما ساخنا مع اقتراب موعد انعقاد أول جلسة برلمانية وتزايد الجدل حول الاتفاق على الكتلة الكبرى لتشكيل الحكومة الجديدة واختيار رئيس لها. العنبر: المعطيات المتوفرة توحي بعدم لجوء القوى السياسية إلى بداية جديدة (الجزيرة) التوقعات السياسية سياسيا، يرى المحلل السياسي الدكتور أياد العنبر في خطوات الاتفاق على تشكيل الحكومة الجديدة مفتاحا أساسيا لحل كل الأزمات في العراق أو زيادة التعقيد فيها خلال العام الجديد ومنها المتراكمة منذ العام 2021، ولا يستبعد في الوقت ذاته إعادة بعض السيناريوهات السابقة، أبرزها أن الحكومة تكون غير قادرة على مواجهة التحديات وتبقى تدور في دوامة الفساد، عازيا السبب في ذلك إلى معطيات توحي بعدم لجوء القوى السياسية إلى بداية جديدة. وفي حال حصول أي تغيير سياسي في عام 2022، يتوقع العنبر أن يكون نسبيا، أو قد يكون متوافقا مع طبيعة المعطيات الدولية والإقليمية التي ستكون حاضرة خلال السنوات القادمة. ويستبعد العنبر استمرار احتفاظ مصطفى الكاظمي وبرهم صالح ومحمد الحلبوسي بالرئاسات الثلاث، وذلك بسبب الخلافات السياسية التي لن تسمح بإعادة الوجوه نفسها لسوء إدارتها، وعدم مراهنة القوى السياسية النافذة على التجديد لها. الشماع يتوقع أن يزداد الضغط على الرواتب والتعيينات عبر خفض قيمة العملة المحلية أكثر (الجزيرة) تشاؤم اقتصادي وأمّا على المستوى الاقتصادي، فيرجح مختصون استمرار تطبيق مشروع "الورقة البيضاء" الذي طبّقته حكومة مصطفى الكاظمي في أكتوبر/تشرين الأول 2020، ليكون بمثابة برنامج للإصلاح الاقتصادي. يطرح الخبير الاقتصادي همام الشماع سيناريوهين لعام 2022، يحصر الأول منه ببقاء حكومة الكاظمي وفريقها الخاص الذي عمل في 2020 و2021 وتحديدا وزير المالية علي علاوي، وهو الأسوء اقتصاديا على مختلف الأصعدة، بسبب ما يصفها بـ"تصريحات سوداوية" أطلقها عن تسريح موظفي الدولة، بعد 10 أعوام، بسبب أفول عصر النفط، في ظل اعتماد العراق عليه، وذلك من أجل تمويل موازناته المالية، مما يعني إعادة سيناريو التهديد الذي بدأه في نهاية 2020 وبداية 2021، وهو يُنذر بقطع الرواتب وعدم وجود أموال لدفعها. ويتوقع الشماع أن يزداد الضغط على الرواتب والتعيينات من خلال خفض قيمة العملة المحلية أكثر، وهذا ما سيؤدي إلى تردي الحياة الاقتصادية أكثر، بالإضافة إلى تردي الواقع الزراعي بسبب شحّ المياه مع تراجع الوضع الصناعي، ليزيد من حجم السلبيات في 2022 بعدم حدوث أي تغيير في القطاع الكهربائي أيضا. وأما السيناريو الثاني فيتمثل في مجيء حكومةٍ جديدة تبدأ بخطواتٍ إصلاحية ليس من خلال الضغط على مستويات معيشية مُتدنية للشعب، وإنما الضغط على الطبقات الثرية المستفيدة بغير وجه حق من المحاصصة والانفلات الأمني والإداري، حسب تعبير الشماع للجزيرة نت، وسيكون حال الشعب أفضل حتى لو نجحت في تطبيق ما نسبته 30% منها لتزيد من حركة السوق والوضع الاقتصادي. الطائي عبّر عن خشيته من استمرار الخروق الأمنية وزيادتها عام 2022 (الجزيرة) تدوير الوجوه أمنيا أمنيا، يتوقع الخبير في هذا الشأن عقيل الطائي بقاء السيناريوهات الأمنية دون تغيير عام 2022 التي تعتمد على الإستراتيجيات التقليدية بانتشار القوات الأمنية واستثمارها لأغراض استعراضية في بغداد وباقي المناطق، في ظل غياب الضوابط والإدارة الحقيقية وعدم الاعتماد على الجهد الاستخباري في معالجة الكثير من الفراغات الأمنية. أكثر ما ينتقده الطائي، في حديثه للجزيرة نت، هو وضع بعض القادة الأمنيين في مهام وواجبات عسكرية بتأثيرات سياسية دون أن يكون لهم أي مؤهلات كافية، محمّلاً في الوقت ذاته المناكفات والصراعات السياسية مسؤولية الإخفاقات الأمنية في البلد التي تكون فرصة جيدة لتنظيم الدولة الإسلامية لاستغلالها وزيادة عملياته ضد المواقع الأمنية. ولا يخفي الطائي خشيته من استمرار الخروق الأمنية بل وزيادتها عام 2022 بنسبة كبرى مما حدث العام الماضي، وإذا تشكلت حكومة توافقية سيواجه الملف الأمني فيها الكثير من المشاكل، إلا أن الأمر قد ينعكس لو تشكّلت حكومة وطنية تتحمل مسؤولية حماية الشعب على مختلف الأصعدة، بعيدا عن اتخاذ أسلوب تدوير الوجوه الأمنية والعسكرية. وفي رده على سؤالٍ عن احتمال استمرار الهجمات على المصالح الأميركية بعد إعلان الكاظمي عن انسحاب القوات القتالية وانحصار المدربين والمستشارين منهم في قاعدتي عين الأسد بمحافظة الأنبار غربي البلاد وحرير بكردستان العراق، يميل الطائي إلى احتمال تراجع هجمات الفصائل الشيعية، لكنّه لا يستبعد وجود أيادٍ تعمل على نشر الفوضى وقلب الأوراق بتنفيذ هجمات على القوات الأميركية لتزيد من وجود الأطراف المتناحرة في الساحة. جاسم: وزارة الثقافة تحرض على أن يشهد العام الحالي العديد من الفعاليات الثقافية والفنية (الجزيرة) الواقع الثقافي وعن الجانب الثقافي، شهد العراق عام 2021 العديد من الفعاليات والمهرجانات الثقافية سواء على مستوى الفنون أو الشعر، باستضافته الكثير من الوجوه الفنية المحلية والعربية وإقامة فعاليات فنية وثقافية متعدّدة حضرها نجوم عرب بارزون مثل النجم المصري أحمد عبد العزيز والمطرب علي الحجار والممثل السوري أيمن زيدان، وكذلك تنظيم مهرجان بابل الدولي مجددا بمشاركة مطربين بارزين في مقدمتهم هاني شاكر، ومعرض بغداد الدولي للكتاب. وتحرص وزارة الثقافة العراقية على أن يكون العام الحالي مشابها أو يفوق العام الماضي في إقامة وتنظيم الفعاليات الثقافية والفنية وعلى مختلف الأصعدة، حسب وكيلها عماد جاسم، لكنه يربط ذلك بالموافقة على بعض المعطيات في موازنة هذا العام التي تُطالب بها وزارته من خلال منحها فرصة لتجدّد العطاء بتخصيصات مالية كافية وتناسب حجم الطموح. وأعدّت الوزارة منهاجا متكاملا للعام الحالي للانفتاح على منظمات دولية، وبمخاطبتها الجاليات العراقية المقيمة في المهجر مع سعيها لعقد مؤتمر للمسرحيين المُغتربين لتكون فرصة ثمينة لهم لتقديم أعمالهم المسرحية الكبيرة والرائدة، بالإضافة إلى إعداد خطط لاستقبال العديد من المثقفين ليأتوا إلى بلدهم من الخارج والاحتفاء بهم. ومن أبرز الفعاليات التي تحرص الوزارة على إقامتها عام 2022، وكانت قد نظمتها العام الماضي، وتكرارها بثوبٍ يليق بالثقافة والفنون العراقية: مؤتمرات خاصّة بالحقول الاجتماعية والنفسية مثل مؤتمر عالم الاجتماع الراحل علي الوردي للعلوم الاجتماعية، حسب تأكيد جاسم للجزيرة نت، الذي أشار إلى وجود مساع لتنظيم مهرجانين سينمائي ومسرحي مع العديد من المهرجانات الدورية. المصدر : الجزيرة
عربية Draw: سيناريوهات تشكيل الحكومة العراقية القادمة . تم تحديد يوم الأحد الموافق 9 كانون الثاني 2022، موعداً لانعقاد أول جلسة لمجلس النواب الجديد في دورته التشريعية الخامسة.وبحسب المرسوم جمهوري الصادر فقد تمت دعوة مجلس النواب المنتخب بدورته الخامسة للانعقاد يوم الأحد الموافق 9 كانون الثاني 2022 على أن يترأس الجلسة أكبر الأعضاء سناً. بقي على عقد الجلسة الاولى (7) ايام فقط ومازال الفرقاء السياسين غير متفقين، لم يتفق الشيعة حتى اللحظة على الشخصية التي سيتولى رئاسة الوزراء، السنة غير متفقون من ستولى رئاسة مجلس النواب،والكورد غير متفقون على ترشيح شخصية لتولي منصب رئاسة الجمهورية، مرشحو الشيعة لرئاسة الحكومة لاتتعدى اصابع اليد، السنة لديهم( 4) مرشحين لرئاسة مجلس النواب، الكورد كذلك لديهم اكثرمن ( 5) مرشحين لتولي منصب رئاسة الجمهورية. المنصب من اجل قيادة السنة. تم تحديد يوم الأحد الموافق 9 كانون الثاني 2022، موعداً لانعقاد أول جلسة لمجلس النواب الجديد في دورته التشريعية الخامسة. وبحسب المرسوم الجمهوري فقد تمت دعوة مجلس مجلس النواب المنتخب بدورته الخامسة للانعقاد من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح في يوم الأحد الموافق 9 كانون الثاني 2022 على أن يترأس الجلسة أكبر الأعضاء سناً. وتنص المادة (54) من الدستور العراقي على أنه "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسومٍ جمهوري، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة، وتعقد الجلسة برئاسة أكبر الأعضاء سناً لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ولا يجوز التمديد لأكثر من المدة المذكورة آنفاً، الفرصة سنحت هذه المرة لـ(محمود المشهداني) من المكون السني لكي يرأس الجلسة الاولى لمجلس النواب، لانه اكبر اعضاء البرلمان سنا وهو من مواليد ى الاول من تموز 1948. بحسب العرف السياسي المتبع في العراق بعد سقوط نظام صدام حسين في عام 2003، فأن منصب رئاسة مجلس النواب من حصة السنة، ورئاسة الحكومة من حصة الشيعة و رئاسة الجمهورية من حصة الكورد. تحالف«تقدم» برئاسة محمد الحلبوسي، هي الكتلة السنية التي فازت بأكثر المقاعد في مجلس النواب العراقي و الحاصل على 37 مقعداً، وانظارهذه الكتلة ترنو الى ان يتولى رئيسها الولاية الثانية لمجلس النواب العراقي. الا ان جهات من داخل المكون السني و جهات اخرى خارج المكون يعارضون تولي الحلبوسي رئاسة مجلس النواب لولاية ثانية. العزم الذي يتزعمه الشخصية السنية المعروفة ورجل الاعمال الثري خميس الخنجر، من الكتل المهمة داخل المكون السني و هو يسعى لان تكون رئاسة مجلس النواب هذه المرة من حصة كتلته، الحلبوسي و الخنجر، قاما برحلات مكوكية الى اربيل و دولة الامارات لحسم منصب رئاسة مجلس النواب لصالحهم( الحلبوسي مقرب الى دولة الامارات المتحدة و الخنجر مقرب من تركيا) . بحسب تصريح محمود المشهداني، الرئيس الاكبر سنا للبرلمان العراقي في دورته الخامسة،" الخنجر يسعى للحصول على منصب رئاسة مجلس النواب هذه المرة ، الا ان كتلته لم يتفق حتى الان على المرشح الذي سيتولى المنصب). لمنصب رئاسة مجلس النواب اهمية كبيرة للمكون السني، الشخص الذي يتولى المنصب، سيتراس سنة العراق، وهذه الالية غير متبعة داخل المكونين الشيعي و الكوردي. بسبب الصراع المتأزم بين الحلبوسي و الخنجر من غير المتوقع ان يحسم منصب رئاسة المجلس النواب في الجلسة الاولى، مما يؤدي الى ابقاء الجلسة مفتوحة الى ان يتفق الجهات السياسية فيما بينهم. هناك فكرة داخل المكون السني لحل المشاكل العالقة بين الحلبوسي و الخنجر، وهي تولي الحلبوسي رئاسة المجلس النواب للولاية الثانية ، واعطاء منصب نائب رئيس الجمهورية لكتلة الخنجر، الا ان اعضاء كتلة الخنجر يرفضون الفكرة وهم مصرون علي عدم حصول الحلبوسي على الولاية الثانية. تحالف العزم رشح ( 3) اسماء لتولي منصب رئاسة مجلس النواب وهم كل من ( القيادي في التحالف ووزير الدفاع السابق خالد العبيدي ومحمود المشهداني، الذي لايلقى تأيدا من الاوساط السياسية العراقية، اما الشخصية الثالثة هو ثابت العباسي، وهو من المكون التركماني ومقرب للشيعة، ويعتقد ان هذه الشخصية لايستطيع تمثيل السنة. من المتوقع ان ينتهي الصراع بين الحلبوسي والخنجر الى التوصل لحل وسط، من خلال ترشيح شخصية سياسية سنية من الخط الثاني لرئاسة البرلمان على ان لايكون من خط "الصقور" لكي لايصبح رئيسا للمكون السني وفي نفس الوقت لايكون من خط ( الحمائم) ويكون ضعيفا و ان يستغل من قبل المكونات السياسية الاخرى. التوقعات تشير الى ان بعد وصول الأنباء الخاصة بلقاء الحلبوسي والخنجر في دولة الإمارات العربية المتحدة، وشبه الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان بضمانة إماراتية، إلى باقي الأعضاء في تحالف عزم الذي يترأسه الخنجر وينافس تحالف "تقدم"، بزعامة الحلبوسي، ثارت حفيظة أعضاء تحالف عزم. الرافضين لما سماه "صفقة الحلبوسي"، حيث اكدوا بانهم ولن يسمحوا للحلبوسي برئاسة البرلمان مرة ثانية، إذا صمم الخنجر على تنفيذ هذا الاتفاق، فسوف يعلنون انشقاقهم عن تحالف عز، .هناك العديد من أعضاء عزم لا يريدون الحلبوسي رئيساً للبرلمان مرة ثانية، ويعتقدون ان تحالف عزم قادر بمفرده على اختيار رئيس للبرلمان آخر غير الحلبوسي. جولة اخرى للصراع حول منصب رئاسة الجمهورية. بحسب العرف المتبع بعد عام 2003، بعد اختيار هيأة رئاسة مجلس النواب، يتم ترشيح رئيس الجمهورية، ومن ثم يقوم رئيس الجمهورية بمخاطبة الكتلة الاكبر داخل البرلمان لاختيارمرشحها لرئاسة الحكومة.وبحسب الاتفاق الاستراتيجي بين البارتي و اليكيتي، فأن منصب رئاسة الجمهورية، من حصة الاتحاد الوطني الكوردستاني وهذا مقابل تولي شخصية من البارتي رئاسة الاقليم . بعد احداث 16 من تشرين الاول عام 2017، وسيطرة القوات الاتحادية على المناطق المتنازع عليها. واستقالة مسعود بازراني بعد 12 عاما من تولي منصب رئاسة الاقليم، اصبح منصب رئاسة الاقليم في عام 2018 شاغرا، ووزعت صلاحيات الرئيس على البرلمان ومجلس الوزراء و المجلس الاعلى للقضاء. ولقد اشترط البارتي على اليكيتي على ان يحصل على منصب محافظ كركوك مقابل ان يحصل اليكيتي على منصب رئاسة الجمهورية. ولم يصل الحزبين الى اتفاق وقدم كل منها مرشحيهم لتولي المنصب، حيث قدم اليكيتي برهم صالح لتولي المنصب، وقدم البارتي وزير الخارجية الحالي فؤاد حسين لشغل المنصب. بعد انتخابات تشرين الاول الماضي، عاد البارتي و اليكيتي مرة اخرى الى حلبة البرلمان، الا ان هذه المرة، الوضع يختلف عن عام 2018، بالنسبة للبارتي حيث اصبح موقفه قويا ومختلفا عن السابق رمم البارتي علاقته بالقوى العراقية وخاصة الاطراف الشيعية، بعد ان شابت هذه العلاقة الفتور بعد احداث 16 تشرين الاول من عام 2017. الاميركيون والايرانيون، يؤكدون على ان منصب رئاسة الجمهورية من حصة اليكيتي، الا ان اليكيتي لم يحسم مرشحه بشكل رسمي للمنصب حتى اللحظة، برهم صالح يريد ان يرشح نفسه للولاية الثانية، لطيف رشيد والملا بختيار انظارهم على المنصب ودخل اسم عضو المكتب السياسي لليكيتي ( عدنان مفتي) على الخط، الا انه سرعانما نفى ترشحه للمنصب. طالب زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني بان يحسم منصبي رئاسة الجمهورية ومنصب محافظ كركوك بالتوافق بين البارتي واليكتي، اذا تم حسم هذين المنصبين بالتوافق فأن فرصة تولي برهم صالح لولاية ثانية ستكون ضئيلة، وذلك لان البارتي يتهم صالح بالضغط على المفوضية لسلب مقعدين للبارتي في مجلس النواب لصالح اليكيتي. اذا لم يتم التوافق بين البارتي واليكيتي، فأن البارتي سيقوم لحسم المنصب لصالحه من خلال تقديم رئيس الاقليم الحالي ( نيجرفان بارزاني ) كمرشح للمنصب، وربما تكون هذه هي المفاجئة الكبرى التي طالما صرح به اعضاء الديمقراطي الكردستاني مرارا. من سيصبح رئيسا للوزراء العراق؟ رغم عدم وجود مرشحين واضحين حتى الآن، لكن هناك تداول لعدة أسماء داخل البيت الشيعي لرئاسة الوزراء، أبرزهم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، ومحافظ البصرة الحالي أسعد العيداني، والوزير السابق محمد شياع السوداني، ومحافظ النجف السابق عدنان الزرفي، وحسن الكعبي نائب رئيس مجلس النواب السابق، وسفير العراق في لندن جعفر الصدر، والوزير السابق نصار الربيعي، إلى جانب رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي. يسعى التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر -والذي جاء في المرتبة الأولى بواقع 73 مقعدا بالبرلمان (وفقا للنتائج الأولية) من أصل 329 في الانتخابات الأخيرة- إلى تشكيل الكتلة النيابية الأكثر عددا لتشكيل الحكومة الجديدة، لكنّ لم يتم الاتفاق حتى الآن على شخصية معيّنة لرئاسة الحكومة لأنّ ذلك يحتاج إلى توافق داخل البيت الشيعي. حصل دولة القانون على( 34 مقعدا) وهناك وجود حظوظ كبيرة لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي بأن يكون مرشح القوى المحسوبة على الفصائل والحشد الشعبي المنضوية فيما بات يُسمى بـ"الإطار التنسيقي" وهو يسعى لتشكيل الكتلة النيابية الأكثر عددا والإعلان عنها قريبا لتشكيل الحكومة الجديدة وهناك ( 4) سيناريوهات لذلك : السيناريو الاول. اتفاق التيارالصدري مع اطراف الاطار التنسيقي و الكورد والسنة، ومن ثم تشكيل الكتلة الاكبر، من الصعب تحقيق هذا السيناريو، لان الصدر يرفض تشكيل حكومة توافقية و ويريد تشكيل حكومة اغلبية وطنية . السيناريو الثاني . توصل الكتلة الصدرية للاتفاق مع الكورد والسنة و تشكيل الكتلة الاكبر داخل البرلمان، تحقيق هذا السيناريو صعب ايضا، لان ايران ابلغت الاطراف الكوردية عن طريق سفيرها في بغداد عدم التدخل في الصراع الشيعي الشيعي. السيناريو الثالث: اتفاق اطراف الاطار التنسيقي، مع الكورد والسنة و طرد التيار الصدري خارج المعادلة، تحقيق هذا السيناريو يعرض الوضع السياسي للعراق و يعرض البيت الشيعي للازمة كبيرة و يضع مصير الحكومة القادمة على المحك وربما سيكون مشابها لمصير حكومة عادل عبدالمهدي اذا اختار الصدريون المعارضة. السيناريو الرابع اتفاق الصدر مع بعض اطراف الاطار التنسيقي بالتعاون مع الكورد والسنة، وهذا السيناريو متوقع حدوثه، وسيؤدي الى فرط عقد الاطار وسيكون نوري المالكي ضحية لهذا السيناريو ويذهب احلامه في ترأس الحكومة مرة اخرى تحت الثرى، في خضم هذا الصراع هناك السيناريو عدد من سياسي الشيعة مرشحين لتولي منصب رئاسة الحكومة القادمة. اولا :مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي ، له اكثر حظوظا لتولي المنصب و يحظى بدعم الاميركان والايرانين، الا ان الاطراف الشيعية الخاسرة في الانتخابات يرفضون توليه المنصب لولاية ثانية، اذا فشل الاتفاق النووي بين ايران واميركا، فأن حظوظ الكاظمي سيكون كبيرا لانه مرشح التوافق بين هاتين الدولتين. اضافة الى ذلك للكاظمي دور كبير لتقريب وجهات النظر بين الايرانيين و السعوديين. ثانيا: مرشحون اخرون. هناك شخصيات اخرى مرشحة لنيل منصب رئاسة الحكومة: اسعد العيداني علي شكري حيدر العبادي محمد شياع السوداني محمد توفيق علاوي
عربية Draw: قريش - جريدة عربية مستقلة تصدر في لندن قال سياسي كردي كبير انَّ الحظ العاثر لعمار الحكيم زعيم تيار الحكمة جعله يجلس ملاصقا في كرسيه للمبعوث الأمريكي السابق في العراق وأفغانستان زلماي خليل زاد، في الجلسة الافتتاحية لمنتدى السلام والامن الذي نظمته الجامعة الامريكية في دهوك الشهر الماضي. وأضاف السياسي الذي تحدث الى مراسلة – قريش -في بيروت طالبا عدم الإفصاح عن اسمه انَّ الحكيم كان من بين ضيوف المنتدى وابدى ارتياحا، اول الامر لجلوسه الى جانب المبعوث الأمريكي، كونهما يتبادلان الكلام باللغة الفارسية بطلاقة. ومضى السياسي الكردي في القول ان المجاملات كانت واضحة بينهما، قبل ان تنتهي الجلسة الافتتاحية ويخرجا مع الحاضرين الى بهو الجامعة الامريكية بمعية قياديين كرد، وهنا بادر زلماي خليل زاد الى التوقف لحظة لتبدو على وجهه ملامح الطبيعة الأفغانية القاسية ملتفتاً الى الحكيم، قائلا له : ياسيد عمار الحكيم التاريخ لايزال قريباً، ووالدكم الراحل كان معنا، أنا شخصياً الذي قررت بعد مؤتمر لندن قبل تحريركم من صدام ان يكون الحكم بيد الشيعة، كلمتي وكلمة الرئيس بوش كانت واحدة، وهكذا كان الحكم بأيديكم، كل شيء مرّ من بين أيدينا وتحت سيطرتنا. قال الحكيم: لا نسى جهود سيادتك معنا أبداً. قاطعه زلماي خليل زاد محتداً: ليست جهودي، هذا قرار الولايات المتحدة كلها في تلك الأيام، وكان الجيش الأمريكي وكل قواتنا تعمل وتعطي التضحيات في سبيل تثبيت حكم الشيعة بالعراق. ولكن ما هي النتيجة، نراكم تقصفوننا بالصواريخ، تريدون تدمير سفارتنا في بغداد وتدمير قواتنا التي هي في الأساس لحماية حكم الشيعة. ردّ الحكيم مرتبكاً والحمرة تعلو وجهه: سيادتكم تعرفون انّ هناك متطرفين نحاول صدهم وتقييد حركتهم دائما وخطابنا دائما… جانب من الجلسة الافتتاحية في الجامعة الامريكية في دهوك- الجالسون من اليمين: مسرور بارزاني ، برهم صالح ، نيجرفان بارزاني ، عمار الحكيم ، زلماي خليل زاد قاطعه زلماي بنفس الحدة: هذا ليس حقيقة الوضع، والا ما كان اصدرتم قرار مجلس النواب بالانسحاب الأمريكي. حسناً، انا كنت الى قبل أسابيع مشرفاً على الانسحاب الأمريكي من أفغانستان وتسليم الحكم الى طالبان، نحن، يعني قواتنا ليست موجودة في أفغانستان كان هناك جيش كبير عند أشرف غني، لكن في ساعة واحدة وافقنا على رجوع طالبان الى الحكم، أشرف غني لم يقصف قواتنا، بل توسّل بقاءنا ورفضنا، انتم قصفتم سفارتنا ومصالحنا. بُهت عمار الحكيم وامتقع وجهه، وكان بعينيه يلتمس العون من قياديين كرد الى جانبه، لكن زلماي خليل زاد مضى بالقول: حسنا يا سيد الحكيم، انت بحسب وجهة نظرنا جزء من قيادة الحكم الشيعي في هذا البلد، لكن انت تقول أنك لست مع التطرف، حسنا سيد الحكيم قل لهم انّ الامريكان سينسحبون بالكامل، وانهم قادرون ان يسلموا الحكم لمن لا يعضون اليد التي احسنت اليهم، هذا ما سيحصل. التفت زلماي حوله كأنه يبحث عن مرافقيه لمغادرة المكان، تاركا خلفه صدمة كبيرة في وجه الحكيم الذي طار في اليوم ذاته ناقلا الرسالة الصاعقة الى القيادات الشيعية في بغداد.
عربية Draw: مركز البيان للدراسات والتخطيط شهد الشرق الأوسط الذي يعرف بأكثر المناطق توترا وسخونة في العالم، تشكيل ثلاثة تحالفات دولية بقيادة الولايات المتحدة في السنوات الأولى من القرن الحالي، بغية محاربة الإرهاب ومواجهة عمليات زعزعة الاستقرار والأمن الإقليمي. فكان أول التحالفات عام 2001 بعد أحداث الحادي عشر من أيلول بهدف محاربة القاعدة وطالبان في أفغانستان، وكان التحالف الثاني عام 2003 ضد النظام البعثي في العراق، وكان الثالث والأخير في عام 2014 لمواجهة داعش الإرهابي بعد ظهوره في العراق والتهامه ثلث العراق، وتم الإعلان عن هذا التحالف بواسطة الولايات المتحدة في 8 آب 2014، وبطلب رسمي من الجانب العراقي حيث انضم الحلفاء تدريجياً، وكانت بريطانيا وفرنسا وأستراليا وألمانيا أولى الدول التي انضوت تحت خيمته قبل أن تتبعها 79 دولة تدريجياً. وتقسم حلفاء الولايات المتحدة في التحالف إلى مجموعتين رئيسيتين: الأولى: الدول الـ28 المنضمة إلى حلف الناتو، والتي أعلنت دعمها للتحالف في قمة ويلز، والثانية: دول المنطقة العربية المتحالفة مع الولايات المتحدة، والتي وافقت في قمة جدة على مرافقة واشنطن في محاربة عصابات داعش الإرهابي. تعهدت الدول المتحالفة بإضعاف داعش وهزيمتها وتدمير بنيتها التحتية والاقتصادية، ومنع تسلل عناصرها عبر اراضيها، ودعم الاستقرار وتوفير الخدمات الأساسية للمناطق المحررة، وتشكيل جبهة إعلامية لمحاربة الاعلام الداعشي المضاد. لقراءة المزيد اضغط هنا

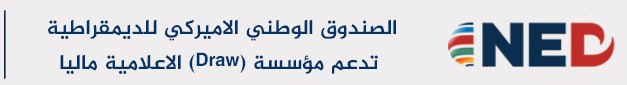

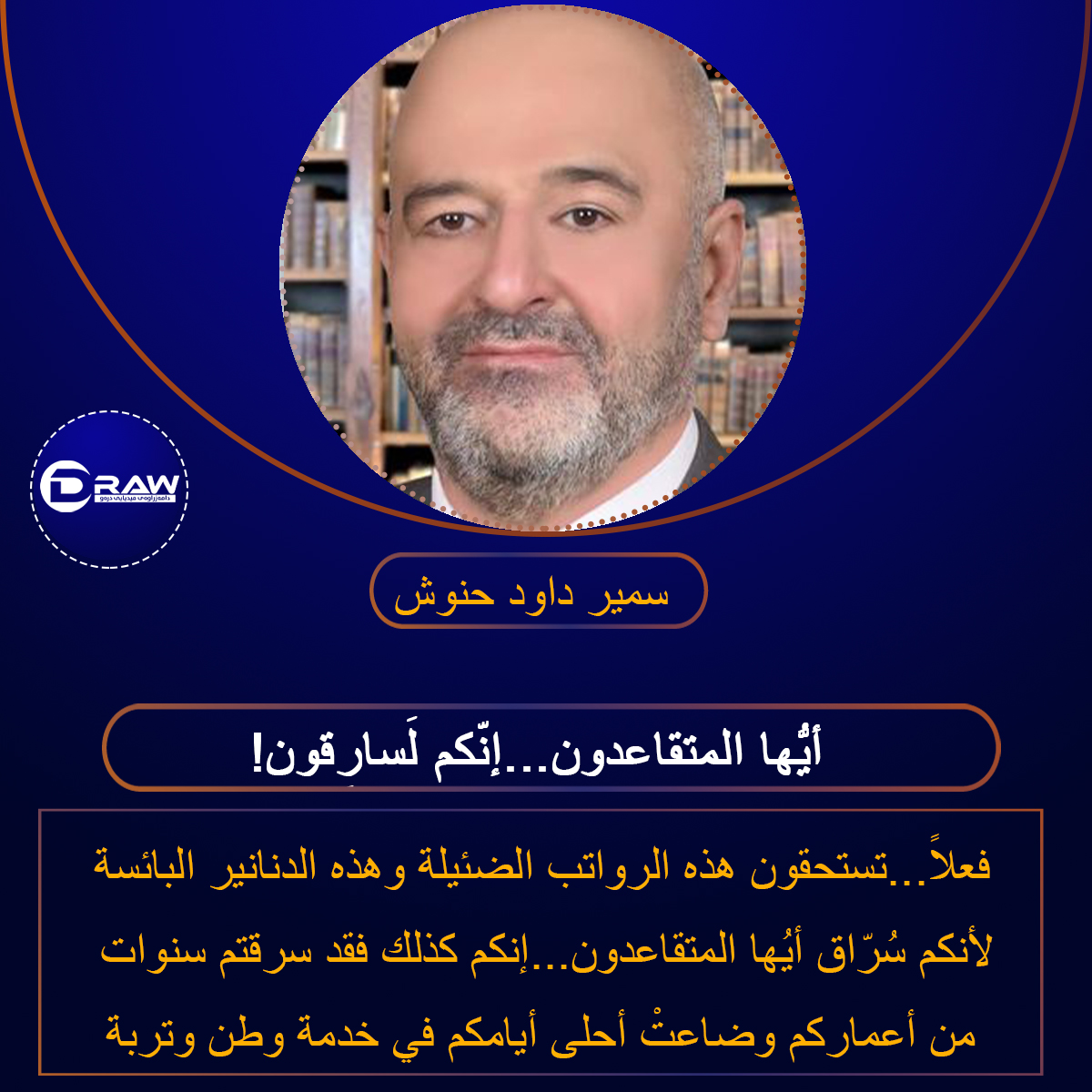
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)