عربيةDraw على الرغم من أن العالم العربي موحد بفضل العديد من العوامل الاجتماعية والتاريخية، إلا أنه يتألف من تعددية من الانتماءات العرقية والقومية والثقافية واللغوية والمذهبية ذات الأصول العريقة والتشابكات المعقدة. لقد ثبت أن تحقيق الاعتراف بالتعددية الثقافية بهذه التعددية أمرٌ بالغ الصعوبة والصراع، لا سيما في العراق، ولبنان، وسورية. ومع ذلك، نتطلع إلى حدوث تغيير في التصورات العربية للتعددية الثقافية والأقليات، وهو ما انعكس في المراجعات الأخيرة للميثاق العربي لحقوق الإنسان. وعلى الرغم من قصوره النظري ونقائصه العملية، قد يُثبت الميثاق العربي لحقوق الإنسان المُنقّح أنه نقطة انطلاق مفيدة لسد هذه الفجوة. يتضمن الميثاق عدة أحكام تتعلق بالتعددية الثقافية وحقوق الأقليات، والتي من شأنها أن تُوجّه نحو اتجاه أكثر مراعاةً للتنوع. العالمين العربي والإسلامي يضع الباحث التركي في السياسة المقارنة “شينر أكتورك” Şener Aktürk الدول العربية في فئة “معادية للعرق” في دراسته “أنظمة العرق: مقارنة بين الشرق والغرب والجنوب” Racial Systems: Comparing East, West, and South يدرس تحليله الدول بحثاً عن وجود خمس عشرة سياسة مميزة للاعتراف العرقي، بدءًا من استخدام الفئات العرقية في التعداد السكاني، ومرورًا بحقوق الأقليات اللغوية، ووصولًا إلى الحكم الذاتي الإقليمي. من المهم هنا عدم الخلط بين العالم العربي والعالم الإسلامي. يبدو أن العديد من الدول الإسلامية خارج المنطقة العربية تتبع التوجهات العالمية العامة نحو التعددية الثقافية. لنأخذ إندونيسيا أو ماليزيا، بما لديهما من أنظمة معقدة لحقوق الأقليات والسكان الأصليين. هناك بالفعل أدبيات ثرية حول التعددية الثقافية في المجتمعات ذات الأغلبية المسلمة خارج العالم العربي، وخاصة في تلك الدولتين وشبه القارة الهندية. يوجد عدة دراسات وجميعها تتناول بعض القضايا النظرية والمعيارية الأساسية المتعلقة بآفاق المواطنة متعددة الثقافات في هذه البلدان. يشير هذا إلى أن مصاعب التعددية الثقافية في العالم العربي لا تتعلق بالإسلام في حد ذاته، بل تتعلق بخصائص الإرث العثماني والاستعماري، وبالجيوسياسية الإقليمية الحالية. وقد أثيرت قضايا مماثلة في الجدل المعروف حول “الاستثناء الإسلامي” مقابل “الاستثناء العربي” فيما يتعلق بالديمقراطية. أعتقد أن مصاعب الديمقراطية في العالم العربي لا يمكن تفسيرها من خلال الإسلام، بالنظر إلى النجاح النسبي للديمقراطية في الدول ذات الأغلبية المسلمة خارج نطاق الإسلام. يجب تجنب فكرة أن الشرق الأوسط استثناء من حيث عدد أو معاملة أو حساسية أقلياته. في الواقع، إذا نظرنا إلى الأمر من خلال عدسة أوسع، فبدلاً من النظر إلى العالم العربي كاستثناء من الاستقبال الإيجابي عموماً والآثار التحويلية لسياسات التعددية الثقافية في معظم مناطق العالم، قد نرى أمريكا اللاتينية كاستثناء من رد الفعل العدائي عموماً والآثار المتناقضة للتعددية الثقافية، والسياسات التقليدية في معظم المناطق. كما أن تبني هذا المنظور الأوسع يُساعد على تجنب الادعاءات الحتمية المفرطة بشأن آفاق التعددية الثقافية. في حين أن مقاومة حقوق الأقليات والسكان الأصليين منتشرة على نطاق واسع في عالم ما بعد الاستعمار، فمن الواضح أن الدول قادرة على التغلب على هذه الموروثات. فالتاريخ ليس قدراً محتوماً، وهناك اختلافات صارخة حتى بين الدول المتجاورة ذات التركيبة السكانية والإرث التاريخي المتشابه. نحن بعيدون جداً عن معرفة الشروط اللازمة أو الكافية لاعتماد حقوق الأقليات والسكان الأصليين. كما أننا لا نملك نظريات راسخة حول متى ستصبح هذه الحقوق فعّالة عملياً، أو مُحدثة تحولاً في تأثيرها. يرى بعض الباحثين أن صعود سياسات “السكان الأصليين” في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى قد عزز سياسات غير ديمقراطية وإقصائية، بل وعنيفة. بدلاً من بناء علاقات مواطنة ديمقراطية أكثر شمولاً وسلمية كما هو الحال في أمريكا اللاتينية. لذا، يجب أن نرفض رفضاً قاطعاً كلاً من الاستثنائية والقدرية فيما يتعلق بسياسات الأقليات في العالم العربي. بدلاً من محاولة تحديد بعض الاستثنائية العربية المزعومة أو بعض ردود الفعل العربية المحددة مسبقاً لمطالبات الأقليات، من المهم دراسة العالم العربي كسياق مهم لاستكشاف ما هي في الواقع أسئلة عالمية حقيقية حول آفاق التعددية الثقافية. ما هي الظروف التي يمكننا في ظلها تصور جدلية داعمة متبادلة لبناء الأمة وحقوق الأقليات؟ في ظل أي ظروف يمكن أن يكون للنضال من أجل حقوق الأقليات تأثير تحويلي؟ في أي ظروف يمكن للمعايير الدولية أن تلعب دوراً بنّاءً في هذه العملية؟ إذا كانت هذه الأسئلة صعبة وغير محسومة في العالم العربي، للأسباب التي نوقشت سابقاً، فهي أبعد ما تكون عن السهولة أو الحل في أي منطقة أخرى. لقد عرّف نظام الملل العثماني الأقليات على أسس دينية، وهناك بالفعل أدبيات واسعة حول وضع المسيحيين واليهود كأقليات محمية في العالمين العربي والإسلامي. مع أن إرث الملل العثمانية ذو أهمية حاسمة لموضوعنا، إلا أنني لا أريد التكرار، فقد تناولت موضوع الملة في مقالة سابقة عن الأقليات. بل أريد التركيز على كيفية تصور التنوع العرقي والقومي ومناقشته في العالم العربي، وكيفية ارتباط ذلك بالخطابات العالمية الناشئة حول حقوق الأقليات والسكان الأصليين. تركز هذه الخطابات العالمية الجديدة بشكل أقل على الجماعات الدينية، وأكثر على جماعات مثل الأكراد في العراق أو سوريا، والأمازيغ في الجزائر، والجنوبيين في السودان. كما لا يرغب الفلسطينيون في إسرائيل أو العرب في إيران في أن يُنظر إليهم كأقلية دينية فحسب، بل كجماعة وطنية متميزة أو شعب أصلي (مع ما يرتبط بذلك من مطالبات بالأرض والحكم الذاتي وحقوق لغوية، وما إلى ذلك)، فكذلك تطالب مجموعات مختلفة داخل الدول العربية ليس فقط بالتوافق الديني، بل أيضاً بوضع الأقلية الوطنية أو السكان الأصليين. وتواجه مجموعات عرقية أخرى تمييزاً طبقياً (مثل الأخدام في اليمن) أو إقصاءً (مثل العمال المهاجرين في الخليج). تُمثل هذه الأنواع من المجموعات العرقية والوطنية المحور الرئيسي للخطابات الدولية الحديثة حول حقوق الأقليات والسكان الأصليين، إلا أن أهمية هذه المعايير الدولية أو ملاءمتها للعالم العربي لا تزال غير مدروسة إلى حد كبير. مصطلح العالم العربي يجب علينا أيضًا توضيح مصطلح “العالم العربي”. في المقام الأول، نستخدم هذا المصطلح بمعناه الجغرافي التقليدي للإشارة إلى الدول ذات الأغلبية العربية، وجميعها أعضاء في جامعة الدول العربية. (تضم الجامعة أيضاً بعض الدول مثل جزر القمر وجيبوتي وموريتانيا والصومال حيث اللغة العربية لغة رسمية وليست لغة أغلبية، ولكن تركيزنا ينصب على الدول ذات الأغلبية العربية). ومع ذلك، فإن هذه الحالة تشمل الأقليات العربية في الدول المجاورة، مثل إسرائيل. فلهذه الأقليات العربية طرقها المميزة في ربط تقاليدها العربية/الإسلامية وواقعها المحلي بخطابات ومؤسسات أكثر عالمية. كما نُجري مقارنات ذات صلة مع الدول المجاورة: على سبيل المثال، مقارنة طريقة النظر إلى الأكراد في الدول ذات الأغلبية العربية (مثل سوريا والعراق) بمعاملتهم في إيران أو تركيا. تساعد هذه المقارنات في تسليط الضوء على ما يميز قضايا الأقليات في الدول ذات الأغلبية العربية (إن وُجد). نظام الملل تركً إرثًا باقٍ لا يزال قائماً حتى يومنا هذا يؤثر على الوحدة الوطنية. عند تناول قضية حقوق الأقليات اليوم، من الضروري فهم هذه الخلفية لتجنب الاستراتيجيات – بما في ذلك الاستراتيجيات الدولية حسنة النية – التي ستُعزز ببساطة مكانتهم كمواطنين مُميزين. علينا أن نعلم كيف تُعقّد أعباء التاريخ جهود معالجة قضية الأقليات، والتأكيد على المساهمات الإيجابية المُحتملة التي يُمكن أن يُقدّمها إرث نظام المِلّ. وأنّ هذا الإرث ّ يحمل دروساً مهمة ليس فقط لحماية الأقليات، ولكن أيضاً لبناء هوية وطنية أكثر شمولاً، ومؤسسات عامة أكثر تمثيلاً. إنّ المعايير الدولية للأقليات وحقوق الإنسان، إذا فُسّر تفسيراً مناسباً، يُمكن أن تلعب دوراً بنّاءً في بناء جدلية إيجابية لبناء الأمة وحقوق الأقليات. نؤكد على أهمية التعددية الثقافية الليبرالية للأقليات في العالم العربي. إذا أُريد للتعددية الثقافية الليبرالية أن تكون ذات صلة ومفيدة، فيجب إعادة صياغة العلاقة بين الليبرالية والتعددية الثقافية لتوضيح أن الليبرالية تسبق التعددية الثقافية، وأن ترسيخ البنية الأساسية للديمقراطية الليبرالية يسبق السعي إلى نسخة متعددة الثقافات منها تحديداً. إن الحفاظ على هذه الأولوية أمرٌ أساسي، ليس فقط للعالم العربي، بل أيضاً في الغرب. فإذا لم تتمكن التعددية الثقافية في العالم العربي من ترسيخ جذورها إلا بعد إرساء حد أدنى من الديمقراطية الليبرالية، فمن الصحيح أيضاً أن التعددية الثقافية في الغرب تواجه ردود فعل عنيفة وتراجعاً عندما يُنظر إليها على أنها تبتعد عن المبادئ الليبرالية الأساسية. وبشكل أعم، تُعدّ الديمقراطية الليبرالية شرطاً أساسياً لتعددية ثقافية مستدامة. تغير مناهج دراسة العرقية تتطلب دراسة أي أقلية تحليل بنية مجتمع بأكمله: إما أن تُعرّف الأقلية على هذا النحو في علاقتها بالأغلبية، أو أن المجتمع ككل يتكون من مجموعة من الأقليات. وتتنوع الأقليات بقدر ما تتنوع الانقسامات في أي مجتمع، على سبيل المثال، الرجال والنساء، كبار السن والشباب، المتعلمون والمتعلمات، العاملون والعاطلون عن العمل، وهكذا. ومع ذلك، فإن المحور الأكثر أهمية الذي يفصل الأقليات عن غيرها في المجتمع الحديث هو المحور الإثني، وبالتالي فإن الأداة الأساسية لدراسة الأقليات هي تاريخ الإثنية وعلم اجتماعها السياسي. وهناك أدبيات وافرة حول هذه القضية، مقسمة إلى عدة مدارس ومناهج رئيسية متنافسة. هناك ثلاثة مناهج رئيسية لدراسة العرقية: القومية العرقية، والإقليمية العرقية، والدين العرقي. تتناول القومية العرقية محاولات الجماعات العرقية لإيجاد تعبير إقليمي على مستوى الدولة بأكملها، يُفترض أنه يتوافق مع احتياجات الأمة وحقوقها. تتحدى الإقليمية العرقية سلطات الدولة القومية من خلال المطالبة باستقلالية محلية-إقليمية أكبر للجماعات العرقية، أو حتى التطلع إلى شكل من أشكال الاستقلال في المستقبل البعيد. وتفترض الإثنية الدينية تداخل الوعي الديني مع بعض الخصائص الأخرى للعرقية – الأصل المشترك، أو الثقافة، أو اللغة – مما ينتج عنه شكل من أشكال النشاط العرقي الذي قد يكون أو لا يكون ذو توجه إقليمي، ولكنه ذو أهمية سياسية. من الواضح أن بعض هذه الأشكال العرقية قد تتداخل وتعزز بعضها البعض. ومع ذلك، ينبغي إدراك أن أسس الوعي السياسي والنشاط في العلاقات العرقية لا تخضع فقط لتفسيرات مختلفة من مختلف المشاركين في العملية السياسية، بل تتغير أيضاً بمرور الوقت. بعبارة أخرى، تُعدّ هيكلة العرقية عملية بالغة التعقيد، ديناميكية وذاتية. لذا، فإن السؤال الحاسم هو كيف ولماذا تصبح العرقية حقيقة سياسية من حقائق الحياة؟ تُقدّم ثلاث مدارس فكرية رئيسية إجابات مختلفة على هذا السؤال. أولاً: النهجان الاقتصادي والعقلاني ينبع هذان النهجان من عصور سابقة عبر النظريات الماركسية، التي عُدّلت لاحقاً بنهج إ”ميل دوركهايم” الاجتماعي. الفكرة الأساسية هي أن عملية التنمية الاقتصادية تُنشئ مجتمعات أكبر على حساب المجتمعات الأصغر، وأن دمج الوحدات الأصغر والأكثر تميزاً في إطار مجتمعي أوسع وأشمل أمر لا مفر منه مع تحول الاقتصاد الرأسمالي الحديث إلى حقيقة سائدة في المجتمعين الوطني والدولي. ويمكن إيجاد تنويعة جديدة على هذه المواضيع في نهج الاختيار العقلاني السائد في السنوات الأخيرة. ثانياً: نهج التحديث يفترض هؤلاء أن عملية التحديث، كما عُرِّفت عادةً في ستينيات وأوائل سبعينيات القرن الماضي، تُنشئ فعلياً كيانات جديدة من خلال توسيع نطاق الاتصالات، وانتشار محو الأمية والتعليم، وإدخال التكنولوجيا الحديثة، وتداخل فكرة المشاركة الجماهيرية في العملية السياسية. افترضت الأشكال المبكرة لنظرية التحديث أن إنشاء مثل هذه الكيانات الجديدة من شأنه أيضاً أن يخلق دولاً جديدة يمكنها التغلب على هوياتها ما قبل الحديثة، تماماً كما افترض “كارل ماركس” و”دوركهايم”. ومع ذلك، فإن الأشكال اللاحقة والأكثر تطوراً لنظرية التحديث – ما يمكن أن نسميه نهج التحديث-الصراعي – أشارت إلى احتمالات معاكسة، تُعتبر أكثر ترجيحاً. حيث جادل هؤلاء الباحثون بأن عملية التحديث ولّدت الصراع العرقي وفاقمت منه من خلال تغيير أسس المجتمع الأكثر تقليدية، وخلط قضايا الشرعية، وإدخال موارد جديدة إلى ساحة المنافسة السياسية. وفقاً لهذه الطريقة في التفكير، فإن شكوك عملية التغيير الهائلة والمتعددة تُثير هروباً نحو العرقية كشكل من أشكال الاطمئنان والأمان من مخاطر الحداثة وخطرها. إضافةً إلى ذلك، فإن النخب المهددة بفقدان الوصول إلى الموارد في ساحة تهيمن عليها أشكال من المنافسة تجدها غير مألوفة، وبالتالي يصعب السيطرة عليها أو التلاعب بها، تميل إلى إحياء المشاعر العرقية والتضامن بهدف تحويلها إلى موارد سياسية حيوية. وهكذا، قد يحاول القادة السياسيون الذين يجدون صعوبة في التكيف مع أسلوب أيديولوجي للسياسة الحزبية إنشاء أحزاب قبلية وعرقية لمواجهة التأثير الأيديولوجي وشرعية منافسيهم. فهم يزرعون حتماً مشاعر الفخر والتضامن والهوية في الجماعة العرقية التي يستخدمونها، حتى لو كانت هذه المشاعر كامنة منذ زمن طويل. وعندما تشعر مجموعات أوسع بالحرمان بسبب إعادة توزيع الموارد الاقتصادية وغيرها في ظل التحديث، فقد يلجأون أيضاً إلى الهوية العرقية كمصدر قوة. ثالثاً: المناهج العرقية البدائية أو الأصيلة تفترض هذه المناهج أن للجماعات العرقية وجوداً أصيلاً خاصاً بها، وليست مجرد خيالات يستغلها القادة والسياسيون أو يستغلونها. هذا التلاعب ممكن بالفعل، ولكن فقط عندما يكون هناك أساس موضوعي قوي لوجود هذه الجماعة، والذي يمكن إحياؤه أو استخدامه في العملية السياسية. تؤكد التنويعات الأحدث في هذا الموضوع على ديناميكيات التطور المتضمنة في السياسة العرقية. على الرغم من احتمال وجود أساس موضوعي للعرقية، إلا أن الجماعات العرقية نفسها تتشكل وتُعاد صياغتها باستمرار. عند تحديد الحدود السياسية لآسيا وأفريقيا، على سبيل المثال، أعادت القوى الاستعمارية تعريف حجم الجماعات العرقية ونطاقها. أدى توسيع الحدود السياسية إلى استيعاب الجماعات العرقية وتمايزها: فمع اختفاء الجماعات القديمة، ظهرت جماعات جديدة، بينما اندمجت جماعات أخرى وانفصلت ببساطة. لا بد أن يتناول النهج العرقي الأصيل علاقة الإثنية بالبنية الطبقية، وهو سؤالٌ مثيرٌ للاهتمام يعود إلى أيام المدرسة الماركسية. يرى أستاذ العلوم السياسية الأمريكي “دونالد هورويتز” Donald Horowitz أن للهوية العرقية سمةً فريدة. “بينما يستطيع الأفراد تجاوز طبقتهم الاجتماعية، وبينما يُمكن الحراك الاجتماعي من جيل إلى جيل، فإن الروابط العرقية نسبية. فإذا وُلد المرء في جماعة عرقية، فليكن؛ فلا يمكنه الخروج من هويته العرقية.” من أهمّ حجج هذا النهج أن الإثنية مفهومٌ مقارنٌ بالفعل. أي أن الجماعات العرقية تُعرّف حتماً بعلاقتها بالآخرين بقدر ما تُعرّف بإدراكها لأيّ خصائص موضوعية. هناك جدلٌ كبيرٌ حول تداعيات هذه الأطروحة، ومع ذلك، لا يوجد جدلٌ يُذكر حول ضرورة إشراك فهم الإثنية في العلاقة النفسية بين الجماعات بشكلٍ بارز. وكما ذُكر سابقًا، فإن دراسة الأقليات والإثنية هي بالضرورة دراسةٌ للعلاقات بين الأغلبية والأقلية، وبين الأقلية والأقلية. التداعيات والاعتبارات النظرية والمقارنة في محاولةٍ لتقييم التداعيات النظرية للتحليل المقارن الأولي، يبدو من الآمن القول إن هناك نموذجاً للأقليات المدمجة، وأن لهذا النموذج خصائصه التي تجعله الأكثر وضوحاً. ثم هناك نموذج الأقليات شبه المدمجة، مثل الأكراد، حيث كان الوضع مختلفاً، على الرغم من وجود قدرٍ كبيرٍ من الإمكانات نفسها. النموذج المعاكس للأقليات غير المدمجة أو المشتتة والمنتشرة، مثل المسيحيين الأرثوذكس (أو اليهود في العصور السابقة)، يقع في الطرف الآخر من الطيف، وهناك حالة الأقباط بينهما، قريبة من النموذج المنتشر، ولكنها ليست مطابقة له، نظراً لأعدادهم الأكبر وتركزاتهم الديموغرافية الجزئية. لذا، لدينا طرفان مختلفان من الاستمرارية النظرية – المدمجة من جهة والمنتشرة من جهة أخرى – وبينهما شيء مثل شبه المدمجة وشبه المنتشرة. قد تكون هذه طريقة مناسبة لتصنيفها لأغراض التحليل والمقارنة. يجب أيضاً مراعاة متغيرات أخرى، بما في ذلك تعريف الأغلبية، لفهم ماهية الأقلية بشكل أفضل. فإن تعريف الأغلبية ليس دائمًا ثابتاً، بل يعتمد على الهوية الذاتية للمجتمع السياسي في لحظة معينة من التاريخ. لقد لاحظ عدد من الباحثين أن الهوية العرقية قابلة للتغيير والتلاعب. في تحليله للسياسة العراقية قبل سنوات عديدة، صاغ الحاكم العسكري البريطاني للعراق في ثلاثينيات القرن الماضي “ستيفن هيمسلي لونغريغ” Stephen Hemsley Longrigg في كتابه “أربعة قرون من العراق الحديث” Four Centuries of Modern Iraq العبارة التالية: “أكراد لأغراض وزارية”. يمكن لأي شخص أن يكتشف هويته كأقلية تحت ضغط العمليات السياسية، ويمكن لشخص آخر أن ينكر هذه الهوية لأسباب عديدة. إضافةً إلى ذلك، يمكن للمرء أن ينتمي، بل وينتمي بالفعل، إلى عدد من الكيانات العرقية وغيرها من الكيانات “الأصلية” في الوقت نفسه، مما يُظهر ما يُطلق عليه علماء الاجتماع السياسي “الانقسامات المتقاطعة”. يمكن للمرء أن يكون عضواً في الأغلبية والأقلية في الوقت نفسه، أو عضواً في عدة أقليات. يمكن أن تكون نتائج هذا الانتماء المتعدد ذات أشكال مختلفة. كانت النظرية الكلاسيكية في الغرب ترى أن الانقسامات المتقاطعة مفيدة للمجتمع أساساً لأنها تُحسّن من بعضها البعض، وبالتالي تُرسي أسس مجتمع أكثر تعددية تتعايش فيه عناصر ومبادئ تنافسية مختلفة. وقد تعرضت هذه النظرية للطعن مؤخراً في الغرب، وبالتأكيد لا يوجد دليل يُذكر يدعمها في الشرق الأوسط. سيُسارع المحللون إلى إضافة مُتغير آخر، يُشار إليه عادةً بمستوى المأسسة. تُجادل هذه النظرية بأن أسلوب بناء المؤسسات (الأحزاب، والنقابات، والأندية، والعمليات الانتخابية، ومجموعة مُتنوعة من المنظمات الرسمية) يُحدث فرقاً بالغ الأهمية في الحظوظ السياسية لأي بلد، لأن المأسسة وحدها هي التي تُمكّن النظام السياسي المُستقر من العمل بطريقة مُنظمة، بمعزل عن تقلبات التنافس النسبي على الموارد. عند ولادة هذا النهج النظري، في أواخر ستينيات القرن الماضي، كرر كبار كهنته مراراً وتكراراً أن الشرق الأوسط يتميز عموماً بانخفاض مستوى المأسسة، مما يعني أن هناك عدداً قليلاً من الكيانات السياسية التي صمدت بفضل قوتها الذاتية بدلاً من انغماسها في الانتماءات والولاءات العرقية والقبلية. لا تزال هذه النظرية قوية، وإن كانت أقل شيوعاً اليوم، ولها تأثير مُباشر على مسألة الأقليات في الشرق الأوسط. أولاً: تكتسب هوية الأقلية أهمية أكبر في المُجتمعات التي تقل فيها المؤسسات المُعقدة والمستقرة، وذلك ببساطة لأن أساس الحياة السياسية والمُنافسة يكون أكثر محدودية. يساعد هذا أيضاً على تفسير سبب ميل القضايا العرقية في مثل هذه المجتمعات إلى أن تكون أكثر حساسية وتؤدي إلى مزيد من العنف. ثانياً: تقلّ الموارد والقدرات التي يمتلكها المجتمع المعني في محاولة معالجة علاقات الأغلبية بالأقلية عندما تكون المؤسسات السياسية ضعيفة، وذلك بسبب نقص الآليات التكاملية وحتى الساحات المحايدة التي يمكن أن تلتقي فيها الهويات والكيانات العرقية المختلفة على أسس مقبولة بشكل متبادل. يؤدي هذا النقص بدوره إلى الشك وعدم الثقة في المؤسسات القائمة، التي يُنظر إليها على أنها أسيرة مصالح عرقية متنافسة، مما يقلل من قدرتها على صياغة السياسات. وعلاقات تشمل مجموعة متنوعة من المصالح والولاءات. ثالثاً: ستشعر الأقليات بأنها لا تستطيع حماية مصالحها إلا بإنشاء مؤسسات خاصة بها أو الاستيلاء على المؤسسات القائمة، مما يجعلها موضع شك في نظر الأغلبية. كل هذه العوامل تؤدي إلى حياة سياسية شديدة التقلب، حيث يغيب التأثير المستقر للمؤسسات السياسية الدائمة، مما يؤدي إلى نتائج مُنهكة للبلاد. المؤسسة القوية الوحيدة القائمة هي الدولة، فتصبح محوراً للمنافسة العنيفة باعتبارها الكائن المؤسسي الوحيد الذي يستحق الاستيلاء عليه. بتحليل بعض هذه الملاحظات النظرية في السياق الملموس لسياسة الشرق الأوسط، يبدو أنه نظراً لقلة المؤسسات وبؤر الولاء البديلة في المنطقة، فقد استمر الصراع العرقي بين الأغلبية والأقليات لفترة أطول، مع احتمالية أكبر للتقلب من أي مكان آخر، ويمكن، بل ينبغي، فهم هذا الأمر بشكل صحيح في ضوء الإسلام والسياسة. اهتمامات نظرية إضافية تُعد العلاقة بين الأقليات والدولة من السمات المهمة لدراسة العرق في الشرق الأوسط. ونظراً للتأخر النسبي في نشوء الدول في المنطقة وصعوبة مأسستها في مواجهة تحديات داخلية متعددة، فإن الواقع العرقي للحياة يُصبح أكثر إلحاحاً في دولة الشرق الأوسط الحديثة. فعندما تتداخل السياسات العرقية للأقليات مع الهويات الطائفية والدينية (أحياناً داخل إقليم معين داخل الدولة)، يمكن أن تُصبح الجماعات العرقية والأقليات مصدر إزعاج بالغ. ويصدق هذا بشكل خاص في الدول التي لا يترك فيها التنوع الجديد نسبياً في القومية مجالاً كافياً للاعتراف بوجود الأقليات، التي يُنظر إليها على أنها تُشكل تحدياً لسلطة الدولة ليس فقط من خلال ما تفعله، بل أيضاً بحكم ماهيتها. على الرغم من أن دولة الشرق الأوسط قد نجت بشكل مثير للإعجاب، إلا أنها في بيئة قاسية وغير مضيافة، إلا أنها بعيدة كل البعد عن الأمان. يُشكّل الظهور الأخير للنشاط الإسلامي المتطرف، إلى جانب تنامي الوعي العرقي، تهديداً جديداً وقوياً لشرعية الدولة واستمراريتها. ومع ذلك، فقد أظهرت هذه الدول، حتى الآن، درجة عالية من العزيمة والمهارة في احتواء هذا التهديد القوي. بل إن ردود الفعل على التحديات الأخيرة تُشير مجدداً إلى مأسسة الدولة الشرق أوسطية كحقيقة مؤثرة للغاية في التاريخ السياسي المعاصر للمنطقة. تُشكّل المواجهة بين الدولة والتحديات العرقية الجديدة أحد أكثر مجالات الدراسة إثارة للاهتمام في سياسات الشرق الأوسط المعاصرة. ويسعى الباحثون إلى التأكيد على مفهوم الاستراتيجيات التي طورتها واعتمدتها سلطات الدولة تجاه الأقليات، والاستراتيجيات التي تستخدمها الأقليات تجاه الأنظمة والدول. ورغم أنه لا يزال من السابق لأوانه محاولة تصنيف هذه الاستراتيجيات تصنيفاً منهجياً، فإن مساهمات هؤلاء الباحثين تُسهم في إرساء أسس هذه المحاولة النظرية. بشكل عام، لا توجد سوى دراسات حالة قليلة في الشرق الأوسط تُشكّل جوهراً معرفياً مقبولاً، استناداً إلى مادة تاريخية مُفصّلة وأسس علمية اجتماعية سليمة. إن الدراسات التاريخية تعاني من ثغرات خطيرة. مهما كانت قيمة هذه الدراسات كتاريخ سياسي، فإنها نادراً ما تتناول مسألة الهويات الوطنية والإقليمية باعتبارها متوافقة لا متعارضة. علاوة على ذلك، لا يتناول أي من هذه الأعمال نظريات القومية أو الموضوعات ذات الصلة بتكوين الدولة والأدبيات التاريخية والاجتماعية المتعلقة بها، إلا ما ندر. ومع ذلك، ربما يُخطئ علماء الاجتماع أيضاً فيما يتعلق بالعلوم الاجتماعية، يبدو أن المتخصصين في هذه القضايا يشيرون إلى الأدبيات النظرية في مجلات تخصصاتهم بشكل أكثر تواتراً مقارنةً بدراساتهم لمواضيع مماثلة في مقالات أو كتب مخصصة لمواضيع الشرق الأوسط تحديداً. بعبارة أخرى، لا يستخدم المؤرخون مفاهيم العلوم الاجتماعية بشكل كافٍ، ولا يستخدم علماء الاجتماع ما يكفي من المعرفة الملموسة المكتسبة من تاريخ الشرق الأوسط. ليس من الممكن ولا المرغوب فيه إجبار المؤرخين على كتابة علوم اجتماعية مشكوك فيها، أو إجبار علماء الاجتماع على كتابة تاريخ مشكوك فيه بنفس القدر. بدلاً من ذلك يجب إنتاج هذه الدراسات على مراحل تشمل ورشات عمل يقدم فيها متخصصون في تاريخ البلدان أوراقاً بحثية حول الحالات المختلفة. مركزية الدولة والعلاقات بين الدولة والأقليات العدد الهائل من الاستراتيجيات التي يتبعها كلا الجانبين استجابةً للقيود. الافتراض الأساسي بأنه في حين أن التلاعب بالهويات أمرٌ واقع، إلا أن هناك أيضاً شكلاً من أشكال العرقية الأصيلة، وهو تنويع على النهج الثالث لدراسة العرقية الموصوف سابقاً. أهمية تداخل (أو انعدام) الخصائص العرقية للأقلية: السمات القومية، والوعي الديني، والثقافة المشتركة. وحساسية الأنظمة السياسية في الشرق الأوسط للتحديات الإقليمية المحتملة، ومن هنا تأتي أهمية التمييز بين الأقليات المدمجة مقابل الأقليات المنتشرة. أهمية التوقيت. لا نعرف سوى القليل نسبياً عن النقطة في الديناميكيات السياسية لكل بلد التي تشهد ارتفاعاً هائلاً في الوعي والميل إلى النشاط الجماعي. سياسات البدائية يُركز النهج العرقي الأصيل لدراسة السياسات العرقية على كل من ديناميكيات التغيير في الهوية والوعي العرقيين، والمتغيرات الموضوعية إلى حد ما التي تُحدد الأغلبية والأقليات، والتي تميل إلى الاستمرار مع مرور الوقت. يتعلق الأمر أيضاً بطبيعة السياسة في المجتمع المعني. ليس كل انقسام محتمل في المجتمع يُسيّس، ولكن في بعض الأحيان يحدث هذا التحول بسرعة هائلة. إحدى الطرق المؤثرة لمعالجة هذه القضية هي من خلال الصيغة الكلاسيكية للبدائية، التي كانت موجودة منذ ستينيات القرن الماضي وتشهد الآن انتعاشاً، بسبب الابتعاد عن كل من نظريات التحديث البسيطة والتعقيدات التي تنطوي عليها المناهج الاقتصادية. النهج النظري للبدائية غني وعميق؛ وهو يستحق بجدارة مكانة مركزية في دراسة الأقليات والعرق. اقترح عالم الأنثروبولوجيا السياسية البارز “كليفورد غيرتز” Clifford Geertz الصيغة الأصلية في مقال نُشر عام 1963. جادل “غيرتز” بأهمية الروابط البدائية، تلك الروابط التي يولد بها المرء. في ذلك الوقت، كان التصرف وفقاً لهذه الهوية الموروثة يُعتبر أقل حداثة من المعايير العقلانية والعلمانية والنسبية للمجتمع المتقدم. لقد تم التخلي إلى حد كبير عن هذا النهج العرقي المركزي والتبسيطي؛ فقد أثبتت البدائية أهميتها البالغة في جميع المجتمعات، ولا يوجد دليل على قوتها بشكل خاص في أي جزء من العالم. أصبحت عالمية البدائية مقبولة بشكل عام الآن. ويبدو أنها في أوج قوتها في أوروبا الشرقية مع الفراغ الاجتماعي والسياسي الذي نتج عن انهيار المؤسسات القديمة والمجتمعات السياسية بسبب الموجة الثورية في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات. قدم “غيرتز” أمثلة مختلفة على معنى الروابط البدائية: روابط قائمة على الدم، والقرابة، والدين، والعشائر، والتقارب التاريخي المفترض، وما إلى ذلك. على الرغم من أن بعضها يبدو متداخلاً، ويبدو الكثير منها خيالياً فحسب، فإن هذا لا يعني أنها أقل واقعية، لأن الأفكار في أذهان جماعات الناس هي حقائق سياسية من حقائق الحياة، وهي بنفس قوة أي عوامل موضوعية. ومع ذلك، يصعب التعامل مع الهويات البدائية لأنها قابلة للتغير بسرعة كبيرة وقد تظهر بأشكال مفاجئة. وقد حدثت هذه التحولات في مجتمعات تشهد تغيراً سريعاً، مما أدى إلى انعدام الأمن، وبالتالي تشجيع الناس على العودة إلى قوقعتهم الآمنة نسبياً على حساب المجتمعات السياسية الأكبر. الروابط البدائية سهلة الفهم، وتبدو دائمة وجديرة بالثقة. على النقيض من ذلك، يصعب التعايش مع المجتمعات السياسية الأكبر، لأنها تتطلب بعض التكيف مع الأفكار والخصائص المشتركة التي تبدو مصطنعة. التباين في الصعوبة مفهوم بسهولة. تختلف الروابط البدائية في شدتها. وبالتالي، قد تهدد بتفتيت الدولة إما بمحاولة إجبارها على الانخراط في مجتمعات سياسية أكبر أو بتفتيتها إلى مجتمعات أصغر. في كلتا الحالتين، تهدد شرعية هياكل الدولة القائمة، وهذه هي أهميتها الجوهرية للسياسة المعاصرة. في ضوء القيود السياسية، نادراً ما تُنشئ الحركات القائمة على الروابط الأصيلة دولاً خاصة بها، وعندما تفعل ذلك، لا يُمكنها النجاح لأنها عملياً لا تخلو أبداً من الأقليات التابعة لها. لذلك، لا توجد أمثلة حقيقية على دول عرقية في الشرق الأوسط، ومن غير المرجح أن يكون لدينا أي منها في المستقبل أيضًا. ومن المثير للاهتمام أن حتى تلك الجماعات العرقية التي يُشار إليها في الأدبيات باسم “الأقليات المدمجة” لا تدّعي تأسيس دول خاصة بها. بل على العكس، تبدو هذه الأقليات الأكثر ولاءً للدول الوطنية القائمة التي ترغب في النجاح فيها، بل وتمتلك حصة كبيرة من السلطة الكامنة في آلية الدولة. ماذا نستخلص؟ من الواضح أن هناك أنواعاً مختلفة من أوضاع الأقليات. هناك بلد لا توجد فيه أغلبية، بل أقليات فقط هو لبنان. توجد أغلبية كبيرة، ذات وضع أقليات واضح، في مصر. في سوريا، توجد أقلية إلى جانب أغلبية واضحة، على الرغم من أن الأغلبية لا تسيطر على المركز السياسي. تهيمن أقلية على الأغلبية، وأقلية كبيرة أخرى في العراق. في شبه الجزيرة العربية، تهيمن أغلبية واضحة، ولكن هناك أيضاً وجود كبير للعمال الأجانب إلى جانب أقليات إسلامية داخلية قوية. لدينا حالة السودان، حيث يوجد انقسام حاد بين شمال عربي مسلم وجنوب غير مسلم وغير عربي. في جميع أنحاء الشرق الأوسط، تندرج الحالات تقريباً ضمن أحد هذين النمطين. لا يمكننا حالياً التعميم بشأن جميع هذه الحالات. على سبيل المثال، لا يمكننا تحديد ما إذا كان أحد الأنماط أكثر ملاءمةً للتوافق بين الجماعات من نمط آخر، أو ما إذا كان أحد الأنماط أكثر عرضة للتنافس العنيف. ولكن يمكننا القول إن هذه الأنماط ليست خاصة بالشرق الأوسط بحد ذاته، إذ يمكن العثور عليها في أماكن أخرى من العالم. من المنطقي افتراض أن أغلبية كبيرة واحدة قادرة على التمتع بحكم أكثر استقراراً من أغلبيات أصغر، ومن المنطقي أيضاً افتراض أن الأقليات المتعددة أصعب على الأغلبية في التعامل معها من أقلية واحدة. تُشكل الأقليات المنتشرة، كقاعدة عامة، تهديداً سياسياً أقل للأغلبية من الأقليات المدمجة ذات القاعدة الإقليمية؛ في الواقع، تُعد هذه الملاحظة إحدى النقاط التي تستحق التوسع فيها لاحقاً. يبدو أن الأرض والإقليم يُحدثان فرقًا كبيراً في تأثير الجماعات العرقية في الشرق الأوسط، ويبقى أن نرى مدى صحة هذا الأمر. وقد لوحظت مؤخراً أهمية القاعدة الإقليمية في الكيانات الجديدة الناشئة من أنقاض الاتحادين السابقين ليوغوسلافيا والاتحاد السوفيتي. وتوجد أمثلة أخرى في حالات معروفة للصراعات العرقية في أفريقيا وآسيا، من زائير إلى كمبوديا. ويبدو أن أحد القاسم المشترك بين هذه الحالات هو البعد الإقليمي الذي يُحوّل الأقلية المفترضة إلى قوة عرقية ملموسة. يجب دراسة الأنماط السياسية الوطنية في مقابل أنماط وضع الأقليات. لقد رأينا أن الشرق الأوسط يضم أقليات متماسكة ونقيضها، الأقليات المنتشرة (العلويون على عكس المسيحيين الأرثوذكس اليونانيين، على سبيل المثال)، كما يُظهر تمييزات عرقية مقابل تمييزات دينية: ونعني بالتمييز الديني التمييز بين الإسلام وسائر الأديان. ومع ذلك، هناك بُعد آخر، وهو الفرق بين أصناف الإسلام التي تُعدّ مهمة بما يكفي لجعل الجماعات المعنية تُعادل الأغلبية والأقليات. هنا أيضاً يصعب وضع النظريات. على سبيل المثال، يمكننا النظر في فرضية مفادها أن الأقليات الإسلامية الداخلية من المرجح أن تكتسب أهمية أكبر في المستقبل المنظور نظراً لشرعيتها التي ستكون أعلى من شرعية الجماعات الأخرى. قد يتحسن وضع الأكراد في العراق، كما لو كان ذلك تشبيهاً للوضع الاستعماري السابق في دول أخرى، حيث كانت القوى الاستعمارية تفضل الأقليات المدمجة. قد يكون الدعم الدولي للحكم الذاتي الكردي في الشمال في أعقاب حرب الخليج عام 1991 نزوة تاريخية متأخرة، تؤدي وظيفياً نفس دور التفضيلات الاستعمارية القديمة للأقليات المدمجة في سوريا. من الواضح أن هذا الدعم أقل استقراراً بكثير من الدعم الاستعماري القديم، لكن تأثيره على المستقبل قد يكون حاسماً. هناك العديد من العناصر والمتغيرات الأخرى التي تُحدث فرقًا في مصير الأقليات في العالم العربي. ومع ذلك، فإن التفاعل بين المواضيع الرئيسية المشار إليها في هذا التحليل الأولي – الأقليات المدمجة مقابل الأقليات المنتشرة، وطبيعة الروابط الأصلية، والتطرف، والإرث الاستعماري – يُهيئ المسرح الذي تتكشف فيه إشكالية الأقليات في الشرق الأوسط.
عربية:Draw أجريت العديد من الدراسات التي تؤكد ان ارتفاع حرارة الجو في البلدان ذات الفصول المتقلبة تؤدي الى زيادة في معدلات الجريمة ومنها دراسة في الولايات المتحده الأميركية أجريت في 7 ولايات. ودراسة أخرى مشابهه في اليابان توصلت إلى ذات النتيجة وان جرائم الاعتداءات والعنف تكثر عندما تكون حرارة الجو مرتفعة. وقد تم وضع مجموعة من الاشخاص في ثلاث غرف من باب التجربة . احدهما حارة والأخرى باردة والأخرى متوسطة الحرارة... اتضح ان سلوك المشاركين في الغرف الحارة كانو أكثر عدوانية من الذين تم وضعهم في الغرف الاخرى . والسبب في تغير السلوك في الجو الحار هو التاثير على الأعصاب من حيث الانزعاج والاحباط والاندفاع وهو يؤدي الى السلوك العدواني نتيجة تغيير السلوك المعتاد والعلاقات الشخصية وذلك يؤدي الى النزاعات الشخصية والجريمة ... وهذا ليس هو السبب الوحيد الذي يدفع الى ارتكاب الجريمة فهناك اسباب أخرى تكون وسطا وتدفع الى ارتكاب الجريمة منها الظرف الاقتصادي والبطالة والمخدرات ومن هذه الجرائم التي ترتكب... الجرائم البشعة ومنها القتل والايذاء والسب، حيث يكون هولاء الاشخاص تحت تأثير الحر المرتفع على الجهاز العصبي ويؤدي الى ضعف التركيز خصوصا مع قلة النوم والاجهاد في العمل نتيجة عدم وجود التيار الكهربائي وهناك مادة.السيروتونين..في الدماغ وهي المسؤلة عن ضبط المزاج في تختل في حرارة الجو المرتفع..وتدفع الى ارتكاب الجرائم .. وايضا ارتفاع هرمون ..التسترون..وهو الذي يسبب اخلالا في السلوك نتيجة الحر ..ويؤدي الى ارتفاع الجريمة. وهناك دراسة أخرى في فرنسا اثبتت ان الاقاليم الباردة هي اقل ارتكابا للجريمة من المناطق الحارة التي ترتفع فيها الجرائم .. وحتى في العراق شاهدنا ازدياد حالات الجرائم البشعة بكافة أنواعها جراء حرارة الشمس التي تصل إلى 50 درجة والناس تعمل في الشوارع تحت هذا التاثير .... لكن تبقى المصدات التي يتحلى بها الانسان العراقي من قيم ومثل عليا تدفع للصبر وعدم التهور حيث احيانا يأتي موعد رمضان في تموز وترى الناس صائمون وصابرون يتحلون بما قاله الله تعالى (واذا ما غضبوا هم يغفرون )وايضا ( والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس)وايضا (الا بذكر الله تطمئن القلوب) وتبقى الجريمة دائما رهينة الظروف والعوامل والمؤثرات النفسية والخارجية المختلفة ..التي يختلف تأثيرها من شخص لآخر لان الجريمة مثلما تكون في الصيف قد تحصل في الشتاء ...ولايمكن ان تكون حرارة الجو مغيبة للعقول التي تدرك عواقب الفعل ونتائجه ..وليست هي السبب الوحيد بالتاكيد ... ورحم الله الشاعر ..وهو القائل.. لايعشق الصيف الا من به خلل ....اما الذي يهوى الشتاء فهيم...
عربية:Draw الهجوم على محافظة(السويداء) والمكون (الدروز) في سوريا و ارتکاب جرائم القتل و النحر و هتك الأعراض و نهب البيوت والمحلات في مناطق الدروز، من قبل قوات منظمة تتكون من الجيش السوري (وزارة الدفاع) و قوات الأمن العام و ميليشيات البدو، من الجرائم الكبرى، جريمة ضد الإنسانية (Crimes against humanity) و جريمة إبادة جماعية (Genocide) القصد منها قتل وابادة (الدروز) کطائفة دينية، احدى مكونات الشعب السوري. وهذه الجريمة ترجع للاذهان ما قام به النضام البعثي من جرائم في عمليات الانفال السيئة الصيت عام 1988، کذلك الجرائم التي ارتكبه تنضيم داعش الإرهابي بحق المواطنين المدنيين من الكورد الايزيديين في منطقة شنگال عام 2014. هذه الجريمة انتهاك جسيم لحقوق الإنسان وخرق صارخ لميثاق الأمم المتحدة 1945 والشرعة الدولية لحقوق الانسان (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان1948، والعهدان الدوليان الخاصان بحقوق الإنسان لعام 1966). يخل بالسلم والامن الدوليين، على الامم المتحدة والمجتمع الدولي التحرك السريع واتخاذ اللازم لمحاكمة مرتکبي جريمة الإبادة الجماعية بحق الدروز و على رأسهم الجولاني وازاحتە من السلطة.اذا بقائه يشكل خطرا على استقرار العالم و المنطقة و السلم و الأمن
عربية:Draw المتحدث باسم جماعة العدل الكوردستانية، محمد حكيم: الحرب التي تسببت في توتر المنطقة، وليس من الواضح إلى أين ستصل الأوضاع ومدة استمرارها. وسط هذا الوضع غير المستقر والمجهد، فإن سلطات الإقليم غير قلقة بتاتا بشأن حالة الناس السيئة، ونحن نقترب من شهر تموز، لكنهم لم يوزعوا بعد رواتب شهر آيار، والتي تمثل مصدر رزق غالبية الأسر الكوردية. يجب ألا تكون الصراعات بين الإقليم وبغداد ذريعة للتقاعس عن التفكير في دفع الرواتب. على الأقل يمكنهم دفع راتب واحد من الإيرادات المحلية للموظفين ومتقاضي الرواتب ،حتى لا تتدهور حالة الناس أكثر، لأن الجوع له عواقب وخيمة ويؤثر على غضب المجتمع ويتسبب في عدم الاستقرار في البلاد ويهدد سلطة الحكام في أي دولة.
عربيةDraw تمرّ المحكمة الاتحادية العليا في العراق بمنعطف بالغ الحساسية، في ضوء ما يُشاع عن تقديم ستة من أعضائها الأصلاء وثلاثة من الأعضاء الاحتياط استقالاتهم. وتضع هذه الخطوة المؤسسة الدستورية الأعلى أمام أزمة قانونية مركّبة، يُحتّم فيها على رئيس المحكمة الاتحادية قبول الاستقالات، في حال لم يتراجع عنها أي من الأعضاء، ثم إحالة الأسماء إلى رئيس الجمهورية لاستصدار مراسيم الإحالة إلى التقاعد، وفقًا للسياقات القانونية النافذة. وبموجب المادة (3/ثانيًا) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل، تنتقل مهمة اختيار البدلاء إلى لجنة رباعية مؤلفة من رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس المحكمة الاتحادية العليا، ورئيس جهاز الادعاء العام، ورئيس جهاز الإشراف القضائي. غير أن هذا المسار لا يخلو من إشكالات معقّدة؛ فإلى جانب غموض الجانب الإجرائي المتعلق بكيفية اتخاذ القرار داخل اللجنة بشأن اختيار القضاة، يبرز كذلك التوتر الواضح في العلاقات بين بعض أعضائها، لا سيما بين رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة الاتحادية العليا في الوقت الراهن. وتُطرح في هذا السياق تساؤلات ملحّة، أبرزها: هل سيتأخّر رئيس المحكمة في البتّ بقبول الاستقالات؟ وإلى متى؟ إذ إن ذلك سيؤثّر على نصاب المحكمة، وغياب النصاب القانوني قد يُعطّل دورها في النظر في قضايا حيوية، من ضمنها المصادقة على الانتخابات النيابية القادمة. إن أي تأخير في معالجة هذا الملف قد يؤدي إلى شلل مؤسسي وفراغ دستوري يهدد العملية الانتخابية المرتقبة. لذلك، تبدو الحاجة ماسّة إلى تفعيل الآليات القضائية والدستورية لملء الشواغر بأقصى قدر من الشفافية والتوافق، وتحييد الخلافات المؤسسية التي قد تعرقل هذه المهمة الوطنية البالغة الحساسية.
عربية:Draw يلاحظ الرقم الكبير للرواتب التقاعدية المدفوعة من الموازنة العامة والتي تزيد عن ربع الرواتب المدفوعة لتعويضات الموظفين ،إن الاحالات على التقاعد قبل 1/1/2008 والمكافآت التقاعدية فتدفع من خزينة الدولة جميعها تدفع من الخزينة العامة حسب قوانين العدالة الانتقالية والمفصولين السياسيين وجميع القوانين التي تشرع من قبل مجلس النواب، اما المحالين على التقاعد بعد تاريخ 1/1/2008 تدفع رواتبهم من صندوق التقاعد. وبحسب بيانات مديرية التقاعد العامة وصل عدد المتقاعدين المدنيين والعسكريين الكلي في العراق عام 2020 الى 2.486 مليون متقاعد ، فيما بلغ عدد المتقاعدين الذين يستلمون رواتبهم من صندوق التقاعد 544 الف متقاعد، بينما تتحمل موازنة الدولة صرف رواتب 1.942 مليون متقاعد . وهذا يعني ان 22% فقط من المتقاعدين يستلمون رواتبهم من صندوق التقاعد في حين ان 78% يستلمون رواتبهم من الموازنة العامة . وهو ما يتطلب إعادة هيكلة للرواتب التقاعدية التي تصرف من الموازنة العامة وحصرها بالمستحقين فقط والابتعاد عن تسييس ملف الرواتب لا سيما وان البلد يعاني حاليا من مشاكل مالية كبيرة فيما يلي تفصيل للرواتب المدفوعة عام 2024: تعويضات الموظفين = 60 ترليون دينار المنح والأجور والرواتب = 4.735 ترليون دينار الرواتب التقاعدية = 16.728 ترليون دينار رواتب المعينين المتفرغين = 734 مليار دينار شبكة الحماية الاجتماعية = 5.635 ترليون دينار اجمالي الرواتب المدفوعة = 87.832 ترليون دينار نسبة الرواتب الى الإيرادات النفطية = 69% نسبة الرواتب الى الإيرادات العامة = 62%
عربية:Draw حل برلمان اقليم كوردستان محددة في المادة ١٠ من قانون رئاسة اقليم كوردستان رقم ١ لسنة ٢٠٠٥ المعدل وهو أي الحل من صلاحيات رئيس اقليم كوردستان وفقا لهذه المادة في حالة اذا قام رئيس الإقليم بدعوة المجلس للانعقاد خلال ٤٥ يوما من تاريخ الدعوة للانعقاد التي أمدها ١٠ ايام ابتداءا فإذا لم ينعقد المجلس فيمكن لرئيس الإقليم اصدار مرسوم إقليمي بالحل وهناك حالات أخرى تحدثت عنها المادة ١٠ أعلاه يمكن وفقها حل برلمان اقليم كوردستان منها، الإخفاق في منح الثقة لثلاث تشكيلات وزارة متتالية واذا استقال اكثر من نصف عدد أعضاءه.ويمكن للبرلمان ايضا ان يحل نفسه بطلب من ثلث الأعضاء وتصويت الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء. هل من اختصاصات المحكمة الاتحادية الوارد في المادة ٩٣ من الدستور أو قانونها ٣٠ لسنة ٢٠٠٥ أو نظامها الداخلي ١ لسنة ٢٠٢٢ مايتيح حل برلمان الإقليم؟، هذا متروك لرأي هذه المحكمة التي ردت دعاوى مشابهه لحل البرلمان الاتحادي لعدم الاختصاص كما في القرار ١٣٢ لسنة ٢٠٢٢ هل ان المدد التي نص عليها قانون رئاسة اقليم كوردستان تنظيمية ام حتمية يترتب على تجاوزها عقوبة أو أثر قانوني ، هذه المدد تنظيمية وليس حتمية ..كما قالت المحكمة الاتحادية العليا في قرار مشابه هو القرار ٥١ لسنة ٢٠١٠، بالتالي لاجزاء على تجاوز هذه المدد وكما حصل في انتخابات رئيس الجمهورية في حينه وتم تجاوز هذه المدد. هل يمكن استرداد ما استلمه نواب الإقليم من مكافئات؟ لعدم عقد الجلسات برأيي، غير ممكن لان هذه الرواتب كانت مقابل عمل ولاذنب لهم في تأخر عقد الجلسات فهم فائزين ومؤدين لليمين القانونية وهو أي هذا التوجه ما استقر عليه مجلس الدولة.
عربية:Draw لا يوجد تعريفا واضحا للفرق بين النقد والانتقاد وهوالمهم مع الاستخدام الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي في حين نلاحظ ان قانون العقوبات ميز بشكل واضح بين السب والقذف والتشهير في المواد ٤٣٣ الى ٤٣٦ منه ،ان النقد يراد منه الإصلاح والتقويم والخير في حين ان الانتقاد هو لوم وكشف المستور ونشر الغسيل.والنقد يخلو من ركن الجريمة المعنوي .والذي هو أساس جرائم السب والقذف والتشهير في حين ان الانتقاد هو إسناد واقعة لشخص اذا صحت جعلته موضع ازدراء في قومه وايضا هو المساس بالمشاعر . والنقد هو حسن النوايا وهو ظاهر الخير وباطن الجمال والانتقاد يخالف العادات والتقاليد والاعراف السائدة والنقد به حسن النية مفترض وهو ستر الآخرين ومساعدة بمد يد العون واما الانتقاد .فهو محاولة اغراق الآخرين في الاوحال وهو هروب من الواجب. ومع ذلك هناك خيوط فاصلة بين الاثنين تحتاج الى الدقة في التمييز والمعيار بين الاثنين، هو كل مايشكل جريمة، فما يشكل جريمة هو الانتقاد الذي يعاقب عليها القانون وعكسه النقد الذي هو في السليم.ومع ذلك لايرى الفرق من الرائي بسهولة الا بمعرفة النوايا ....القصد الجنائي ...والذي يظهره التحقيق.. .بالرغم من ان قانون حقوق الصحفيين ٢١ لسنة ٢٠١١ في المادة ٤ منه منحت للصحفي حق الحصول على المعلومات ولايسال عليها الا اذا شكلت جريمة أو نشر اساءة للاخرين فهي جريمة اذا خالفت القوانين النافذة وعلى الصحفي ان يتحاشى ذكر الاسماء دائما وان يعتمد التلميح وليس الاسماء. كما ان المادة ٨ من قانون حقوق الصحفيين منع مساءلة الصحفيين عما يبديه من أراء ومعلومات متعلقة بعمله أو بسبه وجعل هذا القانون من يعتدي على الصحفي كمن يعتدي على الموظف اثناء تأدية الواجب ولايجوز القاء القبض على الصحفي الا بقرار قضائي وفق المادة ١٠ من هذا القانون وان تشعر نقابة الصحفيين وجهة عمل الصحفي..ولهم حضور التحقيق والمحاكمة، اما الامر الثاني المهم ...فهو جهة الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي التي اعتبرتها محكمة التمييز الاتحادية حالها حال وسائل النشر الاخرى .. ..فارى ..ان يتم انشاء قسم خاص في هيئة الاعلام والاتصالات يكون بمثابة تعديل لقانون ٦٥ لسنة ٢٠٠٤ويضمن هذا القسم عدد من المختصين في الاعلام والقانون ...يراقب ماينشر ويكون ارتباطه بالمدير التنفيذي للهيئة وفي حالة مايشكل جريمة يتم احالته الى المحكمة المختصة حسب الاختصاص المكاني......القريبة من الهيئة ....وترتبط هذه الرقابة بجهاة أمنية أخرى تستلم منها المعلومات وهذا يحتم تشريع قانون الجرائم الاليكترونيه. المهم جدا .ويحتاج العراق ان يشرع قانون حق الحصول على المعلومة وقانون حرية التعبير عن الراي المكملان لقانون حقوق الصحفيين...والتي يؤكد عليها الاعلان العالمي لحقوق الانسان في المادة ٩ منه وميثاق العهد الدولي في المادة ١٩منه. اما النشر الهابط والذي وصفة قانون العقوبات العراقي في المواد ٤٠٣ و٤٠٤ الافعال الفاضحة المخلة بالحياء .. فعقوبته تصل إلى الحبس سنتين مع التشديد اذا كان هناك إفساد للذوق والأخلاق العامة ..وهذا يحتاج إلى توعية وافهام قبل إيقاع العقوبة ولو ان قاعدة الجهل بالقانون مرفوضة ويشترط علم الكافة بالقوانين المشرعة ...لكن لعدم وجود قانون الجرائم الإلكترونية برأيي يحتاج الأمر إلى التدرجية قبل إيقاع العقوبة القانونية أعلاه. وتبقى دائما حرية التعبير عن الراي مقيدة بالنظام العام اي القوانين والآداب العامة اي الأعراف والقيم في المجتمع ..كما قالت المادة ٣٨ من الدستور العراقي...واوجبت هذه المادة على الدولة حماية هذا الحق و كما يقول أحمد شوقي: الراي قبل شجاعة الشجعان ....هو أول وهي المحل الثاني.
عربية:Draw يعد المجلس الاتحادي العراقي أحد أهم المؤسسات الدستورية التي نص عليها دستور العراق لسنة 2005، حيث يمثل الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم ويعمل كجزء من السلطة التشريعية جنبًا إلى جنب مجلس النواب، بالرغم من أهميته في ترسيخ النظام الاتحادي، إلا أن المجلس لم يُفعَّل حتى الآن، مما يثير تساؤلات حول أسباب تعطيله وتأثير غيابه على التوازن السياسي والتشريعي في العراق . الإطار الدستوري للمجلس الاتحاد: وفقا للمادة 65 من الدستورالعراقى لسنة 2005 فإن مجلس الاتحاد العراقي يضم ممثلين عن الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم وينظم تكوينه وشروط العضوية فيه واختصاصاته وكل ما يتعلق به بقانون يُسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس ، ويشكل هذان المجلسان السلطة التشريعية الاتحادية وفق المادة (48) من الباب الثالث من الفصل الأول من الدستور والتي تنص « تتكون السلطة التشريعية الاتحادية من مجلس النواب ومجلس الاتحاد »،كما و يجب ايضاً مراعاة المبدا العام وفق ما جاءت به المادة (5) من الدستور بقولها (السيادة للقانون ، والشعب مصدر السلطات و شرعيتها ، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر و عبر مؤسساته الدستورية) . الفلسفة المزدوجة للسلطة التشريعية تشكل الفلسفة المزدوجة للسلطة التشريعية أحد الركائز المهمة في النظام الفيدرالي لضمان تمثيل المكونات والاقاليم والمحافظات، وحمايتها من الهيمنة والأغلبية، وتوفير الضمانات لتعزيز مبدأ المساواة ، يعد تأسيس المجلس الاتحادي خطوة ضرورية لضمان التوازن في صناعة القرار التشريعي، و يسهم ذلك من خلال تمثيله المباشر في التشريعات الوطنية إذ يتيح وجود مجلسين لمراجعة القوانين وتعديلها بشكل أكثر دقة عبر تمكين الأقاليم والمحافظات من المشاركة في صنع القرار مما يعزز الاستقرار السياسي والتعايش بين مختلف المكونات العراقية لذلك يُعد النظام التشريعي المزدوج أحد ركائز النظام الاتحادي، كما يعزز مبدأ المساواة بين مختلف المكونات العراقية. لقد حاول الكورد ضمان حقوقهم الدستورية في صياغة الدستور العراقي لسنة 2005، إلا أن العرب كانوا صارمين جداً ضد حق التقرير المصير للشعب الكوردى ، في حين أنه ليس سرا أن الكورد يقاتلون من أجل حقهم في تقرير المصير منذ 100 عام ، ولاشك في أنه بدون إعطاء حقوق الشعب الكوردي دون ضمانات دستورية لن يكون هناك سلام في العراق ،الشعب الكردى يريد التأكد من أنة لن يتعرض مرة اخرى للأنفال و التهجير والتعريب و .......الخ . اهمية إقرار هذا القانون احدى الامور المهمة في اقرار هذا القانون هو هل يكون لهذا المجلس حق صلاحية النقض على مشاريع القوانين، و كيف يتم انتخاب أعضاء المجلس، مع تمثيل محافظات والاقاليم، وكذلك كيفية اتخاذ القرارات، وما هي حقوق وصلاحيات الأعضاء في الإقليم و المحافظات ، ثم دور المجلس الاتحادي في ممارسة هذه الصلاحيات والمشاركة فيها؟ لأن المادة 65 تعطي المجلس صلاحية تنظيم اختصاصات هذا المجلس وتشكيله بقانون. صلاحيات المجلس الاتحادي نتوقع ان تشمل اختصاصات المجلس الاتحادي ما يلي: اولاً: الاختصاص التشريعي تحديد صلاحيات المجلس ومدى تمتعه بحق النقض على مشاريع القوانين ، ومنع الهيمنة الاغلبية البرلمانية هي لتعزيز مبادىء الفيدرالية. إن تحديد حقوق وصلاحيات الأقاليم والمحافظات في المجلس هي للمشاركة في سن القوانين إلى جانب مجلس النواب و لضمان التوزيع العادل للسلطة و الثروة و مراجعة القوانين المقترحة وتعديلها ، وكذلك اقتراح مشاريع قوانين جديدة ، وكذلك مشاركة المجلس في عملية انتخاب رئيس الجمهورية بالتنسيق مع مجلس النواب ويليه المشاركة فى الاختصاص في تعين اصحاب الدرجات العليا ، والمشاركة فى قرارات السياسية و القانونية وفقاً للمادة (109 ، 110 )من الدستورواخيراً وليس اخراً المشاركة فى كافة الصلاحيات المنوحة لمجلس النواب بموجب المادة (61 ) من الدستور والمادة (48) من الدستور . ثانياً: الإشراف القضائي: ان المشاركة في (الاختصاص الصلاحيات الرقابة و القضائي) اي المشاركة فى محاكمة رئيس الجمهورية والنواب و الرئيس الوزراء عند اتهامهم من قبل مجلس النواب. أهمية القانون بالنسبة للكورد والشيعة والسنة والطوائف الأخرى: إن العراق اليوم بعد عام 2005 هو العراق الذي يهيمن عليه المكون العرب الشيعة، ومن المهم أن تتعلم الأغلبية الشيعية من الماضي وتقديم الضمانات للشعب الكردي والمكونات الاخرى هذه من ناحية ، ومن ناحية أخرى، فإن من واجب المجتمع السني أن يدعم المطالب الكردية في هذه القضية لأن في نهاية المطاف ستصب في مصلحته ايضاً، وبالتالي فهي فرصة لإحياء أمل التعايش والوحدة. إحدى الفوائد الرئيسية لوجود مجلسين تشريعيين هي توفير نوع من التوازن بين المجلسين باعتبار ان كل مجلس يمثل مصالح مختلفة ويعتمد على عمليات انتخاب منفصلة، كما ان المبدأ العام في الدول ذات النظام الفيدرالي هو المساواة بين المجلسين والحق في اقتراح مشاريع القوانين . يمكن لقانون المجلس الاتحادي أن يضمن وحدة أراضي العراق و وحدة شعبه، وذلك من خلال إعطاء حق النقض على قوانين مجلس النواب وتنفيذها وإعطاء حق النقض لممثلي المحافظات، لذلك فإن أغلبية الشيعية بشكل خاص والعرب بشكل عام يواجهون مسؤولية تاريخية تجاه الشعب الكردي، وإذا أعطوا هذا الحق لممثلي المحافظات فإنهم سيحظون بثقة الشعب الكردي. كما ويجب على أصدقاء و حلفاء العراق أن يساعدوا في إقرار هذا القانون المهم بطريقة تجعله مصدر قوة وبناء الثقة في الحاضر وفي المستقبل . لذلك اذا اقتصرت الاختصاصات ومهام المجلس الاتحادى على مواضيع غير مهمة و تقليدية ، على سبيل المثال ( اقتراح مشاريع القوانين وابداء الرأي و المناقشة و الاستيضاح و السعي لحل الخلافات و النظر فى بعض حالات و مشاركة فى اختيار بعض المناصب ، فى هذا حالة لا حاجة لاصدار وتشريع هذا القانون لانه سوف يكون مجلسأ كرتونياً وتشريفياُ . ان الحكمة الثنائية للسلطة التشريعة هى اعطاء الضمان الى كافة المكونات ، مما يدل ان إصدار هذا القانون يتوافق مع ثنائية السلطة التشريعة من حيث القوة التضامنية المشاركة للمجلسين (النواب و الاتحادي ) فى ترسيخ الركائز الدولة فيدرالية و تحقيق الدىمقراطية بما يلائم االضمانة الدستورية فى تحقيق العدالة و صيانة الحقوق المحافظات والاقليم ، كما أنها تحمي الأقليات من هيمنة الأغلبية بضمانات دستورية وقانونية. في ظل النظام السياسي العراقي القائم على المحاصصة والتوافق، نرى انه من الأفضل توزيع الصلاحيات بين المجلسين بحيث يُحال القرار الذي يحتاج إلى أغلبية إلى مجلس النواب، بينما يُحال القرار الذي يتطلب إجماعًا إلى المجلس الاتحادي. الاستنتاج: يجب أن يدرك السياسيون العراقيون أن العراق يتكون من اكثر من مكون (الكورد والعرب الشيعة، والعرب السنة ومكونات اخرى )، مما يستوجب ضمان حقوق جميع المكونات. صدور قانون مجلس الاتحادي هو خطوة ضرورية لمستقبل العراق الموحد، حيث إن تعزيز الصلاحيات التشريعية لهذا المجلس سيسهم في حماية حقوق الأقليات ومنع هيمنة الأغلبية، وهذا ما يعزز مبادئ الديمقراطية والفيدرالية. يُعد المجلس الاتحادي ضرورة دستورية تهدف إلى تحقيق التوازن في صنع القرار، وتعزيز مبدأ الفيدرالية، وضمان التمثيل العادل لجميع المكونات العراقية، رغم التحديات التي تحول دون تفعيله، فإن إقراره وتحديد صلاحياته بشكل واضح سيسهم في تعزيز الديمقراطية والاستقرار في العراق. لذلك، من الضروري أن تبذل القوى السياسية جهودًا جدية لتفعيل هذا المجلس، بما يحقق مصلحة البلاد ككل، ويضمن توزيعًا عادلًا للسلطة بين مختلف الأقاليم والمحافظات . وأخيراً إذا لم يُمنح هذا المجلس الصلاحيات الكاملة التي اشرنا اليها سابقاً لحماية مكونات الشعب العراقي بشكل عام والشعب الكردي بشكل خاص فمن الأفضل عدم تكوينه، لأن هذا المجلس سيكون عبئاً على كاهل الشعب العراقي. لو كنت عربياً لأعطيت اخوتي الكورد ورقة بيضاء لكتابة وتشريع قانون المجلس الاتحادي، لأطمئنهم بان العراق الجديد مختلف تماماً عن العراق القديم لكي اعوضهم عن المعاناة و البؤس و الظلم الذي عانوه في الماضي .
عربية:Draw إن توطين الحوار والدبلوماسية يشكل أداة جوهرية لمعالجة العنصرية والتحيز والحد من الصراعات الدموية في دول الشرق الأوسط. إذ تعد المنطقة واحدة من أكثر المناطق تعقيدًا على المستوى السياسي والجغرافي والاجتماعي، حيث تتشابك فيها المصالح المحلية والدولية، وتتداخل النزاعات العرقية والدينية والسياسية. لذا، في ظل هذه البيئة المتشابكة، أصبح تعزيز الحوار والدبلوماسية خيارًا لا غنى عنه لتحقيق الاستقرار وصنع القرارات السياسية المستدامة. نلاحظ أن الوضع في سوريا اليوم لا يزال يشهد تعقيدًا كبيرًا وتحديات جسيمة. سنوات الصراع التي تجاوزت العقد أدت إلى دمار واسع للبنية التحتية، ونزوح الملايين من السكان، وتفاقم الأزمات الإنسانية. إلى جانب استمرار التدهور الأمني والنزاعات المسلحة والانقسام العرقي والمذهبي. المشهد في سوريا لا يختلف كثيرًا عن نظيره في العراق، فكلاهما يمثلان قلب الشرق الأوسط ومهد الحضارات القديمة، بالإضافة إلى كونهما نموذجًا فريدًا للتعددية الثقافية والدينية. ومع ذلك، فإن هذا التنوع، الذي يُعتبر إرثًا ثمينًا، قد يتحول إلى قنبلة موقوتة تُهدد بالفتنة والدمار إذا لم تُعالج أسبابه جذريًا من خلال حلول سياسية ودستورية وقانونية. في هذه الحالة، نحن أمام خيارين متباينين: إما المضي في ديناميكيات سلبية تؤدي إلى تمزيق النسيج الاجتماعي، وتصاعد الانقسامات العرقية والدينية، وما يترتب عليها من عنصرية، وعنف، وإراقة الدماء، مما يفتح الباب أمام صراعات طائفية طويلة الأمد، ويزيد من اتساع الفجوة بين المكونات المجتمعية، ويعرقل أي مساعٍ للتنمية والإصلاح. أو السعي نحو مسار إيجابي يعزز السلام والوئام، من خلال تقليص الفجوات الاجتماعية، وتعميق التفاهم المتبادل، وتشجيع التعاون بين الأطراف المختلفة، ومكافحة الفساد السياسي والإداري لتحقيق الاستقرار وتطلعات المجتمع نحو مستقبل أفضل. الخلفيات الثقافية والتوجهات – بما تتضمنه من أفكار ومظاهر مادية وسلوكيات – تؤثر بشكل واضح في سياسات الأحزاب والمكونات، حيث يقومون ببناء خطابات باسم الثقافة، والدين، واللغة لتوجيه الجمهور وجعلهم يقبلون المزاعم بأنها تمثل حقائق شاملة. هذه الخطابات تساهم في تشكيل الانقسامات وإبراز الفروقات بين الجماعات، مما يؤثر على تفاعلهم مع القضايا السياسية والاجتماعية. هنا تكمن أهمية توطين الحوار والدبلوماسية في تبني آليات تفاوض وحلول سلمية محلية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المنطقة وثقافتها السياسية والاجتماعية. هذه الدبلوماسية تُسهم في تحقيق توازن المصالح بين الأطراف المختلفة، وتقليل التوترات، وحل النزاعات الإقليمية سواء كانت ناتجة عن عوامل داخلية كالفقر والبطالة وضعف الحوكمة، أو خارجية تتعلق بالمصالح الدولية. كما أن بناء الثقة بين الأطراف المتنازعة يُعد خطوة جوهرية، حيث يتيح إشراكهم في صياغة الحلول بدلاً من فرضها من قبل قوى خارجية، وهو ما يعزز السيادة الوطنية ويُرسخ استقرار المنطقة. لا يتوقف هذا الدور على السياسيين وحدهم، بل يمتد ليشمل المجتمع بكل مكوناته، باعتباره ركيزة أساسية في تحقيق السلام. فالأفراد والمؤسسات المجتمعية يمكنهم الإسهام عبر تعزيز قيم التسامح والحوار، وإطلاق مبادرات شعبية تدعم المصالحة وتُعيد بناء جسور الثقة بين الأطراف المختلفة، مما يُمهّد الطريق لاستدامة الحلول السياسية والاجتماعية. يمكن اعتبار سياسة الرئيس نيجيرفان بارزاني نموذجًا عمليًا لتوطين الحوار والدبلوماسية بهدف تجاوز الانقسامات العرقية والدينية. فقد ركزت سياساته على تشجيع الحوار وتعزيز التفاهم المشترك بين مختلف الأطراف، والسعي لترسيخ التسامح الديني والثقافي كوسيلة لتحقيق السلام الاجتماعي والتغلب على التحيزات العرقية والدينية، والحد من مخاطر النزاعات الداخلية وضمان السلام والاستقرار. يجسد هذا النهج استمرارًا للإرث الذي خلفه والده، المرحوم إدريس بارزاني (1944-1987)، الذي لعب دورًا محوريًا في إخماد الحرب الداخلية بين الأحزاب الكوردية في الثمانينات من القرن الماضي، مما أثمر عن تشكيل الجبهة الكوردستانية بقيادة الرئيس مسعود بارزاني والمرحوم جلال الطالباني، واللذان بدورهما قادوا الانتفاضة الشعبية في اذار ١٩٩١ كنموذج للوحدة والتعاون لتحقيق الأهداف المشتركة. لذا ينبغي على الساسة في العراق وسوريا صياغة استراتيجية شاملة تعتمد على الحياد والموضوعية، بعيداً عن أي شكل من أشكال التحيز أو التعصب، لضمان التعايش السلمي وتحقيق الاستقرار.
عربيةDraw كلنا الان متفقين على ان التطورات الاخيرة في المنطقة خصوصا سقوط نظام الاسد البعثي في سوريا أدى إلى هزيمة إيران عبر ما يسمى بمحور المقاومة وجماعات وحدة الساحات وغير ذلك من الخزعبلات والحدث الاهم هو بروز تركيا كلاعب رئيسيي. كل ذلك له انعكاسات على العراق وطبعا على اقليم كوردستان في الإقليم، الوضع الجديد يتطلب إجراءات وقرارات عاجلة للتكيف مع هذا الوضع. وبصراحة وكي نضع النقاط على الحروف، يتعين على الذين راهنوا على إيران وتحالفوا معها ومع ميليشيات موالية لها ان يعيدوا النظروبسرعة بحساباتهم التي اثبتت التطورات الأخيرة خطأها الفادح.وقبل كل شيء يتعلق هذا بالاتحاد الوطني الكوردستاني والمطلوب منه الان حفاظا على مصلحته ومستقبله ومصلحة الشعب الكوردي في العراق أن يبدأ عملية فك الارتباط بإيران والميليشيات اياها من امثال كتائب حزب الله واهل الحق وبابليون وزعماء بعض الميليشيات مثل قيس الخزعلي وريان الكلداني. فك الارتباط مطلوب خصوصا مع حزب العمال الكوردستاني المتحالف مع إيران واصبح مشكلة كبيرة على الوضع في اقليم كوردستان مما أدى إلى جلب سخط وغضب تركيا التي ازدادت قوة وجبروتا كلاعب سياسي في المنطقة ودوليا ايضا و في هذا الاطار ادعو الطرف الاقوى في الإقليم سياسيا وموقفاً وانتخابيا، تحديدا الحزب الديمقراطي الكوردستاني ان يمد يد التسهيل والمساعدة لتحقيق هذه الاهداف. إلى ذلك يتعين على العقلاء في الاتحاد الوطني الكوردستاتي ممن اثروا حتى الان الانعزال والسكوت عن السياسات الخاطئة لقيادتهم ان يخرجوا من عزلتهم وسلبيتهم ويحثوا قيادتهم على تغيير مواقفها. كذلك ادعو العقلاء من خارج الاحزاب ان يلعبوا دورهم في تقريب وجهات النظر والتوسط إذا تطلب الامر انطلاقا من المصلحة العامة.
عربية:Draw من خلال استقراء الاحداث السياسية وبناءً على المعطيات المُتاحة، اول ما يخطر على بال المتلقي، هو ظهور بوادر اعادة تشكيل الخارطة السياسية للمنطقة، كيف؟ سنحاول من خلال هذا التحليل،عرض مجموعة من المعادلات السياسية والمشاهد المستقبلية لغرض فهم التعقيدات وبناء تصورات واقعية وعلمية للاحداث الراهنة : اولاً//على المستوى المحلي :الأزمات السياسية والاقتصادية والاقتتال الداخلي قد انهكت كاهل المواطن السوري مابين البحث عن المأوى والحصول على قوته اليومي او الانظمام إلى الجماعات المسلحة ومن كثرتها تصعب التمييز والتسمية،ومن جانب آخر هاجس الخوف من (الجماعات المسلحة،المعارضة،النظام السوري،القوات الدولية )افقد المجتمع السوري تماسكه الاجتماعي، مما يُسهل من عملية التغيير، وإن كانت غير مستحبة. ثانياً//على المستوى الاقليمي: الدور التي تلعبه الدول الإقليمية لاتقل أهمية وتأثيراً عن دور القوى الكبرى وسنحاول تسليط الضوء على دور وتأثير كل دولة على حدة؛ أ- العراق،لعل الوضع الراهن للدولة العراقية وبحلتها الجديدة بعد سنة ٢٠٠٣ تُعتبر الأقل تأثيراً على تداعيات الاحداث في سوريا ،لكون البلد أُبتلي بأزمات ومشاكل وتحديات (داخلية واقليمية ودولية ) لاتقل عن حجم التحديات الموجودة في سوريا ،كونه يمر بفترة انتقالية عويصة وتحكمها اجندات إقليمية ودولية حالها حال الدولة السورية،عليه القائمين على الحكم في الدولة العراقية، يًجابهون مجموعة من التحديات، أبرزها والمتعلقة بالشأن السوري ،هي كيفية التحكم بسيادة البلد ومنع خط الإمدادات من إيران إلى سوريا وضبط سلوك الجماعات المسلحة المدعومة من ايران، لكنها تبدو مهمة مستحيلة بالنظر للدور التي تلعبه ايران في بناء وصياغة المشهد السياسي في العراق،عليه لايُنتظر من الدولة العراقية بأن تكون لها تأثير مباشر على واقع الاحداث السياسية، كون الخلافات والمشاكل بين المكونات السياسية في العراق لم تُحل وما زالت قائمة، وفقدان الثقة بين الأطراف المتخاصمة اصبحت صفة تُلازم طبيعة الحراك السياسي، لذا من الأجدر بها أن تحمي حدودها لكي لايتكرر ما مر به البلد من احداث في سنة ٢٠١٤ . ب- تركيا: يبدو بأن الجذور التاريخية للازمات بين الدولة التركية والدولة السورية هي الأبرز ،كونها تعكس مدى تداخل وتنافر المصالح وفقاً لمصالح الدول المنتصرة في الحرب العالمية الاولى انذاك وما أفرزته المعاهدات والاتفاقيات الدولية من تحديات بين البلدين،بالعودة إلى العقود الأخيرة واستعراض العلاقات الدبلوماسية بين البلدين،فإنها تأرجحت مابين التوجس ومحاولة فرض امر الواقع بين الجانبين، ولعل مشكلة المياه وتواجد قيادات حزب العمال الكوردستاني من ابرز الخلافات ،حيث استغلت الحكومة التركية وحزب العدالة والتنمية تنامي الاحداث في سنة ٢٠١١ محاولاً بشتى الطرق تثبيت نفوذها داخل الأراضي السورية، من خلال دعم الحركات والجماعات المسلحة من جهة ،ومن جانب آخر توغلها المباشر داخل الأراضي السورية بحجة محاربة أعضاء قوات سوريا الديمقراطية(قسد).لذا ومن خلال قراءة التصريحات الرسمية لصُناع القرار للدولة التركية فأنها ماضية باتجاه دعم الحركات المسلحة (جبهة تحرير الشام ،أنموذجا)بهدف الإطاحة بالنظام السوري أو في سبيل فرض المزيد من النفوذ داخل الأراضي السورية. ج-لبنان : اصبحت واقع الحرب والأزمات والمشهد السياسي والاقتصادي المتأزم في لبنان تفرض حالة من اللامبالاة من قبل الحكومة اللبنانية كونها أُبتليت بما يكفي ولاتستطيع أن تؤثر في مجريات الاحداث السياسية في سوريا، ناهيك عن عقد الهدنة مع الجانب الاسرائيلي،ومحاولة تحجيم دور حزب الله في المسرح السياسي خلال الفترات القادمة. د- الأردن: دولة عربية ولكنها لاتملك من القوة والنفوذ بما تكفي لفرض اجندات مؤثرة في تغيير الاحداث ،إلا إن بعض المحللين يعتبرونها مطبخ سياسي للاتفاقيات المبطنة. هـ - اسرائيل: اغلب الاحداث السياسية التي تجري في منطقة شرق الأوسط ،أما تُشارك فيها اسرائيل كلاعب رئيسي كما هو الحال في قيامها بإبادة جماعية في غزة ،و تدخلها المباشر في جنوب لبنان بهدف حماية الأمن القومي للدولة الاسرائيلية ، أو بشكل غير مباشر كما هو الحال في اغلب دول المنطقة، ومن ابرز تأثيرات اسرائيل في الاحداث الجارية في سوريا ،تتمثل بمحاولة قطع الإمدادات والدعم السوري -الإيراني عن حزب الله في جنوب لبنان،لتقليل الخطر على اسرائيل.وإن لم تفلح مجريات الاحداث في سوريا بقلب نظام الحكم فأنها تتجه(اي اسرائيل) نحو الضغط على الحكومة السورية بهدف التخلي عن المطالبة بهضبة جولان إلى الأبد وكذلك التخلي عن دعم حزب الله في جنوب لبنان . و-دول الخليج ،مصر ودول المغرب العربي: دول تنتهج سياسات بعيدة عن الأزمات واختارت لنفسها بأن تتبنى سياسة التطبيع. ز- ايران: دولة إقليمية لها من النفوذ والسطوة داخل الأراضي السورية،مالا يمتلكه النظام السوري،لذا وبشكل مختصر سقوط النظام في دمشق او تغيير ملامح الحكم في سوريا بما لا يتلائم مع المصالح الإيرانية ،يُعتبر نكسة للأستراتيجية والنفوذ الايراني، وبمثابة فقدان موطأ قدم للجمهورية الإسلامية الإيرانية في المنطقة، ثالثا// على المستوى الدولي : مما لاشك فيه إن طبيعة الحروب في الوقت الراهن هي حروب تخوضها دول وجماعات ذات معايير قوة صغيرة ،بالنيابة عن الدول الكبرى ،فيما يتعلق بالشأن السوري فأنها شائكة ومعقدة لدرجة بأن بناء اي تحليل سياسي يستوجب اكثر من قراءة،كون الوضع الراهن في سوريا تتداخل فيه استراتيجيات إقليمية ودولية وذات أبعاد سياسية واقتصادية وأمنية ،عليه اخفاق وتراجع نفوذ القوى الكبرى تعتبر بمثابة تخلخل في التوازن الاستراتيجي للجهات المتصارعة كونها بالأصل هي منطقة تزاحم الاستراتيجات بين الجهات المتصارعة وبنسق متوازن .وفيما يلي نستعرض ادوار القوى الكبرى في سوريا: أ- الولايات المتحدة الأمريكية ؛ بعد انتهاء الحرب الباردة وسطوة القطب الواحد على العالم برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية ،اصبحت التواجد الأمريكي سواءً كانت بصبغة عسكرية ومدعومة من حلف الناتو أو ذات أبعاد اقتصادية وثقافية واستخباراتية، من اكثر المشاهد جدلاً ،حيث تواجد اكثر ١٤٠ قاعدة عسكرية أمريكية حول العالم وكل قاعدة عسكرية احياناً بميزانية دول بحالها، تكفي لمعرفة مدى تشبث الولايات المتحدة الأمريكية بأن تبقى محافظاً على المكانة الدولية كأكثر دولة قدرة في التحكم بنسق السياسة الدولية، ولايخفى على أحد مدى ترابط وتزامن مصالح الولايات المتحدة الأمريكية مع المصالح الاسرائيلية ،بل تُتعبر امريكا الراعي الرسمي للأمن القومي الاسرائيلي، وبهذا الصدد يستوجب تواجد أمريكي في المنطقة سواءً كانت على شكل أساطيل بحرية في البحر الأحمر وبحر الأبيض المتوسط ،او قواعد عسكرية متقاربة من بعضها في كل من (الأردن ،العراق،اقليم كوردستان العراق ،أذربيجان ، قاعدة انجرليك في تركيا ،قطر ) ،فيما يتعلق بالتواجد الأمريكي في سوريا فأنها تستهدف مراقبة تزايد النفوذ الروسي من جهة وتحجيم الدور الإيراني من جهة اخرى ،مستفيداً من نفوذها وسطوتها بتسخير اغلب الحركات المسلحة لصالحها بما فيها الحركات المتشددة . ب-روسيا ؛ مرت روسيا بفترات اُستخف بقوته وخصوصاً بعد انهيار المعسكر الشرقي بقيادة الاتحاد السوفيتي وحل حلف وارشو ،بحيث باتت خطر توغل حلف الناتو وشيكاً وعلى أبوابها تمثلت بمحاولة ضم جورجيا لحلف ناتو سنة ٢٠٠٨ ،إلا ان تصدي روسيا لهذه المحاولة وإفشالها ،شجعت صُناع القرار في روسيا بالتوسع امنياً واقتصاديا وعسكرياً في دول المنطقة ولعل ابرز تلك المحاولات توج بالنجاح للدب الروسي من خلال دخولها في شراكات اقتصادية وأمنية مع دول العالم ومن أبرزها (حلف شنغهاي وحلف بريكس) ومد الخط الثاني للغاز (ستروم٢) إلى أوروبا ،وشكلت مع كل من الصين وكوريا الشمالية وايران تحالف سياسي ،مهدت بدخول قواتها إلى سوريا ومنع سقوط نظام الأسد خلال احداث ٢٠١١،مما اربك الاستراتيجية الأمريكية وخصوصاً بعد اخفاق الأخير في كل من العراق وافغانستان ،عليه النفوذ الروسي في سوريا هي بمثابة خطوة تمهيدية لإعادة دورها المُغيب كقوة كبرى وبالتالي التأثير على التوازنات الاستراتيجية في السياسة الدولية لصالحها نظراً لتواجدها في اكثر من جبهة ومنها دخولها بشكل مباشر في الحرب مع أوكرانيا. المشاهد المستقبلية للواقع السياسي في سوريا : اولاً: انهيار النظام السوري وبدء حقبة سياسية جديدية ،يرسمه ويملي ملامحه المصالح (الأمريكية -الاسرائيلية-التركية ) مع منح ادوار للقوات المستجدة على الساحة السياسية السورية بمن فيهم (قسد) ،هذا المشهد يغيب عنها روسيا(مقابل تقوية مركزها في الحرب الروسية -الاوكرانية) ومستبعد عنها الدور الايراني،وهذا المشهد تعتبر الأقرب إلى الواقع بحكم المعطيات السياسية الراهنة. ثانياً:استمرار الوضع الراهن والاقدام على دعم النظام السوري من قبل (روسيا وايران) كما حدثت في ٢٠١١وتوسيع رقعة الحرب في المنطقة ضد المصالح الأمريكية ،هذا المشهد وارد ولكن الواقع العسكري والسياسي،تُصعب تنفيذ هذا المشهد. ثالثاً:دعم سوريا من قبل روسيا وايران والجماعات المسلحة الموالية لايران بهدف السيطرة على كامل الأراضي السورية ،هذا المشهد غير واقعي مقارنة بخارطة الحرب والصراع الجاري .
عربية:Draw محامي قضية رواتب الموظفين في المحكمة الاتحادية، بكرحمه صديق أعتقد أننا عدنا إلى المربع الأول أي الوضع ما قبل صدور قرار المحكمة الاتحادیة بشأن رواتب موظفي الإقليم. حكومة إقليم كوردستان عملت بقدر الإمكان في خلق المشاكل لإرسال الرواتب من بغداد وهي لازالت تعمل على ذلك، وهذا الأمر لا يخلو من الأدلة، فبيانات ديوان الرقابة المالية ودائرة المحاسبة في وزارة المالية العراقية تثبت ذلك والدليل هوصمت حكومة إقليم كوردستان إزاء ما تقوله بغداد إقليم كوردستان لايعطي أهمية ولا ينظر إلى رواتب الموظفين بقدر ما يهتم وينظر إلى ملف الانتخابات، ومن جانبها قامت بغداد بإثارة الخلافات السابقة حول عدم إلتزام اربيل بتسليم الإيرادات وهذا انتهاك تام لحكم المحكمة الاتحادية الذي يقضي بإبعاد قوت ورواتب موظفي كوردستان عن الصراعات السياسية. في غضون ذلك، نواب السلطة كانوا يتبجحون داخل اروقة البرلمان وكانوا يتهمون الحكومة العراقية بالتسبب في تأخير الرواتب.الاتخجلون من انفسكم، إلى متى تلعبون بقوت و معيشة المواطنين والفقراء.
عربية:Draw شَهِدَ التاريخ البشري العديد من حملات التطهير العرقي التي استهدفت مجتمعات معينة بدعوى تحقيق أهداف سياسية. ومع ذلك، فإن هذه الحملات لم تؤدِ إلى النتائج المرجوة، بل غالبًا ما كانت لها عواقب وخيمة على جميع الأطراف المعنية. فبدلاً من تحقيق الوحدة والاستقرار، أدت هذه الأفعال إلى تفكيك المجتمعات وتدمير الثقافات، وزيادة الكراهية، وتعزيز الانقسامات. تُعتبر هذه الحملات بمثابة وصمة عار في تاريخ الإنسانية، حيث تذكرنا بخطورة التمييز والعنف. إن الفشل في تحقيق أهداف التطهير العرقي يبرز الحاجة الملحة إلى قبول الآخر والاحتفاء بالتنوع، كسبيل حقيقي نحو السلام والتعايش. في هذا المقال، نستعرض بعض الأمثلة التاريخية، بما في ذلك الحملات ضد الكورد، ونناقش كيف أن قبول الآخر والتعايش السلمي هو الحل الحقيقي للسلام. لقد شهد تاريخنا العديد من حالات التطهير العرقي والسياسي، حيث استخدمت الحكومات والجماعات المتسلطة العنف لإزالة فئات معينة وغالبًا ما تم تبرير هذه الأفعال بدوافع سياسية أو دينية، لكن النتائج كانت مدمرة وطويلة الأمد. يُعد غزو التتار وهولاكو لبغداد في عام 1258 خير مثال، فقد تعرضت العاصمة العباسية بغداد لغزو وحشي من قبل قوات هولاكو، كانت النتيجة مدمرة بشكل فادح؛ حيث دمرت المكتبات، وألقيت آلاف الكتب في نهر دجلة، وقُتل العلماء والمفكرون مما أدى إلى فقدان تراث ثقافي وعلمي هائل. هذا الغزو لم يؤثر فقط على بغداد، بل كان له آثار طويلة المدى على العالم الإسلامي، حيث أدى إلى انهيار الخلافة العباسية وفتح الباب أمام فترات من الفوضى وعدم الاستقرار. الصراع السني- الشيعي يمثل أحد أبرز الأمثلة على الانقسام الديني. فقد شهد المجتمع الاسلامي منذ مئات السنين أعمال عنف وتطهير لا انساني، مما أدى إلى استمرار التوترات وعدم الاستقرار إلى يومنا هذا. تتجلى تبعات هذا الصراع في النزاعات المستمرة بين الجماعات المختلفة، مما يعوق جهود بناء مجتمع متماسك. فقد أدى هذا الصراع، الذي بدأ في القرن السابع الميلادي، إلى انقسام دائم داخل الأمة الإسلامية، مما يجعل الحاجة إلى الوحدة أكثر إلحاحاً. هذا الانقسام لا يزال يؤثر على العلاقات بين المجتمعات الإسلامية والدول والحكومات حتى اليوم. نذكر في إطار التاريخ الأوروبي حرب البوسنة 1992-1995 كمثال آخر على التطهير العرقي، حيث تعرض البوشناق والكروات للأذى. وقد أظهرت هذه الحرب كيف يمكن أن تؤدي التوترات العرقية إلى صراعات مدمرة. تُعتبر أزمة الروهينجا في ميانمار كواحدة من أبرز الأزمات الإنسانية في العصر الحديث، حيث تعرض الروهينجا للطرد والعنف. وتظهر هذه الأزمة الحاجة الملحة لقبول الآخر وتوفير الحماية للحقوق الإنسانية. وتاريخ الكورد ليس بعيداً عن هذه السياسات القمعية، بل هو حافل بالعديد من الحملات التي استهدفتهم، حيث تعرضوا للعديد من حملات الإبادة الجماعية عبر التاريخ. بدءًا من الحملات العثمانية التي استهدفتهم في القرن التاسع عشر، وصولًا إلى هجمات نظام البعث في الثمانينات، مثل حملة الأنفال، التي أدت إلى مقتل الآلاف وتهجير العديد منهم. هذه الحملات أظهرت كيف يمكن أن تؤدي السياسات القمعية إلى آثار مدمرة ليس فقط على الكورد، بل على استقرار المنطقة بأسرها. اليوم في إقليم كوردستان، يعيش الناس حالة من الفوضى والقلق نتيجة لعدم التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الفيدرالية والحكومة المحلية. هذا التوتر لا يقتصر فقط على القضايا السياسية، بل يتجلى أيضًا في تأثيره المباشر على حياة المواطنين اليومية. يُعتبر هذا الوضع نوعًا عصريًا من التطهير الاقتصادي والاجتماعي، حيث تتأثر الفئات الأكثر ضعفًا مثل الموظفين والمتقاعدين بشكل خاص جراء ذلك، إن استمرار هذه الحالة يزيد من تعقيد الأوضاع ويعمق الأزمة. لذا، يتطلب من الجميع إعادة التفكير في سياساتهم وتوجهاتهم، والعمل بجدية من أجل تحقيق الاستقرار والازدهار للجميع. قبول التنوع وقوة الحوار يلعبان دورًا أساسيًا في بناء الجسور بين المجتمعات المختلفة. هناك العديد من المبادرات الناجحة التي أثبتت فعالية الحوار في تحقيق السلام، مثل برامج التبادل الثقافي والمبادرات المجتمعية. تعد تجربة جنوب أفريقيا نموذجًا يحتذى به في الانتقال من الفصل العنصري إلى أمة موحدة. لعبت لجان الحقيقة والمصالحة دورًا حيويًا في هذا التحول، حيث سمحت للأفراد بمشاركة تجاربهم والعمل على بناء مجتمع أكثر تماسكًا. كما تُظهر دول مثل كندا وسويسرا واستراليا واميركا كيف يمكن أن يسهم التنوع الثقافي في النمو الاجتماعي والازدهار. هذه الدول تبنّت سياسات تعزز التعايش السلمي وتعترف بحقوق جميع الأفراد بغض النظر عن هوياتهم. ومن هذا المنطلق تبرز رؤية رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، التي تدعو إلى قبول التنوع والتعايش السلمي. إن هذا الفهم والتقدير للاختلافات يمكن أن يسهم في بناء مجتمعات أكثر تضامنًا وسلامًا، حيث يعمل الجميع معًا لتعزيز ثقافة السلام والتسامح. لذلك يُعتبر تدخل سيادته في هذه المرحلة نقطة تحول تاريخية، حيث يمكن أن تساهم سياسته الرشيدة في إعادة بناء الثقة بين المكونات المختلفة في المجتمع العراقي. عبر تشجيع الحوار والتعاون، كما يمكن أن تسهم هذه الرؤية في تجاوز الأزمات الحالية وفتح آفاق جديدة من التعاون والتنمية، مما يعيد الأمل إلى المواطنين ويعزز من استقرار العراق والمنطقة. في الختام، نستنتج أن عمليات التطهير العرقي والسياسي لا تقتصر على كونها عديمة الجدوى فحسب، بل إنها تفضي أيضاً إلى أزمات إنسانية طويلة الأمد. إن قبول الآخر وتقبّل الاختلافات هو السبيل الحقيقي نحو السلام والاستقرار.
عربية: Draw إن التعداد العام في كركوك،الذي من المقرر إجراؤه في 20 تشرين الثاني من هذا العام، سيدفن الأمل في إعادة كركوك إلى حضن إقليم كوردستان عبر الإجراءات القانونية والدستورية إلى الأبد، لأن الكورد فقدوا العديد من الفرص في الماضي. في نيسان 2003، فوتت القيادة السياسية الكوردية فرصة ذهبية لإعادة كركوك إلى إقليم كوردستان. عندما وافقت بناء على طلب الولايات المتحدة على إنسحاب البيشمركة من كركوك والسماح بتحرير كركوك من قبل الولايات المتحدة، ومن ثم تم التعامل مع قضية كركوك وفقا للمادة 158 من قانون الإدارة المؤقتة العراقي. والأدهى هو أنه في وقت كتابة الدستور العراقي وافقت القيادة السياسية الكوردية مرة أخرى على دمج قضية كركوك والمناطق الكوردستانية المتنازع عليها مع مشكلات العديد من المناطق الأخرى في شمال ووسط العراق، وكان مصير المدينة مرتبطا بتنفيذ المادة 140 من الدستور الدائم للعراق. ومنذ ذلك الحين، لم تتخذ سلطات الإقليم خطوات جادة وحاسمة لتنفيذ المادة 140. طوال هذه السنوات، استخدم القادة الكورد كل الأعذار لتبرير عدم تطبيق المادة 140 وخلق عقبات أمام تحديد مصير كركوك، وكانت المكاسب الشخصية والحزبية في بغداد من أولويات السلطة الكوردية. وكان إجراء الاستفتاء في 25 أيلول 2017، وما تلاه من تسليم كركوك وبقية المناطق الكوردستانية المستقطعة إلى الجيش العراقي في 16 تشرين الأول، الضربة الأخيرة لكركوك. وفي حال إجراء التعداد العام في كركوك هذا الشهر، فإن عدد الكورد سيقارن بالتأكيد بعدد العرب ومجموع سكان المدينة، بما في التركمان والكلدان، بحيث لا يمكن بعدها الأدعاء بكوردستانية كركوك، لايمكن بأي معيارعلمي قائم على الإحصاء والتعددية العرقية،إعادة المدينة الكوردية القديمة إلى حضن إقليم كوردستان. وذلك لأن المرحلة الأهم من المادة 140 لم تنفذ بعد، التي تشمل عودة العرب الوافدين إلى أماكنهم السابقة، وعودة الكورد المطرودين إلى مدينة كركوك، وتغيير الحدود الإدارية الحالية لمحافظة كركوك إلى حقبة ما قبل وصول نظام البعث وبداية التعريب. لكن الآن أصبح لدى الكورد ورقة قوية في أيديهم دستوريا وقانونيا، وقبل تطبيق المادة 140 التي هي جزء من الدستور الدائم للعراق وتم التصويت عليها من قبل غالبية الشعب العراقي، يجب إجراء تعداد سكاني في كركوك والمناطق الكوردية المستقطعة التي تسمى المناطق المتنازع عليها في الدستور العراقي.لذلك من واجب أي كوردي محايد أو مؤيد لأي حزب أو قوة سياسية يؤمن بكوردستانية كركوك، أن يضغط على القيادة السياسية الكوردية وحكومة إقليم كوردستان لوضع كل خلافاتهم جانبا في هذا الوقت واستخدام مواقفهم وعلاقاتهم في بغداد وطهران وأنقرة لمنع إجراء التعداد السكاني في كركوكـ إذا لم يفعلوا ذلك ستذهب كل الجهود السابقة والتضحيات من أجل إعادة كركوك في مهب الريح.

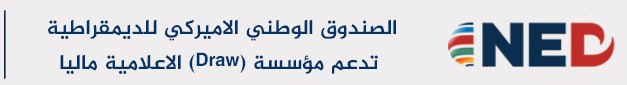

.jpg)

.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)